مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة في النموذج المغربي

الأنوال بريس -الدكتورة هنية ناجيم-
إن مقاربة النوع الاجتماعي موضوع يتسم بالراهنية، وقد كان ظهوره كمقاربة أولا في الدول المتقدمة، ووصل صداه إلى الدول النامية، بعد أن حملته ريح العولمة إليها.. ومقاربة النوع الاجتماعي تسعى إلى النهوض بحقوق النساء وتمكينهن، والنهوض بوضعية الفئات الاجتماعية الهشة، وهي بمثابة البعد المساواتي والمحايد لجنس المخلوق البشري. وقد تم تبنيها من قبل الأمم المتحدة وذلك لتحقيق والحفاظ على التنمية، وضمانها بصفة مستدامة لكلا الجنسين ولكافة مكونات المجتمع الإنساني، أي ما يعرف بالحقوق الفئوية، والقضاء سواء على دونية أو إقصاء أي مكون من مكونات هذا المجتمع.. ومقاربة النوع الاجتماعي تهدف إلى دمقرطة مشاريع التنمية ومشاركة متساوية وعادلة للأفراد إحقاقا لحقوق الإنسان ولتحقيق التنمية البشرية.
لماذا النوع الاجتماعي؟ لضمان توازن الدولة عبر مبادئ المساواة والعدالة والفعالية، وكلما أسرع في تبنيهم كلما كانت التنمية أكثر استدامة. بل ولأن مقاربة النوع الاجتماعي تعتبر مرتكزا أساسيا لتدعيم دولة الحق والقانون، وكذلك لتقييم حكامة السياسات المنتهجة. لماذا مقاربة النوع الاجتماعي وإستراتيجية التنمية المستدامة؟ لأن التنمية لا تتم بإقصاء ولو مكون واحد من مكونات المجتمع، وبالتالي، فمقاربة النوع الاجتماعي المساواتية تؤدي إلى إقرار تنمية مستدامة، والتنمية العادلة لا تتم إلا بإقرار مساواة مبنية على النوع الاجتماعي.
وتتجلى أهمية الموضوع في أن النوع الاجتماعي مقاربة حديثة تم تبنيها لفعاليتها لتحقق وتسرع وثيرة التنمية المستدامة لكافة فئات المجتمع، وليس فحسب لكلا الجنسين بصفة متساوية. وهي تعد مقاربة لا مناص منها للإصلاحات، ولتدخل السياسات العمومية اجتماعيا، واقتصاديا..إلخ، لإقرار الحقوق الخاصة بالفئات. وهي مقاربة أضحت تلزم المتدخلين بتبنيها في تدخلاتهم وجميع السياسات، التي أضحت بدورها ملزمة بإقرار التنمية المستدامة في نشاطاتها لصالح هذه الفئات. والنوع الاجتماعي يتجاوز الوسائل نحو النتائج الإيجابية والمستدامة عبر آلية التتبع والتقييم، لأنهما، أي النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة، أهداف مصيرية من أجل استدامة الدولة في حد ذاتها.
وتتجلى أهم الصعوبات التي واجهت سيرورة البحث في الموضوع، خاصة في ندرة الأبحاث والدراسات، العربية بالخصوص، التي تناولت مقاربة النوع الاجتماعي لحداثتها، بل وأن المقاربة لا زالت في طور التشكل وتشهد نقاشا عالميا..
وتتجلى إشكالية الأطروحة في: إلى أي حد استطاعت السياسات والاستراتيجيات العمومية المتبعة في المغرب من تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز تنمية مستدامة أكثر فعالية لكل فئات المجتمع، من خلال سياسات عمومية مرتكزة على النوع الاجتماعي؟
وقد تبنينا بعض الفرضيات الأساسية لدى دراستنا لمقاربة النوع الاجتماعي واستراتيجية التنمية المستدامة في المغرب، باعتماد الإشكاليات المطروحة وطنيا للنقاش، تتجلى في:
يقتضي تبني مقاربة النوع الاجتماعي تعزيز حقوق الإنسان وتوجيه أنشطة كل الفاعلين (قطاعات حكومية، مؤسسات وطنية، مجتمع مدني..)، نحو تبني المقاربة ومأسستها وطنيا؛
يقتضي مأسسة حقوق الإنسان التوافق الوطني حول المساواة والتكافؤ في الفرص في كل مجالات الحياة العامة والخاصة؛
يقتضي تبني مقاربة النوع الاجتماعي التوازن في كافة الحقوق وضمانها لكل الفئات وتسطير الأولويات العرضانية والقطاعية والبحث عن التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والمطالب الخاصة والإكراهات السوسيو اقتصادية والثقافية؛ وتسخير كل الإمكانيات لتنفيذها على أرض الواقع وإقرار المسؤولية المشتركة في الإعداد، الإنجاز، التتبع، التقييم وتحمل المسؤولية، والتكامل في تحملها.
ولأن حجم هذه المقاربة واختلاف تأثيرها وارتباطها بعدة علوم معرفية فقد كان لزاما إعتماد عدة مناهج: كان أولها المنهج التاريخي، وذلك بالرجوع إلى الأفكار الفلسفية سواء للفلاسفة أو للمدارس التي شكلت مرجعا/ أصول مقاربة النوع الاجتماعي، ودراسة تلك الأفكار/الفلسفات ومقارنتها بما تبلور حديثا من أفكار ومذاهب لمعرفة امتدادها الزمني وتأثيراتها.. والمنهج الوظيفي، وذلك لإبراز الوظيفة التي تقوم بها المقاربة في سبيل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء على مستوى المساواة بين الجنسين، أو من أجل النهوض بالحقوق الفئوية.. وبالمنهج النسقي، لإبراز قيمة هته الوظيفة داخل النظام، ونظرا للدور الذي لعبته/ تلعبه الحركات النسوية والقطاعات الوزارية وغيرها، ومختلف المتدخلين في تبني مقاربة النوع الاجتماعي.. إضافة إلى المنهج القانوني كما اعتمدنا تقنية الإحصاء، لقراءة النتائج المحصل عليها للحكم على تطور نتائج السياسات المنتهجة من عدمه..
والأطروحة تنقسم إلى بابين، حيث عالج الباب الأول: الأصول الفكرية الفلسفية/الدينية للنوع الاجتماعي. حيث في الفصل الأول عالجنا: النوع الاجتماعي في فلسفة حقوق الإنسان. فيما عالج الفصل الثاني: مقاربة النوع الاجتماعي في المذاهب الفلسفية الحديثة. ثم الباب الثاني الذي درسنا فيه
: المقاربة السوسيو-اقتصادية للنوع الاجتماعي
- النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة.
حيث في الفصل الأول عالجنا: مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة على المستوى الدولي. ثم ختمنا الدراسة بمعالجة في الفصل الثاني: مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة في النموذج المغربي.
فالقيمة الكمية والكيفية لحقوق الإنسان لم تكن وليدة الصدفة، كما لم تأتي من عدم، بل ترتبط في تطورها بمسار فكري، ثوري/ إصلاحي، بنى أسسها وشَكَّلها، كما وكيفا، حتى أضحت قيمة كونية، لكن لازال تجاوزها مرن؛ بحيث قابلية هتكها/ أو تطويرها هو رهن مشيئة القوى التي تمتلك تطويع الإرادة الوطنية/ الإقليمية أو الدولية في هذا المجال، إن سلبا أو إيجابا..
ولقد تبلورت فلسفة حقوق الإنسان بصيغ تتفاوت بين الشرعي، والفكر الإنساني، بين فكر المدينة وبين فكر حضارة بأكملها، بحيث على مدار مراحل تطورها عبر الزمن قد اكتسبت قيمة أخلاقية كونية، حيث في تجزيئها تشكل مركبات لحقوق الإنسان، انطوت، أي فلسفة حقوق الإنسان، تحت عدة تسميات (حقوق المرأة، حقوق المواطنة، حقوق الشعب، حقوق الطفل..)، وشكلت أساس العديد من المقاربات، إن جزئية أو شمولية، وهو ما تمثله مقاربة النوع الاجتماعي، التي تشكل البعد الشمولي لمبدأ حقوق الإنسان، ولذلك، فقد تناولنا مقاربة النوع الاجتماعي انطلاقا من منظور الحقوق الفئوية. إذن مقاربة النوع الاجتماعي تجد جذورها في فلسفة حقوق الإنسان، التي تطرح وترتبط بشكل مباشر بمبدأ المساواة، بحيث لا يمكن الحديث عن استكمال حق إنساني دونما أن يكون قابلا لتطبيقه على كل فرد مهما كان جنسه أو هويته..
النوع الاجتماعي مقاربة لم يتناولها الفكر الإنساني فحسب، بل نجدها مشرعة في الديانات السماوية الثلاث، خاصة في دين الإسلام والتي تقضي بالحقوق اللامتجاوزة لكل إنسان، رجلا وامرأة، وبغض النظر عن اختلاف السن والمكانة الاجتماعية والعرقية، وبإلزامية احترام إنسانية الإنسان، إن في ذاته أم مع الغير.
عند تقصير الفكر الفلسفي أو التشريعي/ الوضعي في النوع الكمي والكيفي لحقوق المرأة، جاءت الحركات النسوية لتفرض احترام المرأة والقضاء على دونيتها والحيف الذي يجعل الرجل في مستوى أعلى من المرأة. فظهور التيارات النسوية صب في مجمله نحو المساواة والمناصفة.. وكانت أفكار هذه التيارات تنادي بنهاية التفرقة الجنسية كأنثى وذكر، نحو مفهوم الجنسوية، والذي يصطلح عليه عالميا الآن بالنوع الاجتماعي. للقضاء على التراتبية التي ميزت عصر النظام البطركي.
وقد فرضت هذه الحركات النسوية وجودها عبر ثلاث أحداث عالمية (مؤتمر المكسيك لسنة 1975، اتفاقية CEDAW لسنة 1979 ب Copenhagen ومؤتمر بيكين لسنة 1995)، حيث حظيت هذه الحركات بحماية دولية من قبل الأمم المتحدة، والتي تبنت أفكار تلك الحركات لأجل ترسيخ حقوق المرأة دوليا وإشراكها في التنمية كمستفيدة وكفاعلة.. إضافة إلى تجاوز التقسيمات الجنسية نحو مقاربة النوع الاجتماعي في إنجاز سياسات الدول على مستوى كل المجالات.. وقد فتحت مقاربة النوع الاجتماعي أوراشا كبرى للسياسات العمومية بالاشتغال وفق مؤشرات، من خلال تحديد الأهداف، من جهة، وتقييم مدى تحقيقها، من جهة أخرى، وهو ما سطره مخطط العمل للمؤتمر العالمي ببيكين، حيث أضحت تقارير البرنامج الإنمائي الأممي تتبنى مؤشر التنمية المرتبط بالنوع في قياس مدى جدية سياسات الدول في إقرار التنمية لكلا الجنسين.. إضافة إلى أن اتفاقية CEDAW ومؤتمر بيكين أضحيا إطارا مرجعيا للسياسات. فمؤتمر بيكين لسنة 1995، أضحى يلزم الدول المستفيدة من الدعم الإنمائي الخاص بتقديم تقارير عن الجهود المبذولة من قبلها، لتقييم مدى التقدم المحصل عليه عند مرور كل عشر سنوات.
وقد أبانت أبحاث عالمية أن السياسات التنموية التي لا تحسب حسابا للعلاقات بين الجنسين ولا تخاطب ما بينهما من تمييزات تكون محدودة التأثير.. فمفهوم مقاربة النوع الاجتماعي يعكس التنمية المستدامة بكل جوانبها؛ نظرا لما تقوم عليه المقاربة من أسس تتمثل في إقرار صالح الفرد إن على المستوى السياسي، الاجتماعي، البيئي، الاقتصادي.. ولضمان تحقيقها يتم اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي لتبيان مدى تأثر الساكنة، بكل مكوناتها، ببرامج التنمية التي تستهدفها، من جهة، ومن جهة أخرى، تقيم مدى تحقيق النتائج المسطرة لكل القطاعات بشكل فعال وناجع.
ولعدم اﻹﻧﺼﺎف اﻟﺬي يغشى اﻟﻌﺎﻟﻢ تبنت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ المتحدة ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ للألفية اﻟﺠﺪﻳﺪة؛ حيث ﺣﺪدت اﻷﻫﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ، لسنة 2000، ﻛﺘﺎرﻳﺦ محدد لتقليل اﻟﻔﻘﺮ المدقع إلى اﻟﻨﺼﻒ، وتحقيق التعليم الأساسي لكل فرد على مستوى العالم في أفق ﻋﺎم 2015. وقد ركزت الأهداف على الحكامة المؤسساتية للدول المعنية في معالجة قضاياها والنهوض بالمؤشرات.
ثم سنة 2005، تم انعقاد قمة الأمم المتحدة ببيكين، حيث جاءت القمة بضرورة إدماج النوع لتحقيق الأهداف التنموية للألفية، وذلك في جميع المخططات، وبأثر رجعي على مستوى المخططات السابقة..
ورغم كل هذه الجهود الدولية فقد سجل تقرير التنمية البشرية أن التقدم يتباطأ في العالم منذ 2008. وخطة التنمية للأمم المتحدة ﺗﺴير على أﺳﺎس ﻏير ﻣﻨﺼﻒ؛ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ دول أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وأستراليا واﻟﻴﺎﺑﺎن، ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ على اﻟﺪﻟﻴﻞ القياس ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ البشرية، وتأتي الدول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ دول ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء الكبرى، في ﻣﺮاﻛﺰ متأخرة.
ويواجه العالم عدة تحديات كارتفاع معدل الشيخوخة والفقراء واللاجئون وتنامي مناطق النزاعات لضعف ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وكذا للمؤسسات ﻏﻴﺮ المسؤولة، ولضعف مقومات الحكم.
وما يزيد من تدهور الوطن العربي والإسلامي هي حالة الفوضى التي أعقبت الثورات والتي لا تنذر باستقرار قريب والتي تعتبر النساء والأطفال أكبر ضحاياها.
والمغرب، لم يكن معزولا عن النهضة النسوية العالمية، بل نجد تيارات نسوية مغربية قامت لتعلن عن مطالبها في المساواة والحقوق الكاملة للمرأة والمناصفة.
ولقد عرف المغرب الانتقال الديمقراطي وإرساء مبادئ حقوق الإنسان، وذلك عبر تبني عدة مؤسسات للنهوض بحقوق الإنسان، وعمل على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمصادقة عليها. ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻋﺎﻣﺔ الدستور. ويكرس دستور سنة 2011 مبدأ الديمقراطية ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ، بتفعيل ودسترة ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ المواطنين في ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ وفي الحياة السياسية. ولإرساء مبادئ حقوق الإنسان، تبنى الدستور مبدأ ﻓﺼﻞ السلط والموازنة ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ القضاء والارتقاء باستقلاليته، ومبادئ وقواعد المواطنة ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ والمتفاعلة، وتبني الحكامة الرشيدة.
وقام الدستور بمأسسة حقوق الإنسان، من خلال مأسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما وتبنى سياسات قطاعية في مجال الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية المبنية على النوع الاجتماعي، الأمر سواء على المستوى المحلي والجهوي.
ولقد تم تبني الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقوم على مبدأ حقوق الإنسان، بدعم من الإتحاد الأوربي.. كما ويعرف مجال النهوض بالتنمية تدخلات أخرى: كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وإستراتيجية الحقوق الفئوية بالمغرب، قد عرفت تبني مقتضيات جديدة معيارية وتشريعية ومؤسساتية لحقوق المرأة والطفل والأسرة، كما وتبنى المغرب توسيع إستراتيجية الحقوق الفئوية ودسترتها (على مستوى حقوق الشباب، وحقوق المهاجرين وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة).
كما وعرفت السياسة المالية للدولة تحديثا وإصلاحات خاصة على مستوى الميزانية بتبني مقاربة النوع الاجتماعي، بمساعدة البرنامج الشامل لـ UNIFEM. وأصبح المغرب يصدر تقريرا حول النوع الاجتماعي منذ سنة 2006. وفي نفس السنة تم اعتماد إستراتيجية وطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات التنمية وبرامجها. ومنذ سنة 2012، تبنى تقرير النوع الاجتماعي مقاربة منهجية جديدة تقوم على تحليل السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان. وترتكز هذه المقاربة على تقييم السياسات والبرامج العمومية من خلال ما تم تحقيقه في مجال حقوق الإنسان ومدى احترام المعايير الواردة في الآليات الدولية لحقوق الإنسان. كما وقد أدمج القانون التنظيمي للمالية رقم 13-130 لسنة 2015 مقاربة النوع الاجتماعي.
ويحتل المغرب الرتبة 119 عالميا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حسب معطيات سنة 2011. والرتبة 132 في سلم التنمية البشرية ضمن 187 بلدا، شملهم التقرير العالمي حول التنمية البشرية لسنة 2014. ويظل التعليم العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق أداء جيد في مجال التنمية البشرية. حيث احتل المغرب الرتبة 133 من بين 187 دولة في مجال التعليم، والرتبة على التوالي 110 و 116 في مجالي الصحة ومستوى الدخل.
وعلى مستوى المساواة بين الجنسين، يحتل المغرب الرتبة 129 من أصل 136 دولة حسب مؤشر الفوارق المرتبطة بالنوع GGGI لسنة 2013، وذلك في أربعة مجالات رئيسة، هي التربية والصحة والاقتصاد والمشاركة السياسية. ويحتل المغرب الرتبة 92 من حيث الفوارق بين الجنسين حسب تقرير التنمية البشرية الأممي لسنة 2014.
ورغم المجهودات المبذولة، بقيت النتائج محدودة مقارنة مع مستوى الحضور والمساهمة الحقيقية للنساء في مختلف المجالات؛ ولم ترقى تمثيلية المرأة في انتخابات هذه السنة (2015)، خاصة على مستوى المجالس الجهوية، إلى ما كانت تطمح إليه كل التغييرات التي شهدها المغرب لأجل إقرار المناصفة، حيث لم يعهد إلى المرأة المغربية مسؤولية ترأس ولا مجلس جهوي، مما يثير العديد من التساؤلات حول حقيقة نية المسؤولين السياسيين خاصة في تبني وإقرار مبدأ المناصفة. ونسب تولي النساء مراكز القرار على مستوى جميع القطاعات لا يرقى إلى المناصفة. وهكذا، يستمر التمييز السلبي اتجاه الكفاءات النسوية ببلادنا..
وعلى مستوى حقوق الطفل، فهؤلاء يواجهون تحديات كبيرة من بينها ظاهرة الفقر وسوء التغذية وتزويج القصر والعنف.
والإصلاحات لا يمكن أن تكون ناجعة إلا إذا صاحبتها إرادة حقيقية لتغيير العقليات والسلوكات، وكذا الصور النمطية والتمثلات السائدة عن الأدوار الاجتماعية لكل من النساء والرجال، وذلك لتعميم مبادئ الإنصاف والمساواة وترسيخها في قيم المجتمع. الأمر يتأتى عبر استثمار كل قنوات التنشئة الاجتماعية.
وقد تبنينا سبع مداخل لأجل توفير أرضية سوسيو اقتصادية لتحقيق المناصفة، منها: محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي؛ تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام والفن؛ ومدخل التمكين السياسي عبر نظام الكوتا. ومدخل النمو المدمج – وهي مقاربة جديدة لمحاربة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والمجالية وبين الجنسين. وضرورة تبني الجندرة على مستوى النظام الضريبي المغربي لتوفير أرضية سوسية اقتصادية لتحقيق المناصفة: واعتماد جندرة النفقات الجبائية سيفتح الأبواب أمام تكوين نخبة اقتصادية نسوية، مما سيفتح المجال إلى النهوض بأوضاع المرأة المغربية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.. وتجاوز النظام الأبوي المقاولاتي.. ويجب تفعيل مؤسسة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وإعادة النظر في مشروع قانون رقم 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة لتجاوز نواقصه. وضرورة تفعيل توصيات المؤسسة الملكية ومنتدى مراكش لحقوق الإنسان حول المناصفة.
لكن لانضج السلطة يفرغ كل تقدم من محتواه ويعيد مجهودات المجتمع المدني في سبيل النهوض بالحقوق الفئوية المبنية على النوع الاجتماعي إلى نقطة الصفر. ولذلك يجب مراجعة كل القوانين وملاءمتها مع الدستور، خاصة الخاصة بالصحة، التعليم والمشاركة السياسية. فهناك ترسانة قانونية جديدة فعالة ومتقدمة لكن يقابلها مؤشرات متخلفة على مستوى الصحة، التعليم والمشاركة، مما يكشف عن عيب يتخلل المؤسسات المكلفة بتنفيذ السياسات العمومية، وبالتالي ضعف الحكامة. وندعو إلى تبني الحكامة المبنية على النوع الاجتماعي في سياسات الدولة، إن محليا، جهويا أو وطنيا.
سياسة حقوق الإنسان يجب أن تكون لا أكثر مما هو عادل؛ ونعني به عدم طغيان إقرار حقوق فئة أو جنس على حقوق فئة أو جنس آخر، سواء كان هذا التمييز سلبي أو إيجابي. ولا أكثر مما هو مفيد؛ ونعني به عدم إتخام الفرد بالحقوق.. فالحرية لا يجب أن تأتي على حساب الإستدامة البشرية، وهو ما نراه بدأ يتحقق في العالم الغربي.. فالعالم لا يحتاج إلى نظريات وأنواع جنسانية جديدة بقدر ما يحتاج إلى ترشيد سياساته وتبني التعاون الدولي على أوسع نطاق، بل وتبني سمو التعاون الدولي على الإنغلاق الداخلي أو الإقليمي. فَحَلْ مشكل الفوارق بين الجنسين بالمغرب وخارج المغرب هو الإعتراف بالآخر، الذي يأتي على رأس الأولويات التي تحتاج للتغيير، لأجل نجاعة السياسات والقوانين الهادفة إلى إقرار التنمية المستدامة لكل فئات المجتمع بشكل منصف، فعال، متساو ومستدام. وحل كل هذه المشاكل يستدعي من الدول تبني العمل المشترك والمندمج الفعال فيما بينها لمواجهة المصير الذي أضحى مشتركا بين كل البشرية بكل فئاتها الاجتماعية، وهو أمر ليس بجديد، إذ أننا كلنا من حواء و آدم".
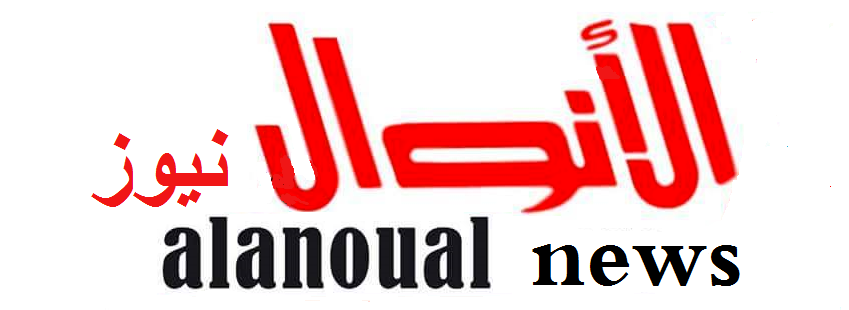
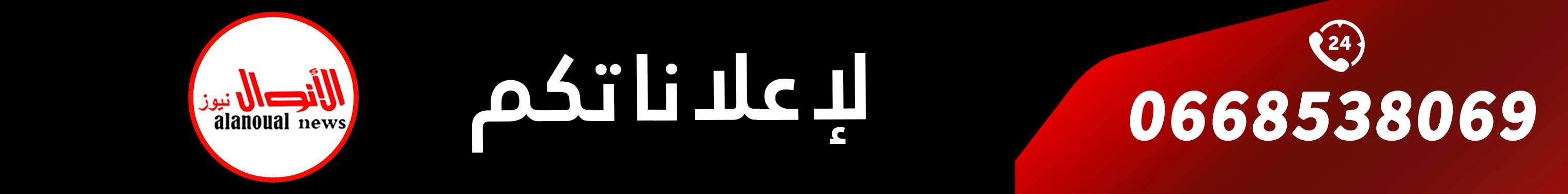
 سلطات القنيطرة تغلق شركة لبيع السيارات لمزاولتها النشاط دون ترخيص وارتكاب خروقات في التعمير واستغلال الملك العمومي
سلطات القنيطرة تغلق شركة لبيع السيارات لمزاولتها النشاط دون ترخيص وارتكاب خروقات في التعمير واستغلال الملك العمومي 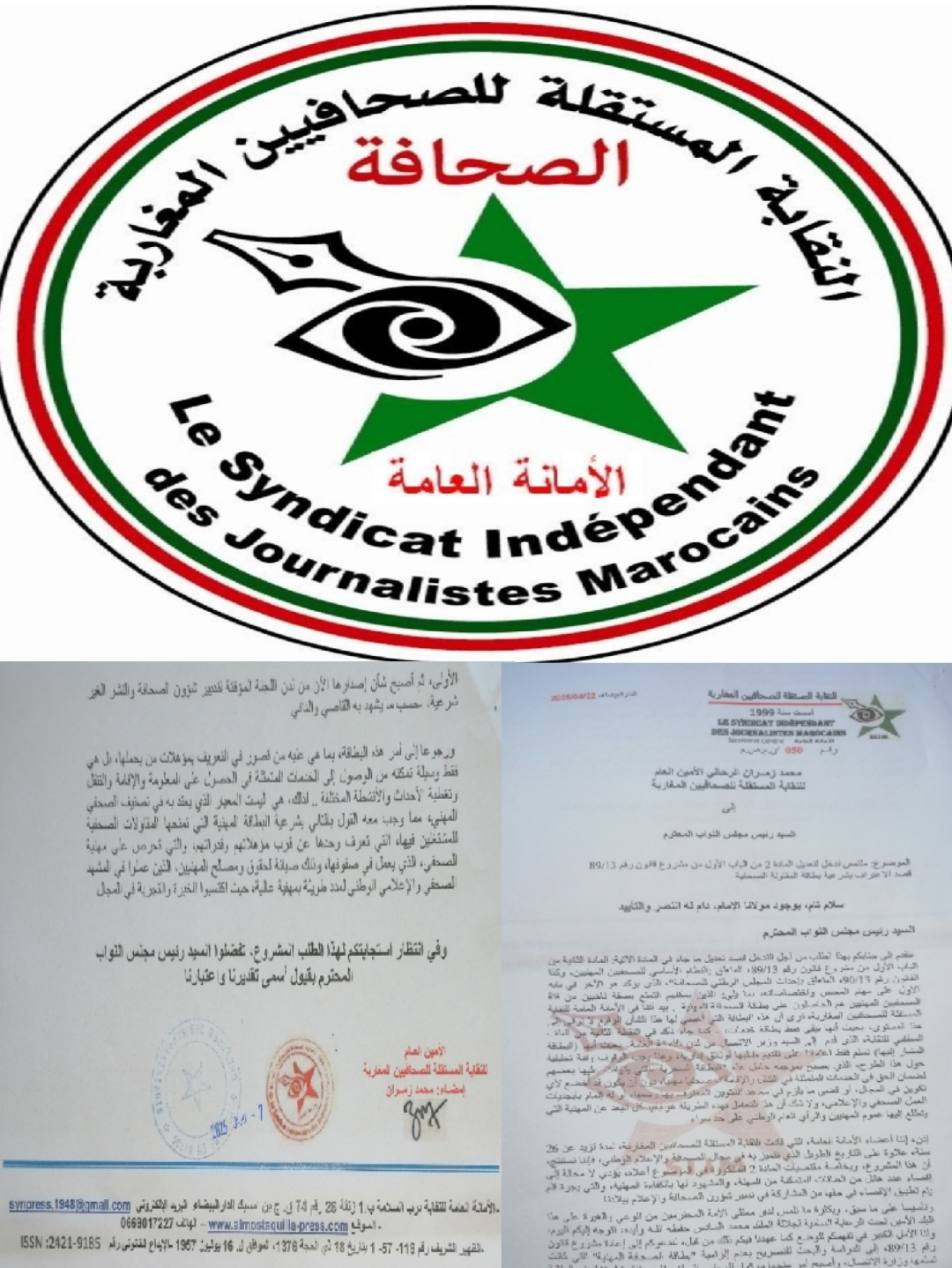 النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تدق باب مجلس النواب لمناقشة موضوع جد مهم
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تدق باب مجلس النواب لمناقشة موضوع جد مهم  الاستفادة من معاش الشيخوخة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح ماي 2025
الاستفادة من معاش الشيخوخة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح ماي 2025 _6.jpg) الشرق الأوسط وبزوع فجراسترجاع مجد الإمراطوريات القديمة
الشرق الأوسط وبزوع فجراسترجاع مجد الإمراطوريات القديمة _6.jpg)
_5.jpg)

أوكي..