الأنوال بريس - فهد المضحكي كاتب بحريني وعضو التقدمي -
ما يميز الحداثة في البلدان العربية أنها مشوهة أو كما يقول المفكر عزمي بشارة انها غير عضوية، تطورت بناء على جدول أعمال “الآخرين” لا بناء على جدول أعمالنا أو حاجاتنا، والشكل الذي اتخذته هذه الحداثة هو الرسملة المشوهة والهجينة لعلاقات الإنتاج، مما أدى إلى قيام رأسمالية غير منتجة، كومبرادورية تابعة بالتصدي لمهمات التحديث جنباً إلى جنب مع بيروقراطية ورأسمالية دولة (قطاع عام) ما لبثت أن فشلت في أداء مهماتها بانتهاء مرحلة التراكم الأولى. لقد حطمت العلاقات الريفية دون أن يحل محلها نظام رأسمالي أو اقتصاد صناعي يستوعب الهجرة إلى المدينة.
وفي الوقت نفسه أدت الحداثة وعملية التثاقف مع الغرب والتحول إلى سوق لبضائعه إلى انتاج حاجات لا يستطيع النظام الاجتماعي / الاقتصادي القائم تلبيتها؛ فالحداثة في شرقنا تنتج الحاجات، وتنتج عدم القدرة على تلبيتها في الوقت ذاته، ويزيد من حدة هذه الظاهرة العظيمة الأثر ازدياد تأثير وسائل الاتصال ودخولها إلى كل بيت بشكل لم يعد بالإمكان أن نتعامل معها كأنها موضوع ثانوي أو جزء من المبنى الفوقي، بل تعامل أساسي ينتمي اقتصادياً إلى المبنى التحتي للمجتمع ويساهم بشكل مباشر في تشكيل شخصية الإنسان المعاصر.
وإلى جانب ذلك يشير بشارة إلى أن ما يميز الإسلام السياسي عن المؤسسة الدينية هو رفضه المطلق للواقع الذي أتت به الحداثة. فالإسلام السياسي ليس محافظاً او مدافعاً عن الواقع القديم فحسب، بل انتقل إلى الهجوم لتوحيد عالمين يبدوان له انهما منفصلين: الدين والدولة، القداسة والسياسة.
في بحثه “مدخل إلى معالجة الديمقراطية وأنماط التدين ” كتب بشارة أن تزامن أفكار حسن البناء في مصر حول إعادة بناء الخلافة الإسلامية والأمة الإسلامية مع أفكار علي عبد الرزاق الإسلامية أيضاً الرافضة لاعتبار الخلافة اصلاً اسلامياً من أصول الحكم والمتقبلة عملياً فصل الدين عن الدولة، لم يكن مجرد مفارقة تاريخية فالعملية نفسها التي أدت إلى فصل الدين عن الدولة في الطرح الفكري (وليس في الواقع فحسب) أدت إلى طرح فكر مضاد.
وهذا يعني على حد رأيه – إن التيارات الأولى في الفكر الإسلامي السياسي لم تبتعد كثيراً عن تيارات الإصلاح الديني في حينه، وإن كانت تظهر بوادر للأصول الراديكالية، إلا انها كانت أكثر اعتدالاً في موقفها من القومية العربية ومن الديمقراطية بالشكل النيابي المبتور الذي طرحت فيه في تلك الفترة من الحركات الأصولية في السبعينيات والثمانيات.
لم يكن حسن البناء معادياً بل مجنداً في مصر في فترة ما بين الحربين كما انه لم ير في القومية العربية عدواً لدوداً بل كان يراها خصماً يجب تحويله إلى مكمل وحليف في الصراع من أجل اقامه الدولة الإسلامية.
وبشيء من التوضيح يرى باحثنا مرحلة الصراع العنيف مع التيارات القومية العلمانية التي تبنت خطاباً سياسياً تحررياً وشيدت رأسمالية الدولة اقتصادياً وأنظمة المجالس الثورية والحزب الواحد سياسياً تمخضت عن نوع جديد من الإسلام السياسي يصطلح المؤرخون على انهاء مرحلة انتقال أفكار أبي علي المودودي في الوطن العربي ومنعطف سيد قطب في تاريخ الإسلام السياسي.
ولقد أفرز هذا التحول في الحقيقة تيارين:
- تيار طور اتجاه سيد قطب إلى نهايته القصوى من حيث تكفير المجتمع والحاكم المسلم واعتبار الجاهلية حالة عقلية (حالة زمنية) والهجرة من هذه الجاهلية لإقامة المجتمع الإسلامي المصغر الذي يعد العدة لتحرير المجتمع الأكبر بالجهاد وقد أفرز هذا التيار جماعات العنف على أنواعها!
- تيار الحركات الإسلامية التي تعيش فترة ارتداد إصلاحي تحاول فيها البحث عن حلول وسط مع الأنظمة تمكنها من العمل العلني وحلول وسط مع مطالب الحركة القومية التاريخية، فقد علمتها التجربة أن المواجهة مع هذه المطالب تعني عزلة جماهيرية. وقد ساعد على بروز التيار الإصلاحي داخل الحركات الإسلامية بروز موضوع الديمقراطية وشرعية ومشروعية السلطة كموضوع يشغل الانتخابات في العالم الثالث خاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي العالمي كما ساهمت في ذلك أزمة الثورة الإيرانية وكذلك انهيار وانعدام شعبية الحكومات الدكتاتورية التي دعمها الإسلاميون (باكستان – السودان) على سبيل المثال.
وفي مقابل ذلك يقول لقد ترافقت هذه العملية بانتقال وربما هجرة للمثقفين العلمانيين القوميين واليساريين إلى المواقع الإسلامية باعتبارها الخيار الحضاري في مواجهة الغرب الاستعماري، لقد نقل أولئك إلى صفوف الحركات الإسلامية أو الادبيات الإسلامية على الأقل بعض الأفكار الأكثر تطوراً وديمقراطية ومع ذلك يتحول موقف الإسلام السياسي من الديمقراطية إلى موقف تكتيكي خاضع للمرجعية الإسلامية، فاجتهاد حركة إسلامية من اجل الديمقراطية لا ينفي اجتهاداً آخر ضد الديمقراطية اذا اقتضت المصلحة!
والأمر الأساسي هنا ان مشروعية الديمقراطية بموجب هذا النهج من التفكير لا تختلف عن مشروعية عدائها وتكفيرها والمقدس الوحيد هو النص أو “الإسلام”، يتعارض هذا الموقف تماماً مع الديمقراطية فيما لا يجوز تجاوزه في حالة الالتزام بالنظام الديمقراطي هي “مقدسات” أخرى مثل: المساواة أمام القانون وحرية التعبير والتعددية وحق الانتخابات العام والموقف الديني السياسي في هذا الاطار يعتبر مجرد رأي، أما بالنسبة إلى من يقبل الديمقراطية كنوع من التكتيك فحسب فإن الديمقراطية بحد ذاتها هي رأي مشروع تتفاوت مشروعيته بتفاوت التفسيرات للثابت المقدس وهو “النص” “الشريعة”…..الخ.
ويستطرد بشارة موضحاً: وتبرز غالبية الأدبيات الإسلامية المشاركة في الانتخابات البرلمانية بهدف واحد وهو المحافظة على الشريعة في الدولة، ويقصر التيار الغالب في الإسلام السياسي التعامل مع الديمقراطية على الجانب السياسي معتبراً هذا الجانب مقبولاً بدرجات متفاوتة، ثم يعود إلى تقييد هذا الجانب ايضاً بحكم الشريعة (تجربة مصر في عهد الرئيس المخلوع مرسي).
ومن الأمثلة أيضاً لا يقبل القرضاوي أي من أسس الديمقراطية وهو يحدد هذه الأسس بالعلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة؛ واطاعة القوانين الأجنبية الوضعية والحرية الشخصية بالمفهوم الغربي وخاصة حرية المرأة في التبرج والاختلاط، ولا يختلف الحال بالنسبة للإسلام السياسي الإيراني فهو يعارض الديمقراطية وحقوق المرأة وتحديث المجتمع بمرجعية متشددة خاضعة لحكم الفرد في ظل نظام ولاية الفقيه الذي يتعارض تماماً مع قيم الديمقراطية!
إذا كانت الأنظمة القمعية في البلدان العربية تعطل الديمقراطية بأحكام جائرة، فإن الإسلام السياسي بكافة أشكاله ومرجعياته يعتبر الديمقراطية وسيلة للوصول إلى الدولة الدينية التي تنطلق من طقوس ومقدسات ماضوية تفرض قيم الماضي على الحاضر والمستقبل!

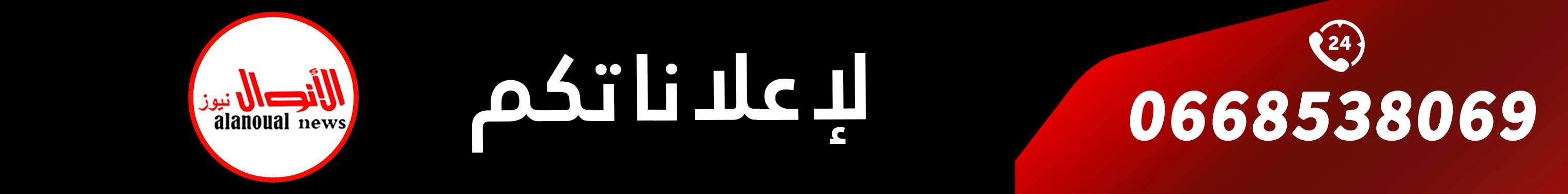

 من أجل استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية بالمغرب الحلقة (3)
من أجل استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية بالمغرب الحلقة (3)  مأساة مدينة آسفي.. مؤسسة الفقيه التطواني تتضامن
مأساة مدينة آسفي.. مؤسسة الفقيه التطواني تتضامن  الندوة الدولية:“التهجير القسري للمغاربة من الجزائر: ذاكرة الانتهاك وواجب الإنصاف”
الندوة الدولية:“التهجير القسري للمغاربة من الجزائر: ذاكرة الانتهاك وواجب الإنصاف” _33.jpg) بيان المنظمة الديمقراطية للشغل حول فرض رسوم التسجيل بسلك الماستر في نظام "الوقت الميسر"
بيان المنظمة الديمقراطية للشغل حول فرض رسوم التسجيل بسلك الماستر في نظام "الوقت الميسر" 


أوكي..