في رثاء رفيقي وصديقي وأخي محمد الرحوي

الأنوال نيوز
رفيقي، مرّت أربعون يوماً على وفاتك ولمّا أستوعب بعد أنّك غادرتنا إلى الأبد. مرّت أربعون يوماً، وما زالت فكرةُ أنّي لم أهاتفك كما اعتدتُ أن أفعلفي رثاء رفيقي وصديقي وأخي محمد الرحوي رفيقي، مرّت أربعون يوماً على وفاتك ولمّا أستوعب بعد أنّك غادرتنا إلى الأبد. مرّت أربعون يوماً، وما زالت فكرةُ أنّي لم أهاتفك كما اعتدتُ أن أفعل كلّ صباحٍ للاطمئنان على صحّتك تجتاز ذهني، بل أحياناً أفكّر أن أزورك.
صديقي، لأوّل مرّة منذ سنوات أكتب نصّاً دون أن أحيله عليك لتنقيحه وتصحيح ما قد يعتريه من أغلاط. فاعذر أخطائي، فلست في مستوى إلمامك باللغة العربيّة، ولا في مستوى ضبطك لبنائها وتركيبها، ولا عارفاً بخباياها، ولا ضليعاً في خصوصيّاتها، ولا حافظاً لشعرها القديم ولا الحديث. أنت الذي وعلى فراش الموت كنت تردّد على مسامعي بصوتٍ متقطّعٍ أرهقه المرض المتفشي في جسدك، المرض الذي لم ينل من صفاء ذهنك، أشعاراً لزهير بن أبي سلمى والمعرّي ولغيرهما من شعراء ما قبل الإسلام وبعده.
أيّها المعلّم، لن أنسى جوابَك لمّا قرّرتُ أن أسألك عن وصيّتك بعد أن صارحَتنا طبيبتك بتفشي المرض في كلّ جسدك وأنّ من الأفضل أن تكون بين أهلك... فهمنا قصدها. وفي المنزل، بدأتُ بتهنئتك بعودتك إلى بيتك، وكرّرتُ، كما كنتُ أفعل سابقاً، أنّك ستُشفى وستجتاز هذه المحنة كما تغلّبت على ما هو أصعب منها، وردّدتُ عبارات كنّا نتبادلها أيّام "قبور الحياة" لحث بعضنا البعض على التحمّل والمقاومة. ثمّ تحدّثتُ عن الموت الذي يلاحقنا جميعاً ولا أحد منّا يدري من السّابق. كنتُ أحاول اختيار الكلمات ... لم تتركني أطيل الكلام، ابتسمتَ، وجاء ردّك مُزلزلاً، يحمله صوتٌ خَفيتٌ تُجهد نفسك ليَبلغ مسمعي:
أَبُنيَّتـي لا تحزني *** كل الأنام إلى ذهابِ
أبنيّتـي صبراً جميـــــ *** لاً للجليل مـن الـمـصابِ
نوحي علـيّ بحسـرةٍ *** من خلفِ سِتركِ والحجابِ
قولـي إذا ناديتِني *** وعييتُ عـن ردِّ الجوابِ
زينُ الشباب أبو فرا *** سٍ لم يُمتَّعْ بالشبـابِ
في الحين جنَحَت بي الذاكرة إلى سنوات الجحيم حيثُ كنتَ تسافر بنا بعيداً عن لظاها وقهر زبانيتها. تتلو أشعاراً، تشرحها، تحكي ظروف نشأتها، وترسم في خيالنا مشاهد باديةِ العرب أو قصورهم أو سجونهم.
ماذا سأقول عنك يا زين الشباب الذي لم يمتّع بالشباب. أنت الذي صارعت، لتسع سنوات، نهْشَ المرض الغازي لأحشائك، بنفس العزيمة التي تصدّيتَ بها، طيلة تسعة أعوام، لمقامع الجلّاد المحاوِلة اقتلاعَ مبادئك وقيَمك وإنسانيتك. أنت الذي لم تنل من صلابتك ولا من دماثة خُلقك حياةٌ صدّت بوجهها عنك منذ صباك.
فهل سأوفيك حقّك في هذه الشّهادة؟ هل سأتمكّن من سرد كلّ الخصال التي اجتمعت فيك؟ ومن أين أبدأ وعن ماذا سأحكي؟
عن الصبر؟ كنت صبوراً قادراً على التحمّل بابتسامة دائمة وحسّ دعابة لم يفارقك أبداً. عن الصّدق؟ كنت يا صاحبي صادقاً. عن الإخلاص؟ كنت مخلصاً. عن الوفاء؟ كنت وفيّاً. كنت رجل مبادئ. لم تتاجر بمحنتك ولا بعت مبادئك. كنت طيّب القلب، خدوماً دون انتظار مقابل. كنت متواضعاً، هادئاً، رحب الصّدر، تتفادى الخلافات، تتغاضى عن الإساءات، تتفهّم ظلم ذوي القربى وتتناسى خذلان بعض الرفاق حين كنت في حاجة إليهم.
وكنتَ شجاعاً ما زال صوتك يتردّد في ذهني وأنت تصرخ في وجه جلّاديك وهم يجلدون باطن رجليك حتى اقـــــتُلعت جلدتهما، ويُطفؤون أعقاب السجائر في جراحك، ناعتاً إياهم بمسميّاتهم: ﭬزّارة، وحوش، عَدْيَان ...
ولن أنسى يوم بلغ لديك السيل الزبى. لحظة كنتَ ستتسبّب في إعدامك وربّما إعدامنا كلّنا. كانوا قد غالَوْا في تعذيبنا والتنكيل بنا بعد اكتشاف مراسلات بين أجنحة جحيم أﭬدز، وأفاضوا في الإهانات والإساءات والسبّ والشتم وقلّصوا من كميّة الطعام القليلة أصلاً. وكأنّ كلّ هذا لم يشف غلائلهم، فأغنوْا برنامج التعذيب اليومي بالأشغال الشاقة. كانوا يقتادوننا كلّ صباحٍ لبناء حائطٍ لعزل زنزانة المختطف اللبناني ذي الأصل المغربي، أبو فادي، تحت ضربات جريد النخل وصياحهم الذي لا ينقطع.
كنّا منهكين. كانت السنوات الخمس التي قضيناها حينها بين الكومبليكس وأﭬدز قد أخذت من أجسادنا وقدراتنا على التحمل والصبر. وصادف أن انتشر بيننا في تلك الفترة، وكان الفصل صيفاً، زكام حادّ. ارتفعت حرارة أجسادنا وضاهت قيظ صيف الصحراء. كنتَ بجانبي تمُدّ الحارس المكلّف بالبناء بالأحجار. وفجأة، ولمّا انحنيتَ لرفع حَجَرةٍ لتسليمها للحارس/ البنّاء الذي كان يعتلي سُلّماً، اقترب منك حارسٌ آخر وهوى بعصاه الطويلة بكلّ قوته على طول عمودك الفقري. تلوّى ظهرك، سمعتُ زفيرك. التفتَّ إليه، فابتعد. وبعد لحظة ودون أن تنتبه إليه، عاد من جديد ونزل بعصاه على طول عمودك الفقري. نظرتَ إليه نظرةً فهمتُ منها ما راج في ذهنك. كنّا نعرف بعضنا جيداً ولا يمكن أن يخفى على أحدنا ما يفكّر فيه الآخر. انحنيتَ تبحثُ عن حجرةٍ، خمّنتُ أنّها ستكون من نصيب الحارس الشّرير الذي كان من بين الأكثر قساوة في تعذيبنا منذ حللنا بأﭬدز. استقمتَ، استدرتَ نحوه رافعاً الحجرة إلى أعلى. صرخ عاليّاً بالأمازيغيّة أنّك تريد قتله. ملأ مسامعي صرير أزنِدة رشّاشات الحرّاس الواقفين في سطح الجناح. وفي رمشة عين، كنتُ قد ارتميتُ عليك، دفعتُك بكتفي لتسقط على الأرض وأنا أصيح "اسْخَفْ ... راه اسْخف". فهمتَ قصدي، هويتَ على الأرض. ولم أعد أسمع غير صراخ الحرّاس بأنك أردت ضرب زميلهم ومنهم من كان يردّد أنّك أردت قتله. كنتُ أنتظر اختراق الرّصاص لجسدينا، وهو نفس ما شعر به باقي رفاقنا. ولولا نفي أحد الحراس ما سار إليه الآخرون لما سلِمت الجرّة.
وبعد ثلاث سنوات أو أربع من ذلك الحادث، أفرج عنّا لتستمر مأساتك مع الحياة. ابتدأت بصدمة اكتشاف أنّ أباك تُوفيّ قبل أربع سنوات من الإفراج عنك. كنتَ اشتريتَ له من المائتي درهم التي سلّموها لك طاقيّة ومصحفاً، هديّة تريد بها استسماحه عمّا تسبّبت له من معاناة طيلة سنوات الاختطاف وإن لم تكن مسؤولاً عنها ... وأنت تقاوم هول الصّدمة وتحاول فهم ما يجري تمّ اعتقالك من جديد. وقضيت أسبوعين بين مخافر الدرك والشرطة. لتتْبعها سنوات طويلة من العوز والتشرد والضياع قاومتها بشجاعة وشهامة لا مثيل لهما.
أخي محمّد، ما ذكرتُه في حقّك مجرّد غيض من فيض. فنم يا صديقي قرير العين، مطمئنّاً، فرسالتك بالغةٌ وحلمك بالعدالة والكرامة سيتحقّق مهما طال الأمد.
عبد الناصر بنو هاشم
الرباط، 23 يناير 2023
كلّ صباحٍ للاطمئنان على صحّتك تجتاز ذهني، بل أحياناً أفكّر أن أزورك.
صديقي، لأوّل مرّة منذ سنوات أكتب نصّاً دون أن أحيله عليك لتنقيحه وتصحيح ما قد يعتريه من أغلاط. فاعذر أخطائي، فلست في مستوى إلمامك باللغة العربيّة، ولا في مستوى ضبطك لبنائها وتركيبها، ولا عارفاً بخباياها، ولا ضليعاً في خصوصيّاتها، ولا حافظاً لشعرها القديم ولا الحديث. أنت الذي وعلى فراش الموت كنت تردّد على مسامعي بصوتٍ متقطّعٍ أرهقه المرض المتفشي في جسدك، المرض الذي لم ينل من صفاء ذهنك، أشعاراً لزهير بن أبي سلمى والمعرّي ولغيرهما من شعراء ما قبل الإسلام وبعده.
أيّها المعلّم، لن أنسى جوابَك لمّا قرّرتُ أن أسألك عن وصيّتك بعد أن صارحَتنا طبيبتك بتفشي المرض في كلّ جسدك وأنّ من الأفضل أن تكون بين أهلك... فهمنا قصدها. وفي المنزل، بدأتُ بتهنئتك بعودتك إلى بيتك، وكرّرتُ، كما كنتُ أفعل سابقاً، أنّك ستُشفى وستجتاز هذه المحنة كما تغلّبت على ما هو أصعب منها، وردّدتُ عبارات كنّا نتبادلها أيّام "قبور الحياة" لحث بعضنا البعض على التحمّل والمقاومة. ثمّ تحدّثتُ عن الموت الذي يلاحقنا جميعاً ولا أحد منّا يدري من السّابق. كنتُ أحاول اختيار الكلمات ... لم تتركني أطيل الكلام، ابتسمتَ، وجاء ردّك مُزلزلاً، يحمله صوتٌ خَفيتٌ تُجهد نفسك ليَبلغ مسمعي:
أَبُنيَّتـي لا تحزني *** كل الأنام إلى ذهابِ
أبنيّتـي صبراً جميـــــ *** لاً للجليل مـن الـمـصابِ
نوحي علـيّ بحسـرةٍ *** من خلفِ سِتركِ والحجابِ
قولـي إذا ناديتِني *** وعييتُ عـن ردِّ الجوابِ
زينُ الشباب أبو فرا *** سٍ لم يُمتَّعْ بالشبـابِ
في الحين جنَحَت بي الذاكرة إلى سنوات الجحيم حيثُ كنتَ تسافر بنا بعيداً عن لظاها وقهر زبانيتها. تتلو أشعاراً، تشرحها، تحكي ظروف نشأتها، وترسم في خيالنا مشاهد باديةِ العرب أو قصورهم أو سجونهم.
ماذا سأقول عنك يا زين الشباب الذي لم يمتّع بالشباب. أنت الذي صارعت، لتسع سنوات، نهْشَ المرض الغازي لأحشائك، بنفس العزيمة التي تصدّيتَ بها، طيلة تسعة أعوام، لمقامع الجلّاد المحاوِلة اقتلاعَ مبادئك وقيَمك وإنسانيتك. أنت الذي لم تنل من صلابتك ولا من دماثة خُلقك حياةٌ صدّت بوجهها عنك منذ صباك.
فهل سأوفيك حقّك في هذه الشّهادة؟ هل سأتمكّن من سرد كلّ الخصال التي اجتمعت فيك؟ ومن أين أبدأ وعن ماذا سأحكي؟
عن الصبر؟ كنت صبوراً قادراً على التحمّل بابتسامة دائمة وحسّ دعابة لم يفارقك أبداً. عن الصّدق؟ كنت يا صاحبي صادقاً. عن الإخلاص؟ كنت مخلصاً. عن الوفاء؟ كنت وفيّاً. كنت رجل مبادئ. لم تتاجر بمحنتك ولا بعت مبادئك. كنت طيّب القلب، خدوماً دون انتظار مقابل. كنت متواضعاً، هادئاً، رحب الصّدر، تتفادى الخلافات، تتغاضى عن الإساءات، تتفهّم ظلم ذوي القربى وتتناسى خذلان بعض الرفاق حين كنت في حاجة إليهم.
وكنتَ شجاعاً. ما زال صوتك يتردّد في ذهني وأنت تصرخ في وجه جلّاديك وهم يجلدون باطن رجليك حتى اقـــــتُلعت جلدتهما، ويُطفؤون أعقاب السجائر في جراحك، ناعتاً إياهم بمسميّاتهم: ﭬزّارة، وحوش، عَدْيَان ...
ولن أنسى يوم بلغ لديك السيل الزبى. لحظة كنتَ ستتسبّب في إعدامك وربّما إعدامنا كلّنا. كانوا قد غالَوْا في تعذيبنا والتنكيل بنا بعد اكتشاف مراسلات بين أجنحة جحيم أﭬدز، وأفاضوا في الإهانات والإساءات والسبّ والشتم وقلّصوا من كميّة الطعام القليلة أصلاً. وكأنّ كلّ هذا لم يشف غلائلهم، فأغنوْا برنامج التعذيب اليومي بالأشغال الشاقة. كانوا يقتادوننا كلّ صباحٍ لبناء حائطٍ لعزل زنزانة المختطف اللبناني ذي الأصل المغربي، أبو فادي، تحت ضربات جريد النخل وصياحهم الذي لا ينقطع.
كنّا منهكين. كانت السنوات الخمس التي قضيناها حينها بين الكومبليكس وأﭬدز قد أخذت من أجسادنا وقدراتنا على التحمل والصبر. وصادف أن انتشر بيننا في تلك الفترة، وكان الفصل صيفاً، زكام حادّ. ارتفعت حرارة أجسادنا وضاهت قيظ صيف الصحراء. كنتَ بجانبي تمُدّ الحارس المكلّف بالبناء بالأحجار. وفجأة، ولمّا انحنيتَ لرفع حَجَرةٍ لتسليمها للحارس/ البنّاء الذي كان يعتلي سُلّماً، اقترب منك حارسٌ آخر وهوى بعصاه الطويلة بكلّ قوته على طول عمودك الفقري. تلوّى ظهرك، سمعتُ زفيرك. التفتَّ إليه، فابتعد. وبعد لحظة ودون أن تنتبه إليه، عاد من جديد ونزل بعصاه على طول عمودك الفقري. نظرتَ إليه نظرةً فهمتُ منها ما راج في ذهنك. كنّا نعرف بعضنا جيداً ولا يمكن أن يخفى على أحدنا ما يفكّر فيه الآخر. انحنيتَ تبحثُ عن حجرةٍ، خمّنتُ أنّها ستكون من نصيب الحارس الشّرير الذي كان من بين الأكثر قساوة في تعذيبنا منذ حللنا بأﭬدز. استقمتَ، استدرتَ نحوه رافعاً الحجرة إلى أعلى. صرخ عاليّاً بالأمازيغيّة أنّك تريد قتله. ملأ مسامعي صرير أزنِدة رشّاشات الحرّاس الواقفين في سطح الجناح. وفي رمشة عين، كنتُ قد ارتميتُ عليك، دفعتُك بكتفي لتسقط على الأرض وأنا أصيح "اسْخَفْ ... راه اسْخف". فهمتَ قصدي، هويتَ على الأرض. ولم أعد أسمع غير صراخ الحرّاس بأنك أردت ضرب زميلهم ومنهم من كان يردّد أنّك أردت قتله. كنتُ أنتظر اختراق الرّصاص لجسدينا، وهو نفس ما شعر به باقي رفاقنا. ولولا نفي أحد الحراس ما سار إليه الآخرون لما سلِمت الجرّة.
وبعد ثلاث سنوات أو أربع من ذلك الحادث، أفرج عنّا لتستمر مأساتك مع الحياة. ابتدأت بصدمة اكتشاف أنّ أباك تُوفيّ قبل أربع سنوات من الإفراج عنك. كنتَ اشتريتَ له من المائتي درهم التي سلّموها لك طاقيّة ومصحفاً، هديّة تريد بها استسماحه عمّا تسبّبت له من معاناة طيلة سنوات الاختطاف وإن لم تكن مسؤولاً عنها ... وأنت تقاوم هول الصّدمة وتحاول فهم ما يجري تمّ اعتقالك من جديد. وقضيت أسبوعين بين مخافر الدرك والشرطة. لتتْبعها سنوات طويلة من العوز والتشرد والضياع قاومتها بشجاعة وشهامة لا مثيل لهما.
أخي محمّد، ما ذكرتُه في حقّك مجرّد غيض من فيض. فنم يا صديقي قرير العين، مطمئنّاً، فرسالتك بالغةٌ وحلمك بالعدالة والكرامة سيتحقّق مهما طال الأمد.
عبد الناصر بنو هاشم

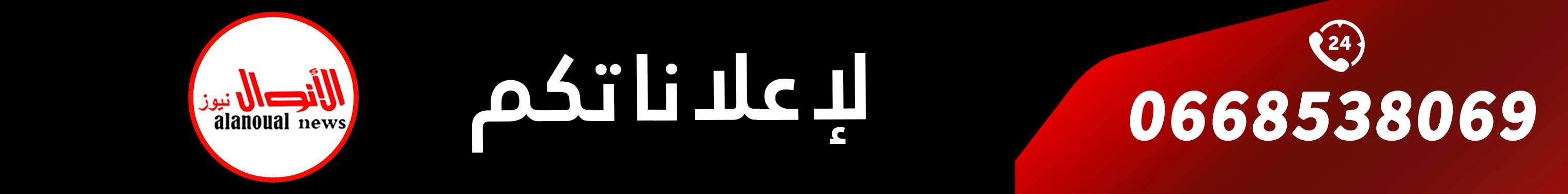
_24.jpg) بيان شرعي يحرم، ويدين رسوّ سفن أمريكية بميناء طنجة محمّلة بعتاد عسكري موجه للكيان الصهيـوني
بيان شرعي يحرم، ويدين رسوّ سفن أمريكية بميناء طنجة محمّلة بعتاد عسكري موجه للكيان الصهيـوني _64.jpg) البيان الصادر عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان حول صناعة التقليدية تحتضر بإقليم سطات
البيان الصادر عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان حول صناعة التقليدية تحتضر بإقليم سطات _80.jpg) النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تشدد على ضرورة غربلة وتصحيح المنظومة القانونية وتنقيتها من كل ما يربطها بالقانون الجنائي
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تشدد على ضرورة غربلة وتصحيح المنظومة القانونية وتنقيتها من كل ما يربطها بالقانون الجنائي _157.jpg) من رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية عدم تسليم وصل الإيداع
من رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية عدم تسليم وصل الإيداع 


أوكي..