التصريح الصحفي المتعلق بالتقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021

الأنوال نيوز
التصريح الصحفي المتعلق بالتقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021.
السيدات والسادة ممثلات وممثلو الصحافة الرقمية والورقية، السمعية والبصرية؛
السيدات والسادة ممثلو المنظمات الحاضرة معنا؛
الحضور الكريم.
يطيب لنا أن نرحب بكن/م جميعا، باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رحاب هذه الندوة الصحفية التي نخصصها لتقديم "التقري السنوي لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2021"؛ وهو التقرير الذي نتطلع من خلاله إلى لفت الانتباه نحو ما تشهده بلادنا من انتهاكات ماسة بالحقوق والحريات الأساسية، وما يستوجبه هذا من تحرك عاجل وجدي من أجل وضع حد لها، بدل انتاج واستهلاك خطابات مطمئنة ومدغدغة للذات.
وغني عن البيان أن الجمعية واظبت، استمرارا للتقليد الذي أرسته منذ تسعينات القرن الماضي، على اصدار تقاريرها السنوية، التي تروم من خلالها القيام بتشخيص عام لحالة حقوق الإنسان، انطلاقا مما رصدته أو تابعته من خروقات، واستنادا إلى تقييمها العام لمختلف السياسات العمومية المتبعة والتشريعات القانونية المعتمدة. وهي في هذا، لا يخالجها أدنى شك في أن ما يتضمنه التقرير من معطيات، وما يحتويه من وقائع وممارسات لا يستغرق كل ما يصيب حقوق الإنسان من تجاوزات ويطالها من تعطيل أو اعتداءات.
وكما جرى به العمل في تقارير سابقة فإن التقرير الحالي يشتمل على ثلاثة محاور أساسية، تتفرع بدورها إلى محاور موضوعاتية} وذلك على النحو التالي:
1) المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية:
يتكون هذا المحور من المحاور الموضوعاتية التالية:
- الحق في الحياة وعقوبة الإعدام؛
- الاعتقال السياسي؛
- الحريات العامة؛
- حرية المعتقد والحريات الفردية؛
- حرية الإعلام والصحافة والانترنيت؛
- الحق في المحاكمة العادلة؛
- وضعية السجون.
2) المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- الحق في العمل والحقوق الشغلية؛
- الحق في السكن؛
- الحق في الصحة؛
- الحق في التعليم؛
- الحقوق اللغوية والثقافية؛
- الحق في الحماية الاجتماعية.
3) المحور الثالث: حقوق فئات محددة
- حقوق المرأة؛
- حقوق الطفل؛
- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- حقوق المهاجرين/ات واللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء؛
- الحق في البيئة السليمة والتنمية المستدامة.
والواقع أن سنة 2021، التي يغطيها هذا التقرير، لم تشهد تحسنا ملحوظا، في وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، إذ ظلت تراوح مكانها، إن لم نقل أنها واصلت التأكيد على أن الانتهاكات التي تعرفها العديد من الحقوق والحريات الأساسية ببلادنا، ليست ظرفية ولا عرضية، بقدر ما هي وليدة اختيار سياسي ممنهج للدولة لا تبغي عنه حيادا أو تراجعا، حتى وإن بدا ذلك أحيانا متعارضا مع التضخم الكبير للخطاب الرسمي والمؤسساتي حول حقوق الإنسان، وسعيه المحموم لاحتكار هذا الخطاب لفائدته، ونزع الشرعية عن أي مقاربة أخرى تناقض ذلك، أو تمتحن جدوى الدور الحمائي للمؤسسات الحكومية والوطنية العاملة في مجال إقرار وتعزيز حقوق الإنسان.
وإذا كان جزء من هذه الخروقات، التي جرى رصدها سنة 2021، يمكن أن يعزى إلى استمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية الناشئة عن انتشار وباء كوفيد-19 واعتماد المعالجة الأمنية كأسلوب لتدبيرها؛ فإن القسم الأعظم منها يستقي أسباب وجوده، من الهجوم المتواصل للدولة على الحريات العامة الضرورية والمميزة لكل مجتمع ديمقراطي، ومن جنوحها الجامح صوب التقويض الشامل لأهم المكتسبات المحققة حتى الآن في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وذلك لفائدة ليبرالية متوحشة هجينة متراكبة مع اقتصاد الريع، ومتداخلة مع الفساد والنهب المنفلت من كل رقابة للثروات والخيرات الوطنية.
لذلك فإن الوضع الحقوقي لم يخل من مشاهد تؤثثها الاعتقالات الموجهة والمحاكمات المنصوبة لقص الألسن الناقدة وتكميم الأفواه المنددة، وكتم كل نفس تجرؤ على فضح ما يجري من تجاوزات، ويحدث من تسلط واعتداءات؛ في استهداف واضح لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والتدوين، وفي تضييق متزايد على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلميين.
وفي هذا السياق وقف التقرير على مجموعة من الخروقات التي مست الحقوق المدنية والسياسية؛ حيث لا زالت السجون تعج بالعديد من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، الذين تابعت الجمعية حالاتهم، لا سيما أولئك الذين توبعوا وحوكموا ضمن حراك الريف، ولم تشملهم قرارات العفو، أو الذين اعتقلوا على خلفيات تدوينات أو منشورات أو فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الذين صدرت في حقهم أحكام ثقيلة بعد تفكيك مخيم "كديم ازيك"، أومن تبقى ممن يطلق عليهم "معتقلو السلفية الجهادية"، الذين ما فتئت الجمعية تعتبر أن الكثير منهم اعتقل على خلفية آرائه وقناعاته الدينية، وتعرض لانتهاكات بليغة تمثلت في الاختطاف والتعذيب والمحاكمات غير العادلة. وقد أحصى هذا التقرير، إلى حدود شهر شتنبر 2021، وجود حوالي 120معتقلا/ة، والعشرات من الاستدعاءات والتوقيفات والمتابعات القضائية.
إن الحق في الحياة، بصفته أسمى حقوق الإنسان، المفروض على الدولة حمايته وتوفير الشروط الكفيلة والكافية لصونه، فيجري انتهاكه ببلادنا لأسباب عديدة وفي مواقع متعددة. فعدد كبير من المواطنين والمواطنات يفقدون أرواحهم، سواء جراء الإهمال وغياب الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات، أو بسبب عدم التقيد بقواعد ومعايير السلامة في الأوراش والمعامل، أو بسبب انعدام المساءلة وسيادة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن إنفاذ القوانين في المخافر والسجون، أو غرقا في البحار بحثا عن ظروف عيش كريم، أو في السدود والوديان والشواطئ بسبب غياب فضاءات آمنة للاستجمام، أو منتحرين بسبب الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية...
ومن خلال الأرقام والحالات الواردة في هذا التقرير، ورغم صعوبة الوصول إلى كافة البيانات المتعلقة بحالات الوفيات بالمغرب، وقفت الجمعية على الكثير من الحالات التي تضع السياسات العمومية للدولة المغربية موضع مساءلة.
عقوبة الإعدام: رغم التزام الدولة المغربية في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، الذي تقول مادته الأولى: "لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في البروتوكول المعني، وتتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية"؛ وخلافا للفصل 20 من الباب الثاني المعنون بالحريات والحقوق الأساسية في الدستور المغربي، والذي يقول: "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"؛ لازال المغرب لم يصادق على البروتوكول الثاني المشار إليه، ولا زالت المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، ولا زالت الدولة المغربية تمتنع عن التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام رغم أن المغرب أوقف تنفيذ هذه العقوبة منذ قرابة ثلاثة عقود (1993).
وبخصوص سنة 2021، ومن خلال التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكلمة رئيس النيابة العامة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، فقد كان مجموع المحكومين بالإعدام نهاية سنة 2020 يبلغ 74 شخصا ضمنهم امرأتان، وفي نهاية سنة 2021، بلغ عددهم 78 حالة (حسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان) أو 79 (حسب رئيس النيابة العامة). وبما أنه لم يستفد أحد منهم من عفو ولم تسجل وفاة وسطهم، فيمكن الاستنتاج أن عدد الأحكام بالإعدام الصادرة سنة 2021 هو أربعة أو خمسة أحكام. ومن جهتنا، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد سجلنا حكمين صادرين خلال سنة 2021 بكل من الجديدة وطنجة.
الوفيات في مراكز الاحتجاز والمستشفيات وأماكن العمل وغيرها: يعرض هذا التقرير 21 حالة وفاة في مراكز الشرطة والدرك والسلطات وفي السجون أو بسبب الإحساس بالغبن (الحكرة) أو تدخل القوات العمومية؛ و32 حالة وفاة في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية جراء الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الاستشفائية؛ و93 حالة وفاة في أماكن العمل بسبب غياب شروط السلامة أو أثناء التنقل للعمل؛ و8 حالات بسبب لسعات العقارب ولدغات الحيات وعضات الكلاب والسعار؛ و35 وفاة بسبب الاختناق الناتج عن تسرب الغاز أو أحادي أوكسيد الكاربون، وما يزيد عن 500 حالة وفاة جراء الفيضانات والغرق والحرائق وحوادث السير "الجماعية". أما حوادث السير بالمغرب، وحسب الإحصاءات لرسمية، فتتسبب في حوالي 3500 وفاة كل سنة منها 839 بالمجال الحضري بالنسبة لسنة 2021.
بخصوص الحوامل والرضع، فإن معدل وفيات الأمهات الحوامل بالمغرب يتجاوز 72 وفاة لكل مئة ألف (100.000) ولادة، ويبلغ 18 وفاة لكل 1000 ولادة حية بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، علاوة على 14 وفاة قبل بلوغ سن الخامسة لكل 1000 ولادة حية. وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 80% من كل هذه الحالات يمكن إنقاذ حياتهم بالنسبة لكل الدول. وذلك من خلال سياسة صحية تراعي توفير الرعاية الصحية بتكلفة مناسبة وفي متناول الأسر، يقدمها أطباء وممرضون مؤهلون، بالإضافة إلى التغذية السليمة للأم والطفل وتتبع وضعهما قبل الولادة وبعدها.
فيما يرتبط بالوفيات الناتجة عن الانتحار: ورغم عدم توفر معطيات رسمية متاحة بخصوص الانتحار في المغرب، فإن تقريرا صادرا عن منظمة الصحة العالمية في الموضوع يخص سنة 2016 تحدث عن عدد 1014 حالة انتحار بنسبة 2.9 لكل 100.000 نسمة. ويتفق الباحثون والمهتمون بالظاهرة على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تعرف أعلى حالات الوفيات بسبب الانتحار. وتبقى أكثر الوسائل المستعملة في الانتحار هي الشنق، يليها الارتماء من أعلى المنازل، ثم تناول مواد سامة مثل سم الفئران أو مبيد الحشرات، إضافة إلى وسائل أخرى كالارتماء أمام القطار وبواسطة أسلحة حادة أو نارية. أما بخصوص الأسباب، فيرى المختصون أن الإقدام على وضع حد للحياة يترجم حالة نفسية متدهورة بالأساس، مرتبطة بعوامل يتداخل فيها الصحي والاجتماعي بالاقتصادي. وهوما يتطلب من الدولة إعادة النظر في منظومة الصحة النفسية كما تؤكد على ذلك منظمة الصحة العالمية في توصياتها أن "لا فرق بين الصحة الجسدية والصحة النفسية وأن ما هو نفسي يؤدي إلى مضاعفات جسدية والعكس صحيح.
أما الحالات التي تمكنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تتبعها خلال سنة 2021، خاصة عبر ما ينشر في الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية، والتي لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من مجموع الحالات، فقد بلغ عددها 168 حالة موزعة على الجهات الإدارية كما يلي: جهة طنجة تطوان الحسيمة 49 حالة بنسبة 19.64%، بني ملال خنيفرة 33 حالة بنسبة 19.64%، الدار البيضاء سطات 17 حالة بنسبة 10.12%، سوس ماسة 17 حالة بنسبة 10.12%، مراكش آسفي 15 حالة بنسبة 8.93%، فاس مكناس 14 حالة بنسبة 8.33%، الشرق 8 حالات بنسبة 4.76%، الرباط القنيطرة 5 حالات بنسبة 2.98%، درعة تافيلالت 4 حالات بنسبة 2.38%، كلميم واد نون 4 حالات بنسبة 2.38%، العيون الساقية الحمراء 1 حالة بنسبة 0.6%، الداخلة وادي الذهب 1 حالة 0.6%.
وبخصوص ملف التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فإنه وإن لم يتم توثيق أية ادعاءات واضحة وصريحة خلال سنة 2021 بالتعرض للتعذيب، فإن العنف المفرط الذي تمارسه القوات العمومية أثناء فضها للاحتجاجات والتظاهرات السلمية، وما يتسبب فيه من إيذاء واصابات بليغة، يتعدى أحيانا سوء المعاملة ويرقى إلى مصاف التعذيب. وتوضح الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع مسيرات الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المستوى الذي قد يصل إليه استعمال القوة، وما يتسبب فيه من مس بالسلامة الجسدية للمحتجات والمحتجين.
وفيما يتعلق بالحق في حرية تأسيس الجمعيات، سجلت الجمعية تجاوزات السلطات للقانون والشطط في استعمال السلطة، عبر رفضها تسلم ملفات التأسيس أو التجديد؛ سواء بشكل مباشر، أو عبر البريد المضمون أو بواسطة مفوض قضائي، ورفضها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها في هذا الشأن في استهتار تام بسلطة القانون، وتحقير كامل للمقررات القضائية وضرب لقاعدة المساواة أمام القانون. ونورد هنا، فقط، ما طال فروع الجمعية من تعسف، حيث بلغ عدد الفروع التي لا تتوفر على وصولات الإيداع 74 فرعا.
أما الحق في التجمع والاحتجاج السلمي فقد وقفت الجمعية على العديد من حالات منع وحظر المظاهرات، والتجمعات والوقفات السلمية، خلال سنة 2021، والقمع الأهوج الذي وصل أحيانا للسحل والإصابات البليغة في صفوف المحتجين والمحتجات، واستعمال الكلام النابي والسب والشتم والإهانات؛ فضلا عن الكثير من التوقيفات التحكمية والاعتقالات، التي تحولت في بعض الحالات إلى متابعات قضائية.
ومع استمرار حالة الطوارئ الصحية والتذرع بالحفاظ على الصحة العامة، أصبح التظاهر السلمي والتجمع؛ سواء المنظم من طرف هيئة يخولها القانون ذلك، أومن طرف ائتلافات أو شبكات أو جبهات أو غيرها، ممنوعا بشكل تام في بعض المدن كالرباط، وخنيفرة، والناظور، والدرويش، وطنجة والحسيمة؛ وفي هذا السياق ما زالت منطقة الريف تعيش حالة من الحصار والمنع منذ ماي 2017.
وفيما يهم حرية المعتقد والحريات الفردية، واصلت الجمعية رصد بعض الحالات، سواء عبر التقارير الواردة من فروعها أو مما تداولته وسائل الإعلام، منها:
- حرمان المغاربة الشيعة، كما المسيحيين، من ممارسة طقوسهم الدينية، وإحياء أعيادهم بشكل علني في دور عبادة خاصة بهم (حسينيات وكنائس)؛ مما يضطرهم لإقامتها سريا في بيوتهم تحت طائلة النبذ والعزل الاجتماعي، أو تعرض للمساءلة؛
- اضطرار المغاربة المسيحيين إلى عدم التعبير العلني عن خيارهم العقائدي، ولجوئهم إلى ممارسة عقيدتهم سرا، خشية تعرضهم لفقدان حقوقهم في الميراث أو حضانة أطفالهم، كما لا يسمح لهم بالتعميد، أو الزواج وفق معتقدهم، أو اختيار أسماء أطفالهم أو دفن موتاهم بمقابر مسيحية؛
- إدانة المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم 28ابريل 2021، مواطنا بتهمة الإفطار في رمضان، بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم؛
- متابعة طالبة مغربية، في يونيو2021، بسبب تدوينة تعود إلى 2019 نشرتها تحت عنوان ـ"سورة الويسكي"، غادرت المغرب إلى أوروبا للدراسة، لتعود إليه بعد 3 سنوات؛ حيث اعتقلتها السلطات ووجهت لها تهمة "المس بالمعتقدات الدينية للشعب المغربي"، وأصدرت في حقها المحكمة الابتدائية بمراكش حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهما.
وبالنسبة إلى حرية الإعلام والصحافة والأنترنيت، فإن المغرب في عام 2021 عرف تراجعا استثنائيا وغير مسبوق على مستوى حريّة الإعلام والصحافة والتدوين، إذ استمرت الاعتقالات والمحاكمات التعسفية التي طالت الصحفيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي موسوم بالقمع والتضييق على الحريّات الإعلامية، إضافة إلى استمرار "إعلام" التشهير، الموالي لأجهزة الأمن والمخابرات، في مهاجمة الصحفيين المستقلين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد صنفت منظمة "منظمة مراسلون" المغرب في المرتبة 136 من أصل 180 بلدًا وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021. ووفق المنظمة نفسها (مراسلون بلا حدود) فإنّ موجة الضغوط القضائية ضد الصحفيين متواصلة. فبالإضافة إلى "المحاكمات التي استمرت لسنوات ضد العديد من الفاعلين الإعلاميين، انهالت المتابعات القضائية على الصحفيين من جديد، حيث تركزت التهم هذه المرة على مسائل أخلاقية تمس حياتهم الشخصية، مع استمرار استخدام المرأة كأداة في مثل هذه القضايا".
كما توقف هذا التقرير، بتفصيل، عند الخروقات التي طبعت الحق في المحاكمة العادلة، والتي كان من أبرز ما ميزها، الخروقات التي شابت المحاكمة عن بعد بسبب تفشي وباء كورونا؛ فعلى الرغم من ايجابياتها في التخفيف من حدة ووقع انتشار الفيروس على مرتفقي قطاع العدلة وعدم تعطيل وتوقيف مصالحهم؛ ورغم حرمان المعتقلين منهم على وجه الخصوص من المثول أمام المحكمة للنظر في ملفاتهم في آجال معقولة، وفي تجاوز الظرف الاستثنائي الذي جعل من الاستماع للأطراف ونقل المعتقلين أمرا يتهدد صحتهم وحياتهم، وأيضا احتمال نقل العدوى ونشرها بالسجن؛ فقد شابتها تجاوزات كان من الممكن تلافيها ومنها:
1- خرق مبدأ الحضورية والتواجهية؛
2- خرق مبدأ العلنية؛
3- خرق حقوق الدفاع.
وفي الجانب المرتبط بوضعية السجون، أشار التقرير إلى أن الساكنة السجنية عرفت سنة 2021 ارتفاعا مقارنة مع سنة 2020، بما يقارب 4000 سجين وسجينة (3947). أما فيما يخص المحكومين فشهد أيضا ارتفاعا ب 5262 سجينا وسجينة، رغم ظروف الجائحة؛ بينما انخفض عدد السجناء الاحتياطيين سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، إذ بلغ 1311؛ وهو مؤشر إيجابي جزئي وذلك رغم أنه لا يرقى إلى طموحات الحركة الحقوقية التي ترافعت من أجل ترشيد حقيقي للاعتقال الاحتياطي.
وعلى الرغم من إجراءات العفو، فعدد المحكومين بالإعدام عرف ارتفاعا سنة 2021 (79 مقارنة مع 2020 حيث بلغ العدد 73 محكوما بالإعدام).
ولا تزال ظاهرة الاكتظاظ تمثل السمة العامة للسجون بالمغرب، مما يعيق تنفيذ برامج التأهيل وإعادة الإدماج، ويحول دون التمتع بحقوق الانسان الأساسية، خصوصا الحق في الصحة الجسدية والنفسية والحق في الفسحة الكافية وفي التغذية السليمة والمتوازنة. فنسبة الاكتظاظ مثلا بجهة مراكش -آسفي بلغت 154,31%، جهة الرباط -سلا -القنيطرة 146,33% وجهة بني ملال -خنيفرة 132,38%...
وبالرجوع إلى إحصائيات عدد الوفيات في المؤسسات السجنية، فقد بلغ مجموعه 204 حالة برسم سنة 2021، مقارنة مع سنة 2020، حيث بلغ العدد حينها 213 حالة وفاة.
أما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ فقد استمرت الحقوق الشغلية، طيلة سنة 2021، كأكبر ضحايا جائحة كوفيد-19. لا لأنها كانت أفضل حالا قبل ذلك، بل لكونها أقل حماية وصيانة. وهكذا تفاقمت البطالة وتعمقت هشاشة الشغل وتراجعت حقوق العاملات والعمال في مواقع الإنتاج وفي مقدمتها الحق في الأجر الذي يضمن العيش الكريم، فضلا عن الحق النقابي والحق في الاحتجاج. واستمر التوظيف السياسي للجائحة من طرف السلطة للتضييق على الحركات الاجتماعية للشغيلة ومنعها من الاحتجاج على هجوم الباطرونا على حقوقها ومن فضح التسريحات الجماعية اللاقانونية التي مست آلاف العاملات والعمال بمختلف القطاعات.
ومن مظاهر تردي الحقوق الشغلية أن ثلاثة أرباع العاملات والعمال لا يتوفرون على تغطية صحية مرتبطة بالشغل، وخصوصا بالوسط القروي. كما جرى تسجيل انتهاكات سافرة للحقوق الشغلية في عدد من المدن، كان أخطرها فاجعة طنجة يوم 08 فبراير 2021 التي توفي على إثرها 28 عاملا وعاملة بعد أن غمرت مياه الأمطار وحدة إنتاجية للنسيج الموجه للتصدير في مرآب فيلا كانوا يشتغلون بها. وقد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة وتعويض العائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها.
وفيما يتصل بالحق في السكن اللائق؛ فإنه لا زال حقا بعيد المنال بالنسبة لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين، لا سيما إذا أستبعدنا من المعايير المنطبقة عليه، أنواعا متعددة ومتنوعة من المساكن، التي لا تعدو أن تكون مجرد سقوف وحيطان لا تتوفر على المقومات الأساسية المتطلبة في الحياة اليومية؛ من المساحة الكافية، والانارة والتهوية الضرورية، والمرافق الصحية الحيوية، والبيئة الآمنة، والتجهيزات والخدمات العمومية...؛ فما بالك بالأحياء الصفيحية والعشوائية غير المهيكلة، ومستوطنات المهاجرين غير النظاميين ووضعية المشردين بدون مأوى.
ولعل الباعث على القلق بهذا الخصوص، هو الإخفاق المتواصل للسياسات العمومية، المتبعة حتى الآن، في مجال الإسكان ومحاربة السكن غير اللائق، بمختلف أشكاله، في تحقيق الأهداف والنتائج المتوقعة؛ بالرغم من الخطط والبرامج، والوعاءات العقارية والموارد المالية المرصودة لاستئصال الظاهرة؛ الأمر الذي يستلزم التساؤل عن الأسباب البنيوية والظرفية التي تحول دون ذلك.
ولا تمثل سنة 2021 استثناء من حيث استمرارية الخصاص الذي يعرفه السكن اللائق، بالرغم من الأهداف والبرامج التي أعدتها الدولة لردم الهوة، وسد الفجوة المسجلة في هذا المجال. فمذكرة مشروع المالية برسم 2021 تتحدث على أن الحكومة استطاعت تقليص العجز التراكمي المسجل في السكن من 840.000 وحدة برسم 2011 إلى 385.000 وحدة برسم 2020. وعلى الرغم من الإعلان رسميا على أن 59 مدينة منها قد أصبحت بدون صفيح، وأن نحو301.914 أسرة تحسنت ظروف عيشها، إلا أن الحكومة لا زالت عاجزة عن تسوية وضعية ما تبقى من الأسر المعنية التي حددتها في 69.086 أسرة في سنة 2021.
أما فيما يخص الحق في الصحة، ولقد صنف المغرب ضمن أسوأ عشرين دولة، من حيث التمتع بالرعاية الصحية والرفاه وفق مؤشر "انديغو ويلنس"؛ بسبب تدني جودة الخدمات الصحية، وعدم رضا المواطنين عن مستوى هذه الخدمات المقدمة، بنسبة تفوق 80 في المائة؛ نظرا، للنقص في الموارد المالية والبشرية، وهشاشة البنيات التحتية، والنقص في الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية.
ويحتل المغرب اليوم المرتبة 112، من بين 195 بلدا، فيما يتعلق بمؤشر الولوج إلى الخدمات الصحية وجودتها؛ علما بأن الولوج إليها يبقى صعبا، خاصة في الأرياف، علاوة على كونه مكلفا ويتطلب وقتا طويلا. كما أن جودة الخدمات الصحية لم تعرف نفس وتيرة تطور الولوج إليها، وأن التكلفة الفعلية التي يتحملها المواطنون تبقى مرتفعة جدا، إذ تتحمل الأسر ما يفوق 50 بالمئة من مجموع النفقات المرتبطة بالخدمات الصحية.
ويعاني قطاع الصحة في المغرب من نقص مهول في البنيات التحتية، الذي سيتكرس أكثر مع دخول مشروع "المساعد الطبية" حيز التطبيق وتكاثر طلبات الاستشفاء. فالمغرب لا يتوفر إلا على 5 مستشفيات جامعية، تعاني بدورها من نقص في الوسائل اللوجستيكية، أو مشاكل في الصيانة أو نقص في الأطر الصحية. فضلا عن عشرات المستشفيات الإقليمية (39 مستشفى متخصصا و102 مستشفى عام)، والمراكز الصحية (2689 مؤسسة، بمعدل 12000 نسمة لكل مؤسسة في الوسط القروي و43000 في الوسط الحضري)، التي لم تجدد بناياتها وأجهزتها، منذ عقود خلت، في ظل ضعف الرقابة وانخفاض الميزانيات المخصصة للتسيير والتدبير؛ خاصة وأن الأسر المغربية تساهم ب 57 في المائة من نفقات العلاج، كما صرح بذلك وزير الصحة نفسه، (لا يتوفر المغرب إلا على سرير واحد لكل 1000 نسمة، مقابل 2.2 لكل ألف نسمة في تونس، و7 أسرة لكل ألف نسمة في أوروبا. ولا تبلغ نسبة الاستشفاء سوى 4.7 % بالمغرب، مقابل 14 % في تونس)؛ بالإضافة إلى غلاء الأدوية، حيث تبلغ نسبة الولوج إليها 400 درهم لكل مواطن.
ولعل أهم مشاكل قطاع الصحة على الإطلاق هو النقص المهول في الأطر الصحية. ففي بلد يتجاوز عدد سكانه 30 مليون نسمة، لا يتعدى عدد الساهرين على الصحة العمومية فيه 47 ألف موظف؛ حيث لا يتجاوز عدد الأطباء 46 طبيبا لكل 100 ألف نسمة (مقابل 70 في تونس و300 في فرنسا) 10 ممرضين لكل 10 ألف نسمة. وهوما جعل منظمة الصحة العالمية تصنف المغرب من بين 57 دولة تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية، إذ يعاني المغرب من خصاص في الميدان الصحي لا يقل عن 6000 طبيب و9000 ممرض (علما أن مؤسسات التكوين الموجودة غير قادرة على استدراك هذا الخصاص، فمثلا لا توجد في المغرب سوى 23 مؤسسة لتكوين الممرضين). ويزيد من عمق هذه المشكلة سوء توزيع الأطر الصحية؛ سواء كان هذا الخلل في التوزيع يتعلق بالعدد أو بالكيف؛ حيث تبقى سمة التفاوت والفارق بين المؤسسات هي الطاغية (مراكز صحية تشتغل بأكثر من 20 إطارا صحيا، بينما تشتغل مراكز أخرى بأقل من ستة أطر).
ويشكو الحق في التعليم بدوره من استمرار وتعمق مختلف أوجه التمييز وعدم تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم الجيد، خصوصا في سياق استمرار أزمة كوفيد-19، التي أثرت بشكل غير متناسب على أشد الفئات ضعفا، لا سيما بالمناطق القروية؛ بمن في ذلك الفتيات والنساء، والأشخاص الذين يعيشون في فقر، والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
وبينت الأزمة الصحية لكوفيد-19 الحاجة إلى تزويد أنظمة التعليم بموارد إضافية لحماية الحق في التعليم المجاني والجيد دون أي تمييز. غير أن المغرب، وخلافا لكل توجيهات المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة بما في ذلك المندوبية السامية لحقوق الإنسان والنقابات الدولية، أقدم على اقتطاع غلاف مالي يقدر بحوالي 3,811 مليار درهم من ميزانية قطاع التعليم المدرسي في إطار قانون المالية التعديلي.
وبلغت ميزانية قطاع التعليم المدرسي برسم سنة 2021 حوالي 58,862 مليار درهم موزعة، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة مع الميزانية الأولية قبل الجائحة؛ فيما أصبحت الأسر تتحمل، إلى جانب الميزانية العامة للدولة، عبء مصاريف تمويل التسيير المدرسي، التي تقدر بنسبة 30% متجاوزة بذلك بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تستقر في 16%، حسب تصريحات الوزارة الوصية.
وعلى الرغم من شبه تعميم التعليم بالسلك الابتدائي (الفئة العمرية 6-11 سنة)، برسم السنة الدراسية 2020-2021، فإن هذه النسبة تبقى متواضعة بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي. وبلغت النسبة الصافية للتمدرس بالثانوي الإعدادي 87,6 %، في حين لم تتجاوز 66,6 %، بالنسبة لسلك الثانوي التأهيلي (الفئة العمرية 2015-2017). وتدفع هذه المعطيات إلى القول بأنه ليس لجميع المغاربة نفس الفرص للوصول إلى التعليم، وأن نسبة مهمة من الأطفال ذكورا وإناثا ما بين 4 و16 سنة لم يلتحقوا بالمدرسة خلال سنة 2020-2021.
وسجلت نسبة الانقطاع عن الدراسة خلال نهاية السنة الدراسية 2020-2021، ارتفاعا مقارنة مع السنة الدراسية 2019-2020؛ حيث بلغ عدد الأطفال الذين غادروا المدرسة 331.558 تلميذة وتلميذا، موزعين على الأسلاك التعليمية الثلاثة على التوالي 106.704 و156.277 و68577 تلميذا وتلميذة. وتتركز أعلى نسب الانقطاع افي السنة السادسة ابتدائي، لا سيما في صفوف الفتيات بالتعليم الابتدائي، وفي السنة الأولى إعدادي والسنة الثانية باكالوريا.
وتفيد آخر الأرقام المقدمة من المندوبية السامية للتخطيط وتهم سنة 2019 إلى أن الأمية تصيب النساء أكثر من الرجال، حيث وصلت نسبة الأشخاص الأميين، نساء ورجالا، إلى 35,9 %، في حين وصلت هذه النسبة في صفوف النساء إلى 46,1 %. وتبلغ نسبة الأمية في صفوق الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 سنة وأكثر 62,2 %، في حين تصل هذه النسبة إلى 76,5 % في صفوف النساء من نفس الفئة العمرية.
وفيما يتصل بالحقوق الثقافية فإن الساحة الثقافية أصيبت بالشلل، وظهرت الأزمة الثقافية بشكل بارز من خلال إقفال المسارح ودور الثقافة ودور الشباب وقاعات السينما على قلتها، وتم توقيف كل المهرجانات والعروض الفنية، والملتقيات وغيرها من الأنشطة التي تخلق حركية ثقافية وتساهم في توفير فرص عمل للفنانات والفنانين المغاربة، وعبرت مجموعة من الهيئات المهنية الفنية عن سخط كبير ورفض تام للطريقة التي كانت وزارة الثقافة تسير بها قطاع الثقافة والاتصال، ووصفوها بالعشوائية والارتجالية في اتخاذ القرارات والمواقف اتجاه بعض الهيئات المهنية دون غيرها، كما أن الدعم المقدم للفنانين أثار موجة من السخط لدى الكثيرين لضعف قيمته، أو لعدم اتخاذ معايير موضوعية وعادلة في توزيعه، كما أنه لم يعمم على الجميع.
- أن القراءة بالمغرب تراجعت بنسبة 2في المائة وأن واحدا من عشرة قراء محتملين لم يقرأ أي كتاب منذ عام، فيما لم يقرأ 41 في المائة كتابا منذ ستة أشهر أو أكثر ومن المستجوبين من لم يقرأ كتابا منذ خمس سنوات...؛
- القاعات السينمائية عانت خلال السنوات الأخيرة، من تقلص عددها سنة بعد أخرى من 247 قاعة سنة 1987 إلى 31 قاعة سنة 2019، ومن تراجع عدد روادها من أكثر من 40 مليونا سنة 1987 إلى أقل من مليوني مشاهدة ومشاهد سنة 2019؛
- توجد 87 قاعة للمسرح، منها 40 فضاء ثقافيا، والباقي تابع لقطاعات أخرى أو للجماعات المحلية؛ تتمركز 50 في المائة من هذه الفضاءات في جهة الدار البيضاء الرباط؛
- تبين معطيات دراسة أنجزتها الفدرالية المغربية لناشري الصحف المغربية في مجموعها تبيع حوالي 200 ألف نسخة يوميا وهو رقم هزيل مقارنة بساكنة المغرب البالغة نحو35 مليون نسمة...
ولم تشكل وضعية الحقوق الثقافية واللغوية استثناء فيما عرفته باقي الحقوق من انتكاسات وتراجعات، رغم بعض الخطابات الرسمية المطمئنة التي تظهر في بعض المناسبات لتختفي على مستوى الأجرأة والتنفيذ اللذين بقيا بعيدين، سواء عن منطوق دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي المجالات العامة ذات الأولوية، رغم علاته، ومنشور رئيس الحكومة رقم 19 بتاريخ 10 دجنبر 2019، الذي يطالب من خلاله مختلف القطاعات الوزارية بوضع مخططات خاصة بتفعيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي وموافاته بجدولة زمنية تأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال التي نصت عليها المادتان 31 و32، في أجل أقصاه نهاية يناير 2020. إذ مر أكثر من عقد من الزمن على دسترة ترسيم اللغة الأمازيغية وما زالت الأجرأة الفعلية تراوح مكانها، بل تم التراجع على كل المجهودات التي قام بها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتم تجميد أعماله وخاصة في مجالي التعليم والإعلام وانسحب من متابعة وتفعيل كل الاتفاقيات التي تم توقيعها وتم تجريده عمليا من مهامه.
ويبقى القانون 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها من أخطرها من حيث استهدافه وحدة الجماعات السلالية، ويمكن اعتباره تقنينا للقضاء على وجودها. بدءا من كون عامل الاقليم أو العمالة هو المخول له حصر لائحة أعضاء الجماعة (المادة 3 من القانون 17-62)، ولا يمكن الطعن فيها أمام القضاء إلا بعد إذن من وزارة الداخلية، أي سلطة الوصاية. أما فيما يخص قرارات التمليك والتفويت والكراء والتبادل، فقد أسندها المشرع إلى مجلس الوصاية المركزي الذي يرأسه وزير الداخلية أومن ينوب عنه وإلى مجلس الوصاية المركزي الذي يرأسه عامل الاقليم (المادتان 32 و33 من نفس القانون 17-62)، كما أعطى المشرع جميع الصلاحيات لوزير الداخلية، وسمح له تحت يافطة الحفاظ على أملاك الجماعات وتثمينها، لاتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات باسم الجماعة (المادة 31).
وتوقف هذا التقرير، كذلك، عند الحق في الحماية الاجتماعية بالمغرب، تغطي أنظمة التقاعد المغربية حاليا ما يزيد قليلا عن 40% من السكان النشطين المشتغلين. ويغطي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض النسبة نفسها تقريبا؛ حيث يبلغ عدد الأشخاص المشمولين به ما يزيد بقليل عن 8,5 مليون شخص. وهكذا فان حوالي60% من السكان النشيطين محرمون من الحماية الاجتماعية.
ولتدارك هذا الخصاص جاء قانون 09.21 كقانون إطار لتنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، من خلال مجموعة من الأهداف والمرتكزات المتمثلة في:
- توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة 2022، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء؛
- تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس؛
- توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة، التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعد؛
- تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
واعتمادا على نفس منهجية التقارير السنوية السابقة فقد خصص التقرير الحالي مساحة مهمة لتناول حقوق المرأة، مؤكدا على أن التصريحات المعلنة للدولة بشأن تطوير التشريعات، واتخاذ إجراءات من أجل رفع التمييز الممارس ضد المرأة، في عدة مناسبات؛ سواء عند عرضها لتقاريرها الدورية حول مدى إعمال اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، أو عند فحص مدى التقدم في تفعيل خطة عمل بكين؛ لم يكن لها أثر قوي على مستوى التشريع كما على مستوى الواقع، بسب تذرعها بالخصوصية الثقافية والدينية كمرجعية كلما تعلق الأمر بحقوق المرأة؛ في تناقض تام مع تصريحاتها الرسمية المعلنة بخصوص انخراطها في المنظومة الكونية والشمولية لحقوق الإنسان.
وحسب آخر بحث للمندوبية السامية للتخطيط، فإن واحدة من كل أربع ضحايا العنف الجسدي، وواحدة من كل عشرة من ضحايا العنف الجنسي تعاني من إصابات و/ أو مشاكل نفسية. وفي إطار العلاقة مع الشريك، تعرضت 25% من ضحايا العنف الجسدي و10% من ضحايا العنف الجنسي لإصابات و/ أو مشاكل نفسية، نتيجة أشد حدث عنف جسدي أو جنسي تعرضت له خلال 12 شهرا الأخيرة.
وازداد وضع النساء تدهورا بسبب جائحة كورونا التي كانت لها انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والمهني للنساء بحكم القطاعات التي تشتغل فيها النساء والتي تعتبر غير مهيكلة أو ذات قيمة متدنية في نظر المجتمع وحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا 19 الصادر عام 2021 فإن مناصب الشغل المتعلقة بالنساء تضررت ب 18 مرة أكثر من الرجال.
وتظل نسبة مشاركة النساء في الأجهزة التقريرية ضعيفة ومخجلة، رغم الحضور النوعي والكمي لهن في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورغم أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة الأربعون، في تعليقاتها الختامية أعربت عن قلقها بسبب نسبة تمثيلية المرأة المنخفضة للغاية في مناصب اتخاذ القرار في كافة الأوساط، وفي القطاعين العام والخاص، والسلك الديبلوماسي والقضاء والأوساط الأكاديمية، فالحكومة لم تقم باتخاذ التدابير الكافية لزيادة التمثيل السياسي للنساء على جميع المستويات بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الاستثنائية المؤقتة.
وفيما يهم حقوق الطفل فإنه بالرغم من اعتماد الدولة للسياسة المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، يوم 03 يونيو2015 من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات العمومية والمخططات، فإن تفعيلها على أرض الواقع مازال ضعيفا رغم تسطيرها لمجموعة من الأهداف (الأطفال أقل من 18 سنة - الأسر الفقيرة التي توجد في وضعية صعبة) والتي ينص عليها قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في المجالات الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية. ورغم إطلاق مجموعة من المبادرات لمعالجة قضايا الأطفال في وضعية هشة، وعلى راسها إطلاق حملة "مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع"؛ إلا أن هذه المبادرات ظلت باهتة في غياب اعمالها على الصعيد الوطني، إذ تم تفعيلها، فقط، على مستوى الرباط، في حين مازال أطفال الشوارع يتسكعون في باقي المدن المغربية.
أما المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي تم التصديق عليه وفق قانون 78-14، فإن تفعيله مازال حبيس الرفوف بمبرر غياب الموارد البشرية لإخراجه.
ويعتبر تزويج الطفلات رافدا من روافد العنف ضد النساء والفتيات، حيث تتعرض الطفلات لكل أنواع العنف، ويتم استغلالهن جنسيا، ويحرمن من حقهن في اللعب والتعليم والصحة، كما يعد منافيا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما المادة 2 من اتفاقية الرضا بالزواج، والمادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن المادة 2 والمادة 9 من الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وبخصوص حقوق ذوي الإعاقة؛ ويبلغ عدد المعاقين بالمغرب حوالي 2.264.672 شخصا، أي أن حوالي 6.8% من إجمالي الساكنة لديهم إعاقات تختلف أنواعها ودرجاتها. كما أن كل أسرة واحدة من بين أربعة أسر لديها على الأقل شخص معاق، وهي تمثل ما يقارب 24.5% من مجموع الأسر ببلادنا. وتشير الأرقام إلى أن 19.04% فقط، من هؤلاء الأشخاص هي التي تستفيد من الحماية الاجتماعية، أي أقل بكثير من الربع. وبغاية تحسين ولوج هذه الفئة للخدمات الصحية تمت تعبئة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، لتحسين تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة واقتناء الأجهزة الخاصة، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، والمساهمة في تحسين مراكز الاستقبال. إلا أن الواقع أثبت أن 60% من الأشخاص المعاقين لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات الصحية؛ إما لأسباب مالية أو وجود مؤسسات طبية بعيدة عنهم. ذلك أن الإحصائيات تفيد بأن 38% من المعاقين يعيشون في الوسط القروي، مما يحول بينهم وبين التمتع بهذه الخدمات.
وعموما فإن نسبة تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة من الفئة العمرية 6-17 سنة، لم تتجاوز 41.8% أي 33.000، وتشهد تفاوتا ملحوظا لا يوازي الإحصائيات العامة لتمدرس الأطفال في المؤسسات التعليمية. ذلك أن نسبة تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة من الفئة العمرية 6-11 سنة، حسب نتائج البحث الوطني هي 37.8%، في حين تبلغ النسبة الوطنية لتمدرس نفس الفئة العمرية 99.5%. وبالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 12-14سنة، فقد سجل البحث نسبة تمدرس لا تتعدى 50.1%، في الوقت الذي بلغت النسبة الوطنية لنفس الفئة العمرية 87.6%. أما عن نسبة تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة من الفئة العمرية 15-17سنة، فقد بلغت 39.9%، في حين أن النسبة الوطنية لتمدرس نفس الفئة العمرية هي 61.1%، وأن 79% من الأطفال المتمدرسين في الفئة العمرية بين 5 و17سنة، لا يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية.
وبالنسبة لتمدرس الأشخاص ذوي الإعاقة من 18إلى 40 سنة، فهي لا تتعدى 39.6% ممن تمكنوا من التمدرس، أما بالنسبة للباقي فغالبيتهم، أي 60.4%، لم تتمدرس بسبب غياب مؤسسات تعليمية تتلاءم واحتياجاتهم الخاصة. وقد اتضح أن 53.1% من الأشخاص ذوي الإعاقة من المتمدرسين يقطنون بالوسط الحضري مقابل % 25.4 يقطنون في الوسط القروي. كما لوحظ عدم تكافؤ في الفرص بين الجنسين، حيث أن 54.1% من الذكور تمكنوا من ولوج المدرسة مقابل 16% فقط من الإناث.
ويصل معدل الشغل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة في سن النشاط إلى 13.6%، أي ما يعادل 83.000 فردا من مجموع المعاقين البالغ عددهم 612.000، من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق. وتبلغ نسبة التشغيل 11.3% في الوسط الحضري مقابل 16.5% في الوسط القروي. كما أن 67.75% من الأشخاص ذوي الإعاقة، من متوسطة إلى عميقة جدا، في سن النشاط عاطلون عن العمل، أي 174.494 شخصا.
ويستفيد 34.1% فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة من أنظمة الحماية الاجتماعية، وأن ثلثي هؤلاء الأشخاص المؤمنين 60.8% منخرطون في نظام المساعدة الطبية (RAMED)، أما الباقي فهم منخرطون أساسا في أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بنسبة 15.4% وفي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) بنسبة 12.7%، في حين أن الآخرين لم يتمكنوا من الاستفادة من التغطية الاجتماعية لأسباب متعددة منها: فقدان بعض الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم الاجتماعية بسبب إعاقتهم.
وفيما يتعلق بحقوق المهاجرين/ات واللاجئين/ت وطالبي/ات اللجوء بالمغرب فإن سنة 2021 تعد جد صعبة، بالنظر إلى عوامل متعددة من بينها الحالة الاقتصادية والاجتماعية العصيبة؛ حيث يعتمد بعض المهاجرين وطالبي اللجوء على بعض المهن الموسمية أو الهامشية، فيما يلجأ البعض الآخر إلى التسول أو طلب المساعدات من الأسر أو بعض التحويلات من داخل المغرب أو خارجه.
وهكذا فحسب البحث الوطني حول الهجرة الدولية قامت به المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2018، ونشر سنة 2021، شكلت الأنشطة الممارسة المصدر الرئيسي لدخل المهاجرين/ات بالمغرب بنسبة تصل إلى 37.7%، 20.8% من ممارسة عمل دائم و17% من عمل صدفي أو موسمي. بينما يتكون المصدر الثاني للدخل لديهم من المساعدات أو التحويلات الواردة من أشخاص أو مؤسسات داخل المغرب بحصة 13.4%. وفي المرتبة الثالثة، يشكل التسول مصدرا ل 14.9% من المهاجرين. كما أن هناك مصادر دخل أخرى، منها دعم الأسرة، الذي صرح به حوالي 13.7% من المهاجرين/ات، والمساعدات أو التحويلات التي تم تلقيها من الخارج بنسبة 7.7%؛ وأخيرًا الادخار الخاص بنسبة 4.8%. أما بالنسبة للتغطية الصحية فتتميز بضعفها حيث يتوفر مهاجر/ة واحد من كل عشرة على تأمين صحي، تبلغ 10.7 ٪ لدى المهاجرين غير النظاميين مقابل 7.7٪ لدى اللاجئين.
كما استمرت الانتهاكات والخروقات لحقوق المهاجرات والمهاجرين وطالبي اللجوء وتنوعت، بين المطاردات والاعتقالات التعسفية والترحيلات، بالإضافة إلى العنف الجسدي والنفسي، وتدمير المآوي، وعدم تمتيعهم بحقوقهم الأساسية، وحرمان طالبي اللجوء من الحق في الاعتراف بصفتهم كلاجئين وبحقهم في الحماية وفي التجمع العائلي.
ومن جهة أخرى تزايدت محاولات هجرة الشباب المغربي في ظل وضعية اقتصادية صعبة، عمقت من آثارها السلبية وضعية كوفيد-19، وما رافقها من إجراءات، وتردي واقع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مما أدى إلى دفع العديد منهم إلى خوض مغامرات الهجرة المحفوفة بالكثير من المخاطر وإلى فقدان ووفاة العشرات منهم.
وبعدما أدت اتفاقات أوروبية مع تركيا وليبيا والمغرب إلى خفض عدد المهاجرين في البحر المتوسط، بات مزيد من المهاجرين يسلكون طريقا خطيرا، بين شمال غرب إفريقيا وجزر الكناري؛ حيث أدى ذلك إلى ارتفاع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال النصف الأول من سنة 2021، إذ بلغ 2087 في محاولة منهم للوصول إلى إسبانيا؛ وهوما يعادل تقريبا العدد الإجمالي للوفيات لسنة 2020 كاملة، حسب الإحصائيات التي قامت بها مجموعة "كامنندوفرونتراس" الإسبانية في تقريرها النصف سنوي، التي اعتبرت أن الطريق البحرية للمحيط الأطلسي من أجل الوصول إلى جزر الكناري كانت هي الأكثر نشاطا وفتكا بالمهاجرين، الذين وصل عددهم إلى 1922 ضحية.
وأخيرا، فإن التقرير خلص فيما يخص الحق في البيئية السليمة والتنمية المستدامة إلى أن المغرب يوجد، منذ أكثر من عشر سنوات، في مرحلة "الانتقال البيئي" المتزامنة مع مرحلة "تحوله السكاني والاجتماعي والاقتصادي"، والرهانات والتحديات التي يواجهها. وتوضح طبيعة وحجم المشاكل والقضايا البيئية المطروحة بجلاء بأن تدهور الموارد الطبيعية للبلاد، خاصة تلك الموارد غير متجددة، قد بلغ مستوى مقلقا وحرجا في بعض المناطق الهشة الحساسة.
وتتجلى حاليا هشاشة الأوساط البيئية في ندرة الموارد وتدهور العناصر البيئية. وهكذا فقد تراجعت حصة الفرد من الموارد المائية من 2560 م3 سنويا في 1960 إلى 620 م3 حاليا. وإذا تأكد المنحى المتبع حاليا فسوف تصل هذه الحصة إلى 500 م3 للفرد سنويا في غضون السنين القليلة القادمة. ويشتبه كذلك في أن جودة الهواء التي تزداد تدهورا هي السبب في وفاة آلاف الأشخاص سنويا. وبدوره يعاني التنوع البيولوجي أيضا من تدهور متزايد للمجال البيئي، خصوصا فيما يتعلق بفقدان نحو17000هكتار من الغابات سنويا. أما فيما يتعلق بالساحل، فإن جاذبيته لشتى أنواع الأنشطة أدت إلى استغلاله بشكل مفرط. وبالنسبة للتربة، فالمساحة الفلاحية المستغلة تتراجع بحوالي 3000 هكتار سنويا بسبب تمدد رقعة العمران، وفي نفس الوقت، فإن زحف التصحر يهدد مساحات كبيرة منها. تؤدي هذه المظاهر المختلفة لتدهور البيئة إلى عدة تأثيرات على إطار عيش السكان، تناهز اقتصاديا نسبة النمو السنوي للناتج الداخلي الخام بالمغرب PIB))، وهو ما عمق العجز البيئي للبلاد ليبلغ -1 هكتار شامل لكل نسمة، بينما كان المغرب يتمتع باحتياط مريح في فجر استقلاله. هذا دون ذكر بعض الأضرار التي لا تقدر بثمن مثل فقدان الأرواح البشرية، وانقراض الأنواع الحيوانية والنباتية.
ويستنتج من هذا أن مختلف الإشكاليات التي تؤثر على الوسط الطبيعي تتأتى إما من عوامل مباشرة وعوامل غير مباشرة، وإما من تفاعلهما معا في آن واحد. ويتضح كذلك بأن بعض العوامل غير المباشرة مثل الحكامة والنمو السكاني والعدالة البيئية والفقر تأتي في هذا التصنيف قبل حتى من العوامل المباشرة التي تعتبر عموما كمصادر رئيسية مضرة بالبيئة.
السيدات والسادة؛
تلكم هي حالة حقوق الإنسان ببلادنا، إنها ليست زاهية ولا مطمئنة، والمسؤولية في ذلك تقع على القائمين على رسمها على هذا النحو، بإيغالهم في التضييق على الحقوق الأساسية والحريات العامة، واختيارهم المضي قدما في التمكين للسلطوية وتقويض تطلعات الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية، وفي المساواة والعدالة الاجتماعية.
وفي الختام، نجدد لكم/ن الشكر، وندعوكم/ن إلى تصفح محاور التقرير لأخذ فكرة وافية وضافية حول الموضوع. وفي انتظار ذلك نحن كلنا آذان صاغية لأسئلتكم واستفساراتكم واستيضاحاتكم.
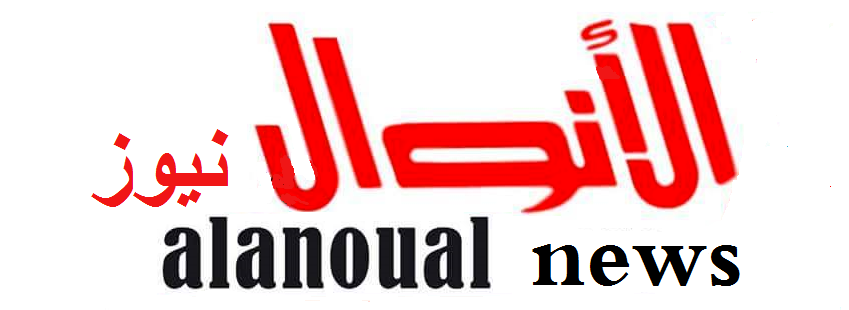
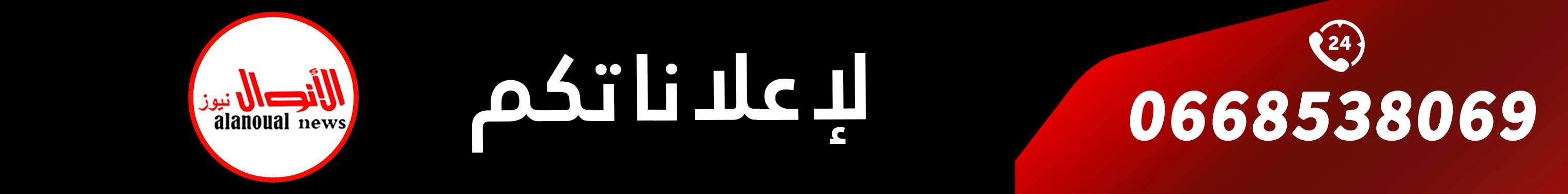
_3.jpg) ندوة دولية بتمارة حول موضوع: اليسار العالمي والمحلي وآفاق إعادة البناء
ندوة دولية بتمارة حول موضوع: اليسار العالمي والمحلي وآفاق إعادة البناء _5.jpg) فنانون عالميون وعرب يحيون ليالي مهرجان “موازين- إيقاعات العالم” 2025
فنانون عالميون وعرب يحيون ليالي مهرجان “موازين- إيقاعات العالم” 2025 _6.jpg) المبادرة الأطلسية الملكية،فرص التنمية والمخاطر الأمنية، موضوع ندوة علمية بسلا
المبادرة الأطلسية الملكية،فرص التنمية والمخاطر الأمنية، موضوع ندوة علمية بسلا _6.jpg) رئيس ودادية سطات السكنية يوجه اشعار الي المشاركين والمستفيدين و المتضررين الشطر الثاني والثالث الهرهورة يوضح أسباب عرقلة تقسيم العقاري
رئيس ودادية سطات السكنية يوجه اشعار الي المشاركين والمستفيدين و المتضررين الشطر الثاني والثالث الهرهورة يوضح أسباب عرقلة تقسيم العقاري 
_4.jpg)
_4.jpg)
أوكي..