التصوف المغربي بصيغة المؤنث: جوانب من الحضور الفاعل للمرأة المغربية في عوالم التصوف

الأنوال نيوز بقلم : د. خالد التوزاني
تمهيد
حظيت المرأة المسلمة عبر التاريخ بنصيب وافر من التقدير والاحترام، ولا سيما في العصور الأولى من عمر الإسلام، لكون النساء كان منهن العالمات والفقيهات والأديبات والمعلمات والصوفيات والمحدثات والطبيبات، غير أننا في هذه الدراسة سنركز على النساء الصوفيات، نظرا لكون التصوف في التمثلات الشائعة يقتصر على ذكر الرجال وكأن هذا المجال لا حظ فيه للمرأة، ولا ذكر لدورها فيه، مع أنها في الواقع أسهمت فيه بشكل جلي، وكانت وراء ظهور عدد من المتصوفة المشاهير.
لقد كانت المرأة حاضرة بقوة في التصوف الإسلامي، ولم يكن حضورها عابرا أو تجسيدا لإنسان عادي له دور اجتماعي معلوم، بل شكَّلت المرأة "تجسدا للحب الإلهي الذي يحيل إلى تجلي العلو في الصورة الفيزيائية المحسة، وشفرة استيطيقية توحي بانسجام الروحي والمادي، والمطلق المقيد في الأشكال المتعينة"، حيث تحولت المرأة لرمز استخدمه الصوفية بذكاء للتعبير عن تجربة روحية ذوقية، ولذلك لا عجب أن تحضر المرأة في أدبيات التصوف بشكل لافت للنظر، لتؤسس أصلا من أصول التصوف، حيث الارتباط المشيمي بالأنثى يفسر ضرورتها في التجربة الصوفية، وهو ما أكده ابن عربي حيث قال بأن: "المرأة صورة النفس، والرجل صورة الروح، فكما أن النفس جزء من الروح، فإن التعين النفسي أحد التعينات الداخلة تحت التعين الأول الروحي الذي هو آدم الحقيقي، وتنزل من تنزلاته، فالمرأة في الحقيقة جزء من الرجل، وكل جزء دليل على أصله، فالمرأة دليل على الرجل"، وهكذا شكَل الشوق والحنين والافتتان بالمرأة مجالا خصبا لخيال الصوفي كي يسبح في عوالم فسيحة من الإبداع، أهلته لإنتاج تراث أدبي خلاق لا نظير له، حيث الحضور الأنثوي كان وسيلة وغاية في الكتابات الصوفية، وفتح بابا للجمال والجلال في اللغة والفكر الصوفيين، حتى إن قراءة شعر ابن عربي دون استحضار خلفية صوفية في التأويل تجعله لا يختلف عن شعر أبي نواس في بعض أشعاره الغزلية، كما لا يبتعد كثيرا عن شعر أبي العلاء المعري في شعر الحكمة، ولا يختلف عن شعر أبي العتاهية في شعر الزهد، وهكذا فإن التأويل الصوفي للأنثى في أدبيات التصوف هو ما يعطي للأدب الصوفي خصوصيته، وإلا فإن دلالة المرأة واحدة، ولكنها في التصوف تأخذ معاني جديدة مختلفة عن المألوف والمتعارف عليه، وهو ما يفسر المدونة الغنية من الكتابات الصوفية التي تتحدث عن المرأة، باعتبارها فاعلا في الوجود متحكمة في الرقاب والمصائر، كما قال الشبلي:
لها في طرفها لحظات سحر تميت بها وتحيى من تريد
وتسبي العالميـن بمقلتيــهـا كـأن العالميـن لها عـبـيــد
من الواضح حجم "الحضور الأنثوي في التجربة الصوفية"، حيث شكلت المرأة بؤرة هذه التجربة، منطلقا وموئلا، وكانت دافعا للصوفية في إبداعاتهم وتحركاتهم، وظلت رمزا مقدسا، تحيطه هالة التعظيم والقداسة في جل نصوص القوم، غير أن التساؤل الوجيه الذي ينبغي طرحه في هذا السياق هو: ما الحضور الواقعي للمرأة باعتبارها شريكا للرجل في حياة الصوفية وليس فقط مجرد رمز مقدس؟ بمعنى توجيه السؤال نحو "النساء المتصوفات"، ما دورهن في التصوف الإسلامي؟ ماهي أهم النماذج التي حفلت بهن كتب التراجم والمناقب والكرامات، وخاصة ما تعلق بالمرأة المغربية؟
المرأة المغربية والتصوف الإسلامي
إذا كان رجال التصوف يتصدرون الميدان، وينتشر صيتهم في الآفاق، فإن ذلك لا يعني أنهم قد عاشوا حياة عزلة عن النساء، بل كانت المرأة حاضرة بقوة في حياة الصوفية، واستطاعت بأدوارها المتعددة أن تحقق القول الشائع: "وراء كل رجل عظيم امرأة"، فقد كانت المرأة المتصوفة زوجة للولي الصالح وأمًّا للولي فيما بعد، كما أسهمت في تربية المريدين الذين صار منهم أولياء.
يبرز دور المرأة في التصوف بشكل جلي من خلال المهام التي كانت تقوم بها، فإذا اشتهر رجال التصوف بالذكر والجهاد والتعليم والإرشاد، فإن المرأة قد قامت بالأدوار نفسها، وجمعت إلى جانبها أعمالها أخرى كإعداد الطعام وعلاج المرضى والاعتناء بالزوايا وتربية القادة، فضلا عن توجيه النساء وتعليمهن أمور دينهن.. فكانت بذلك العنصر الأكثر أهمية في مجتمع الصوفية، وعلى الرغم من عطاءاتها الكبيرة، إلا أنها لم تلق التقدير اللازم والاعتناء الواجب من المجتمع، وهو ما يفسر غياب أسماء مشهورة لنساء متصوفات، فلا يعرف العالم اليوم إلا المرأة الصالحة رابعة العدوية، بينما التاريخ قد ذكر نساء صالحات غيرها، فلم يشتهرن ولم يبلغ صداهن الآفاق، مما دفع بعض الباحثين للنبش في تاريخ تصوف المرأة، غير أن الدراسات العلمية في هذا المجال نادرة جدا، فمن بين البحوث التي يمكن أن نستدل بها في هذا السياق، نذكر العمل الذي قام به الباحث مصطفى عبد السلام المهماه، تحت عنوان: "المرأة المغربية والتصوف في القرن الحادي عشر الهجري"، والملاحظ أن معظم الدراسات قد أنجزت باللغات الأجنبية، حيث نجد عمل "مشيل شودكفيسك" (M.Chodkiewics ) الموسوم بـ (La sainteté féminine dans l’hagiographie islamique)، وأعمال الباحثة نـيلي عـمري سلامة التي خـصصـت جـانبا من أبحاثها للنساء الصـوفيـات من خلال: (Les femmes soufies ou la passion de Dieu)، حيث قاربت هذه الدراسات دور المرأة الصوفية في المجتمع وكيف كانت عاملا حاسما في خلق التوازنات وتحقيق الانسجام بين فئات المجتمع، وذلك نظرا لتواجدها ضمن مستويات متعددة من التدخل الاجتماعي والنفسي والتربوي وكذلك الاقتصادي والسياسي في كثير من الأحيان، علما أن هذا الحقل من الدراسة والبحث ما يزال يثير عددا من التساؤلات والإشكالات التي تحتاج في واقع الأمر إلى المزيد من النبش العميق في التراث الصوفي للنساء المغربيات من أجل فهم المحركات الخفية للمجتمع المغربي وبنيته الفكرية العميقة التي تقف وراء مجموعة من العادات المغربية والسلوكات.
يُجمع جل أصحاب كتب التراجم والمناقب، ممن أرخوا للصوفية رجالا ونساءا -قديما وحديثا- على ضياع أخبار العديد من النساء الصالحات اللواتي عُرفن بالعلم والصلاح والولاية، فهذا صاحب كتاب: "التنبيه على من لم يقع به من فاضلات فاس تنويه" يقول في مطلع كتابه: "ومعلوم من شأن أهل هذه البلاد (يقصد المغربية) عدم الاعتناء بالتعريف والتصدي لذلك بتأليف أو تصنيف، فكم من إمام به اعتناء واحتفال، بل ألقي في زوايا الإغفال والإهمال". ومن ثم، "لا جرم أن الباحث إذا أراد أن يبحث في المرأة العربية المسلمة، فإنه يجد عقبة كأداء لا يذللها إلا إذا مكث ردحا من الزمن، منقبا في بطون الأسفار المطبوعة والمخطوطة، لعله يظفر بطلبته ويدرك حاجته"، نظرا لقلة المصادر التي تتحدث عن سير النساء وتتبع أخبارهن.
بالعودة إلى بعض الرحلات، وخاصة تلك التي تتبعت الصلحاء والعلماء وحفلت بأخبار الأولياء، نستحضر الرحلة المسماة: ماء الموائد، لأبي سالم العياشي (ت 1090هـ)، والتي تذكر بعضا من مكاشفات امرأة زارها هذا الرحالة في مصر بعدما ترامى إلى سمعه بعضا من كراماتها، وهي الصالحة ست نعيمة، يقول أبو سالم العياشي: "ذهب بعض أصحابنا يوم دخولنا إلى الإسكندرية لزيارة الشيخة الصالحة ست نعيمة مستعجلين، وكانت نية أهل الركب أن لا يقيموا بالإسكندرية إلا يومين أو ثلاثة. وعندما دخلوا عليها قالت لهم: أنتم تقولون نقيم يومين أو ثلاثة، لا بد لكم من ستة أيام أو سبعة. فاستبعدنا ذلك غاية. فقلت لأصحابي: من هنا يظهر لنا صدقها أو خلافه. فكان الأمر كما قالت؛ أقمنا نحن سبعة أيام، وأقام الركب الجزائري ستة. وقد استفاض على ألسنة الحجاج كثيرا من المكاشفات عنها. وقد زرتها فلم أر شيئا من ذلك، والله أعلم بحقيقة الحال، والغالب أنها من أهل الأحوال. وقد أخبرتنا أن عمرها مائة وأربعة وستين وأربعة أشهر. وقالت: لا أدري هل أصل رمضان أم لا؟ ومن جملة ما قالت لنا: إن الغرب الآن في هذا الوقت أحرش، ولا تصلون إليه حتى تجدونه في خير كثير، ولا وباء فيه. وقالت أيضا: إن الدولة العثمانية قد انقرضت لظلم أهلها. وإن السلطان يأتينا من وراء فاس، يُبْطِل المكحلة والكابوس والمدفع، ويمشي الذئب مع النعجة. في كلام كثير لا أحفظه الآن. بعضه مصادق للواقع وبعضه الله أعلم بمرادها فيه. وقالت لنا أيضا: إن الركب لا خوف عليه، فإن أهل المشرق من أولياء الله قد تكفلوا به حتى يوصلوه إلى سيدي أحمد زروق، ومن هناك يتكفل به رجال الله من أهل المغرب. وما رأينا في الطريق والحمد لله إلا خيرا، مع ما كنا نتوقعه من الشرور والمحن في الطريق لقلة الركب مع اختلاف أهواء أهله".
إن قلة اهتمام المؤرخين بتتبع أخبار الصالحات من نساء المغرب المتصوفات قد أسهم في ضياع أخبار العديد منهن، مما يشكل خسارة للذاكرة الصوفية بالمغرب، وعلى الرغم من أن معظم الكتب التي تناولت مناقب الصوفية وجمعت تراجمهم وأخبارهم قد تناولت سير بعض النساء وأخبارهن إلى جانب الرجال إلا أن التركيز كان واضحا على الرجال دون النساء، ولم تكن تُذكر المرأة إلا إذا كانت زوجة لولي لها فضل كبير على زوجها، أو كانت أما لولي ربته وأنشأته نشأة صالحة.. حيث لا يتم ذكر المرأة المتصوفة في كتب التاريخ إلا إذا كانت أعمالها وإنجازاتها استثنائية وغير عادية، في حين توجد نساء أخريات كان لهن دور بارز لكن لم يكن أزواجا لأولياء أو لم ينجبن أولياء فلم يُعرفن ولم يذكرهن أحد.
هكذا نسجل إهمال المؤرخين الذين جمعوا أخبار الصوفية وتراجمهم الحديث عن المرأة بشكل مستفيض، حيث لم يعطوا المرأة المكانة اللائقة بها، ويبدو أن سبب ذلك راجع لعوامل اجتماعية ارتبطت بحصر دور المرأة على أعمال البيت وتربية الأبناء، وكأن المجتمع استكثر عليها القيادة الروحية والزعامة الصوفية، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء"، فالإسلام أعطى للمرأة دورا مهما وبارزا، وهو ما أفسح المجال لها لتبرز كفاءتها وقدرتها على القيادة والإنجاز مثل الرجل وربما أفضل في كثير من الحالات، وهكذا فالمرأة الصوفية حاضرة في التراث الصوفي بكثافة وإن لم تظهر في الواجهة أو تشتهر علانية.
أخذت نساء المغرب مكانة مرموقة في مجال الفكر الصوفي المغربي ويكفي أن تكون آثار كثير من النساء شاهدة عليهن؛ فجامع القرويين الذي يعد أول جامعة في العالم، إنما أسسته فاطمة أم البنين بنت محمد بن عبدالله الفهري عام 245 هـ، بينما أقامت أختها مريم جامع الأندلس الذي كان ينافس جامعة القرويين حوالي القرن الرابع الهجري، وقد برزت في هذا الميدان الأميرة الحسنى بنت سليمان النجاعي زوجة المولى إدريس الثاني، وعاتكة بنت الأمير علي بن عمر بن المولى إدريس زوجة الأمير يحيى التي كان لها دور بارز في تحرير مدينة فاس عام 281 هـ، حيث إن حضور المرأة في مجريات الأحداث التاريخية الكبرى بالمغرب كان حضورا فاعلا ومؤثرا وموجها لكثير من الأحداث.
هكذا، برز من النساء المغربيات ثلة كبيرة ممن كان لهن حظ عظيم في التصوف سلوكا وإرشادا وأنبت بينهن أخريات عرفن بالعلم والأدب ونظم الشعر، فما هي أهم النماذج التي نستدل بها على رسوخ التصوف في نساء المغرب؟
نماذج من النساء الصوفيات
تحفل كتب المناقب والتراجم بكثير من النساء المتصوفات والعالمات، ولا شك أن كتاب "التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي" لصاحبه أبي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المشهور (بابن الزيات) ( 627هـ أو 628هـ) يعتبر من أهم كتب المناقب التي تؤرخ لمسألة الصلاح والولاية في المغرب إبان العصر الوسيط، حيث حاول التادلي في هذا الكتاب التعريف بجملة من الصالحين الذين بلغ عددهم في الكتاب مائتين وسبعة وسبعين رجلا وامرأة، منهم تسعة عشر من المجاهيل ينتمي معظمهم إلى مدينة مراكش وأحوازها أو ممن زاروها أو أقبروا فيها.
ويخبرنا التادلي في كتابه "التشوف إلى رجال التصوف" أثناء حديثه عن امرأة صالحة عن إحدى الرباطات التي كان يرابط بها العديد من النساء الشهيرات بالصلاح والولاية فيقول: "كنت توجهت من مراكش إلى "رباط شاكر" في شهر رمضان عام ثلاثة وستمائة مع جماعة من الفضلاء فأقمنا بها إلى ليلة سبع وعشرين فقمنا في الثلث الآخر من الليل وأسرينا فرارا من شدة الحر بالنهار فاتبعنا جمع كثير من الرجال والنساء "، كما ورد ذكر هذا الرباط مرة أخرى في التشوف أثناء ترجمته للمرأة الصالحة منية بنت ميمون الدكالي حين قال: "وحدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال رأيت منية برباط شاكر"، ويضف قائلا: "فأخبرني بعض من تحدث معها (يقصد منية بنت ميمون) من المريدين أنها قالت حضر هذا العام بهذا الرباط ألف امرأة من الأولياء ".
ولا شك أن توافد هذا الكم الهائل من النساء الشهيرات بالصلاح والولاية من مختلف جهات المغرب لحضور هذا الملتقى العلمي والروحي، يدل دلالة واضحة على تشوف نساء المغرب إلى تحصيل قيم المحبة والتعاون والترقي في مدارج الكمال الإنساني، واحتلالهم لمكانة مرموقة في التصوف سلوكا وإرشادا.
ومن النماذج التي نستدل بها على رسوخ قدم المرأة المغربية في العلم والثقافة والسلوك الصوفي والمكانة الاجتماعية الرفيعة، نستحضر الأمثلة الآتية:
أم طلحة اللمتونية: وهي تميمة بنت يوسف بن تاشفين كانت راجحة العقل، جيدة الذاكرة سكنت مدينة فاس اشتهرت بالأدب والكرم ذات ثروة تشرف على إدارة دواليبها ولها كتبة تحاسبهم بنفسها.
زينب بنت الخليفة يوسف بن عبد المومن بن علي الموحدي: تزوجها ابن عمها أبو زيد بن أبي حفص عمر بن عبد المومن، أخذت علم الكلام وأصول الدين عن أبي عبدالله بن إبراهيم إمام التعاليم والفنون فكانت عالمة صائبة الرأي.
خناثة بنت بكار زوجة السلطان المولى إسماعيل التي كانت عالمة صالحة، كان يعهد إليها الكتابات السردية في القصور الملكية.
رقية بنت الحاج العايش اليعقوبية: أديبة وفقيهة وعارفة باللغة والتفسير والشعر والسيرة النبوية وأسرار الحروف والأسماء، درس عليها الرجال والنساء خاصة التفسير، حيث كانت تتوخى أسباب النزول وعلوم القرآن.
مسعودة بنت أحمد بن عبد الله الوزكيتي: تعرف بعودة أم المنصور الذهبي، اهتمت بإصلاح السبل وعمارتها وتأمين أهلها وتشييد النزلات بالأمكنة الخالية في الصحراء والبادية المغربية، وقد أصلحت جسر وادي أم الربيع، وجهزت اليتامى وزوَّجت الأرامل، وبنت مسجد باب دكالة بمراكش عام 965 هـ، وأوقفت عليه نحو سبعين حانوتا وأسست بإزائه مدرسة للطلبة الغرباء ومكتبة وذخائر كتبت على بعضها بخط يدها منها الجزء الأول (من بيان الإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لأبي الحسن علي بن القطان).
من أهم الكتب التي أرخت لكبار الصلحاء والصالحات، نستحضر كتاب: "سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس"؛ سلوة ضمت أنفاسَ خاصة الناس وعامتهم، رجالهم ونسائهم، بل شملت حتى الشهيرات بأحوال الجذب من الهائمات في جمال الأنس، الغائبات عن جميع الرسوم والأكوان، فكان لهذا الكتاب دور في إماطة اللثام عن تراجم هؤلاء الصلحاء والصالحات، معتمدا في ذلك كله أسلوب الحكي والسرد تارة، والتلويح والإشارة تارة أخرى، قاصدا بذلك إيقاظ الهمم وشحذ العزائم، وممن ورد ذكرهن في كتاب "سلوة الأنفاس"؛ نجد العالمة والمتعلمة والمرشدة والمنقطعة وربة البيت، كلهن شموس للاقتداء ونجوم للاهتداء، وعلامة من علامات تميز المرأة المغربية في التصوف:
السيدة فاطمة بنت عبد الله: امرأة صالحة طاهرة عفيفة، اشتهرت بالصلاح والولاية، وكثرة البرور ببعلها، والقيام بشؤون أسرتها، وإكرام ضيفها، واحترام جارها، وبسبب هذه الخصال نالت من الفضل العظيم ما نالت. وقد عاصرت الشيخ العارف بالله سيدي إبراهيم الزواري، الذي كان يكن لها احتراما وتقديرا كبيرين، فقرر زيارتها في بيتها الكائن بزنقة "حجامة" بفاس القرويين، فطرق الباب وفتحت له واستضافته، فتأمل أحوالها في العادات والعبادات فوجدها لا تزيد على أداء الفرائض وما يتعلق بها الكثير، سوى أنها كانت كثيرة البرور بزوجها، فعلم الشيخ أن هذه السيدة نالت ما نالت من الفضل بقيامها بحقوق الله تعالى فيما أمرها به من حق اتجاه زوجها.
السيدة آمنة بنت سيدي عبد الرحمن الفاسي: هي أخت العلامة سيدي محمد بن عبد الرحمن الفاسي، المرأة المقعدة الصالحة القانتة، جمعت مكارم الأخلاق كلها؛ من حلم وهيبة وسكينة ووقار ولين، وكان لسانها لا يفتر عن ذكر الله، تلازم الصمت في كل وقت وحين، لها سبحة لا تفارق أناملها في الصحة والمرض، و لها من الناس أتباع يلازمونها، فإذا اجتمع إليها النساء وأكثرن الكلام في مجلسها بغير ذكر الله، زجرتهن وأمرت بخروجهن عنها. توفيت رحمها الله أوائل ذي الحجة الحرام متم سنة تسع وثلاثين ومائة وألف للهجرة، ودفنت بزاوية جدها عند الباب بروضة الحاج الشعير بفاس.
المجذوبة السيدة آمنة الساكمة: امرأة غائبة منقطعة عما سوى الله، كانت تعتريها أحوال الجذب فتلزم الصمت والسكون، وتغضب إذا انتهكت حرمات الله، وكانت ذات هيبة ووقار، ولا تطلب من أحد شيئا، ومن أعطاها شيئا أخذته، وفي بعض الأحيان تمتنع عن أخذه، أو تعطيه للغير. ولها مكان تجلس فيه بجانب حوانيت الشطَاطَبِيين بسوق الغزل من فاس القرويين، وكان الناس ينسبونها إلى الخير والصلاح. توفيت رحمها الله حوالي سنة خمسين ومائة وألف، ودفنت قرب باب الساكمة، وضريحها هناك إلى يوم الناس هذا، ولعل سبب تسميتها بالساكمة، راجع لكثرة صيامها، حيث سميت على نفنفتها سايمة أي صايمة.
العارفة بالله السيدة رقية بنت محمد بن عبد الله معن: امرأة صادقة منقطعة عن الدنيا وزخرفها، وهي بنت الشيخ محمد بن عبد الله معن دفينة خارج باب الفتوح بمدينة فاس، ورثت عن والدتها السيدة عائشة بنت شقرون الفخار أحوالا سنية وأخلاقا كريمة، وكان أخوها الأصغر كثير التعظيم لها والثناء عليها، فقد شهد لها بالمعرفة والرسوخ في طريق القوم، ومما يؤثر عنها أنها كانت زاهدة في الدنيا رافعة همتها متعففة عما في أيدي الناس، وفي يوم وفاتها فرحت فرحا شديدا، وقبل لحظات من وفاتها سألت عن دخول وقت صلاة الظهر؟ فقيل لها أن مؤذن الزوال قد أذن، فصلت الظهر والتحقت بالرفيق الأعلى. وقد حضر جنازتها ثلة من العلماء الأفاضل، ووري جثمانها الثرى بعد زوال يوم السبت حادي عشر ذي القعدة سنة سبع وثمانين وألف.
العالمة السيدة عائشة بنت علي بونافع: حفيدة الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي من بنته السيدة آمنة، كانت لينة الكلام، كريمة المعاشرة خصوصا مع بعلها، ذات أخلاق عالية وخاصة الصبر، فقد توفي زوجها وأولادها منه والكثير من أفراد عائلتها ولم تبك على أحد منهم بكاء الصياح والنحيب، وإنما صدر منها بكاء خفيف بالدمع لا غير، وكانت كثيرة الذكر والمواظبة على قراءة الأوراد وزيارة الصالحين والصالحات، ومحبة أهل العلم والخير من المنتسبين، كما يروى عنها ملازمة مجالس العلم، وخاصة "مجلس البخاري" على أبي العباس بن مبارك الذي يُقَام بعد صلاة الصبح بضريح المولى إدريس الأزهر، وتحضر أيضا مجالس وَلَدها سيدي عبد المجيد في "النصيحة الكافية" و"رسالة بن أبي زيد" و"شمائل الترمذي" التي كانت تقام مابين العشائين وبعد صلاة الصبح بالضريح الإدريسي. توفيت رحمة الله عليها سنة سبعة وسبعين ومائة وألف.
مما سبق، يمكن القول إن الكتاني استطاع من خلال مؤلفه "سلوة الأنفاس"، أن يسلط الضوء على مجموعة من النساء الشهيرات بالعلم والصلاح والولاية باعتبارهن فاعلات بسلوكهن الصوفي والأخلاقي في المجتمع، ولعل الباعث والقصد الخفي غير المعلن الذي جعل الكتاني يخصص صفحات من كتابه "السلوة" لسرد سير وأخبار هذه الطائفة من صالحات فاس اللائي استطعن بثقافتهن وسلوكهن الصوفي المتفاعل مع المجتمع ترسيخ مجموعة من القيم الإنسانية السامية، يتمثل أساسا في رغبة المؤلف الجامحة في إحياء قيم أخلاقية سامية عرفها المجتمع المغربي وكانت صمام أمان لاستقراره ونهضته.
كذلك من نساء المغرب وخاصة في الجنوب، نستحضر والدة العلامة المغربي المختار السوسي، ويتعلق الأمر بالسيدة رقية بنت محمد بن العربي الأدوزي (ت1342هـ)، يقول عنها ولدها العلامة المختار السوسي: "كانت أول معلمة من النساء في "إلغ"، ومهذِّبة البنات في دار والدي، فبها انتشر ما انتشر من ذلك فيهن (...) أتقنت حفظ كتاب الله (...) أيقظتني يوما فناولتني كأسا مملوءة ماء، فقالت: إن هذا الماء ماء زمزم الذي هو لما شُرِبَ له، وهذا سحر يوم عظيم، وهو مظنة الاستجابة، فاشرب منه وانوِ في قلبك أن يرزقك الله العلم الذي أتمناه لك دائما. فأفرغت الماء في حلقي بنيتها هي التي تدري ما تطلب وما تنوي إذ ذاك، ثم استلقيت ثانيا في مضجعي وأنا حينذاك، ولا أكذب القارئ لا نية لي، ولا أقصد بشربي لما قدّمته لي بسرعة، إلا أن أرجع إلى الاستمتاع بنومي لا غير"، وقد توفيت سنة 1342ھـ.
وأيضا رابعة زمانها فاطمة بنت محمد المشهورة بـ" تاعلاَّت الهلالية" (ت1207هـ)، والتي عاشت في سوس، وعُرفت بالصلاح والتقوى، وأثرت عنها كرامات عديدة، وقد كانت معمرة ومسنة حيث عاشت قرنا كاملا حتى تجاوز عمرها أكثر من 110 سنة، ويقام إزاء ضريحها موسم ديني حافل، أسس عام 1255ھ، أسسه الحاج أحمد إكني الحاحي الذي نزل بتارودانت وتِدسي، وأثر أطلال داره باقية بتِدسي، وقد كان هذا الموسم زاخرا بتلاوة كتاب الله عز وجل، ومليء بالطلبة يأتون إليه من كل فج عميق، ويعكفون على قراءة القرآن ليل نهار، وما زال إلى يومنا هذا.
هكذا، نخلص إلى نتيجة مفادها أن المرأة المغربية قد لعبت أدورا طلائعية في التصوف، فكانت مريدة وعالمة وزاهدة وصالحة وصاحبة كرامات، وأسهمت في تنشيط الحياة الروحية والعلمية في المغرب، حيث برزت في تاريخ المغرب نساء نابغات وشهيرات، سجل التاريخ أسماءهن بمداد الفخر، وخلد ذكرهن في ميادين الولاية والصلاح والعلم والمعرفة.
لم تحظ النسوة المتصوفات بما حظي به الرجال الصوفية من احتفاء وذكر متكرر في كتب التراجم والمناقب، حيث تم تغييب كثير من النساء، ولم يحتفظ التاريخ إلا بالجزء اليسير من متصوفات المغرب، ولعل ذلك راجع للبنية الذهنية التي تستكثر على المرأة احتلال مواقع القيادة والتأثير والسلطة الدينية أو الاجتماعية، كما أن العقلية الذكورية في المجتمع حالت دون الاحتفاء بالنساء الرائدات في الجانب الروحي، وعلى الرغم من هذا التغييب أو الإهمال الذي طال كثيرا من النساء، إلا أن بعض المصادر التاريخية حفلت بنماذج من نسوة متصوفات، حيث شكلت تلك المصادر نقطة انطلاق في اتجاه الكشف عن جوانب غامضة من إسهام المرأة في التصوف.
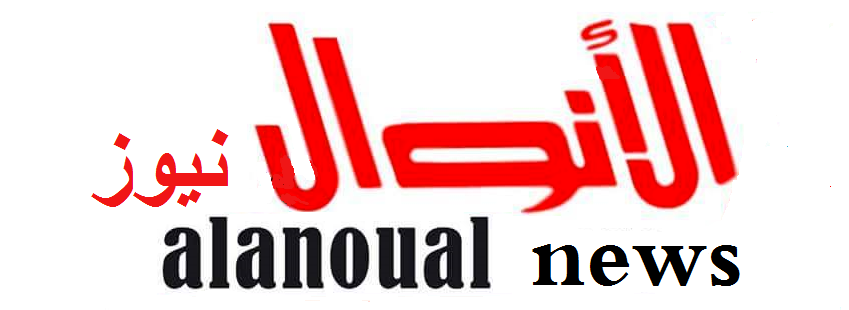
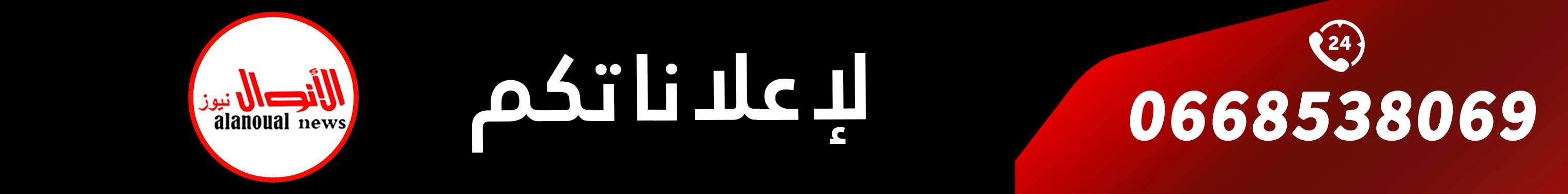
_3.jpg) جلالة الملك يُعطي بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش
جلالة الملك يُعطي بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش _2.jpg) حرب مبابي وسان جيرمان تشتعل.. تجميد 55 مليون يورو وتهديد بسحب رخصة النادي
حرب مبابي وسان جيرمان تشتعل.. تجميد 55 مليون يورو وتهديد بسحب رخصة النادي  كوادالاخارا،المكسيك – تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في قلب الحركة التعاضدية العالمية
كوادالاخارا،المكسيك – تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في قلب الحركة التعاضدية العالمية _5.jpg) أحدهم مواليد الجزائر.. من أبرز المرشحين لخلافة البابا فرنسيس؟
أحدهم مواليد الجزائر.. من أبرز المرشحين لخلافة البابا فرنسيس؟ 


أوكي..