التصوف في مواجهة الأزمات المعاصرة: عندما تصبح الأزمة دافعا لتقوية الجانب الروحي في الإنسان

الأنوال نيوز: بقلم الدكتور خالد التوزاني
يكاد يجمع الدارسون على اعتبار بداية القرن العاشر والحادي عشر الهجري (16-17 ميلادي) عصرا للأولياء والكرامات، حيث كثرت التآليف الصوفية، وانتشر تأسيس الرباطات والزوايا. وبالعودة إلى التاريخ فإن بداية هذه الفترة تزامنت مع محن وأزمات عاشها الناس، " وقد بين الحسن الوزاني المعروف عند الأوربيين Jean Léon l’african في كتابه "وصف إفريقيا" الحالة المزرية التي كانت عليها المؤسسات الدينية بالمغرب في مطلع القرن الهجري العاشر 16م-، فذكر أن مسجد الكتبيين بمراكش الذي قال عنه أنه من أجمل مساجد العالم، مهمل لا تقام فيه غير صلاة الجمعة، ويصعب الوصول إليه بسبب أنقاض الخرائب المتراكمة في طريقه. وأن المائة دكان لبيع الكتب المجاورة للمسجد تهدمت ولم يبق لها أثر. وقال عن جامع القرويين إن الدراسة فيه ضعفت وقل عدد الأساتذة والطلبة. وأن الحالة الثقافية، نتيجة لذلك تدهورت في فاس وفي سائر مدن إفريقيا". فحسب أحد الباحثين، "لم ير المغرب في تاريخه عصرا أكثر فوضى، وفتنا وضعفا وتطاحنا على الرئاسة من آخر عصر السعديين في النصف الأول من القرن الحادي عشر، وذلك بسبب تطلع كل أبناء المنصور الذهبي للملك وتقاتلهم عليه، مما أدى للخراب، وقيام الثوار في كل ناحية، واستيلاء الأجانب من برتغال وإنكليز على مراسي المغرب وطمعهم في داخله".
وهذا دليل يوضح جانبا من الأزمة التي كانت سائدة أنذاك. وباعتبار الزاوية "المكان الذي يجتمع فيه الشيخ مع أتباعه ومريديه وتلاميذه، ومكانا يتخذ للعبادة والتعليم، كما يتخذ للإطعام والإيواء، وقد يتخذ للتعبئة والجهاد حين يقتضي الأمر ذلك" فإن الزاوية تبعا لذلك، هي الإطار المؤسس الذي تندرج داخله الممارسة الصوفية وأيضا المركز الذي تنطلق منه الدعوة إلى هذه الممارسة والحفاظ على تعاليمها، ويترتب على ذلك أن كثرت الزوايا وانتشارها يدل على رسوخ قدم التصوف في البلاد وشيوعه.
يبدو أن عددا من الزوايا بالمغرب قد أفرزها واقع المجتمع المضطرب والمتأزم، فهذه الزاوية الوزانية تتأسس "في وقت كانت الفتن فيه كنزول المطر من السماء، حروب طاحنة متوالية بين السعديين والعلويين، وبين المسلمين والإسبان والانجليز، وبين ثوار متلصصين هدفهم الإفساد في الأرض ونهب الأموال. يضاف إلى ذلك، ما كان يصاب به الناس كضيق في المعيشة، وارتفاع في الأسعار، وجذب وقحط وزلازل وهزات". فكانت الرباطات "ملاذا لكل المقهورين والمتذمرين"، حيث هبت الزاوية "للدفاع عن مصالح المتضررين في فترات التأزم واشتداد الظلم والطغيان"، مما جعلها مؤسسة متفردة أنقذت المغرب من ويلات الجوع والفتن عبر إطعام الطعام وإرشاد الحيران والأخذ بيد المحتاج والإسهام في "تشكيل تصرفات الأفراد" وتوجيه ردود أفعالهم تجاه الأزمة، وجدير بالذكر أن صوفية المغرب بعد إرشاد العباد إلى عبادة ملك العباد وتأمين الغذاء والإيواء ونشر العلم والأخلاق، كانوا يتطلعون لتحرير الثغور وترسيخ الأمن في البلاد، "فرجال التصوف كانوا هم روح الجهاد المغربي"، "فالزاوية وإن كانت تنطلق عند تأسيسها، من البعد الصوفي الديني، فإنها سرعان ما كانت تنتقل إلى البعد الاقتصادي ثم السياسي".. فكانت بذلك صمام أمان لوحدة المغاربة زمن المحن وأوقات الفتن.
من خلال تحليل الآراء السابقة، خاصة تلك التي تربط انتعاش التصوف وازدهاره بتخلف المجتمع وانهياره، نلاحظ أن هذه الآراء تحمل في طياتها تناقضا خفيا، مفاده أن الزوايا تظهر زمن الفتن التي تصيب المجتمع باعتبارها عرضا من أعراض الأزمة، وفي الآن ذاته يكون ظهورها سببا في تخطي هذه الأزمة وإعادة التوازن، فكيف يكون العرَض سببا في الشفاء من الداء ؟ إلا إذا كان هذا العرَض علامة على وجود نوع من المقاومة للداء، وما تجلي العرض إلا إيذانا بقرب الشفاء، ومن ثم، فالفضل في الشفاء يرجع لتلك المقاومة لا للعرض، ولعله تناقض على مستوى الظاهر فحسب، فالزاوية يمكن اعتبار تأسيسها مقاومة للتخلف ما دامت تنشر العلم والإيمان، وهي كذلك مقاومة للجوع والظلم ما دامت تطعم الطعام وتنصر المظلوم، حيث إن ظهور الزوايا خلال الفترات العصيبة من تاريخ المغرب، لم يرسخ الوضع السائد بقدر ما تصدى للواقع المتردي وعبر عن رفضه له، بل قدم البديل وأسهم في التغيير الإيجابي، حتى سار بالمجتمع نحو بر الأمان وتجاوز الظروف الصعبة بأقل الخسائر الممكنة، ولم يكتف بذلك، بل كان له إسهام واضح في ازدهار الحضارة والفكر والأخلاق داخل هذا المجتمع، من خلال "إغناء الحركة الفكرية والأدبية بالمغرب". فليس ظهور التصوف بسبب التخلف وإنما برز لمحو التخلف، وتحقيق نوع من التوازن المفقود عندما يبالغ أفراد المجتمع في التعلق بالدنيا مبتعدين عن المنهج الرباني.
تميز التصوف في تاريخ المغرب في علاقته بالمجتمع بالفاعلية والحركية، مما يدل على يقظة القوم وواقعية فكرهم، وإلا لما نجحوا في إنقاذ البلاد من ويلات الفتن والحروب، باقتراح بديل "قوامه المحبة والإخلاص والإسهام في بناء مجتمع حضاري يحافظ على ثوابته". ومن ثم، فالقول بأن التصوف مرتبط في الأغلب بحالة بؤس المجتمع وتخلفه ليس سببا كافيا لتبرير صعود نجم التصوف في المجتمعات التي تعيش وضعا صعبا، وإنما يمكن الإشارة إلى أن التصوف موجود في كل الأوقات، لكن تظهر بصمته بشكل واضح جدا عندما تتخلى باقي الفئات داخل الأمة عن دورها، فعمل الصوفية في العادة يكون في الخفاء والستر، حتى إذا دعت الضرورة إلى الظهور والبروز، قام الصوفية بالواجب تجاه الأمة؛ فقدموا الدعم المطلوب، وأقاموا لذلك المساجد والرباطات والزوايا، وبرزوا في البلاد حتى إذا علا نجمهم فيها وطفقت شهرت أعلامهم الآفاق، ظهر الأدعياء فأفسدوا صفاء التصوف مقابل متاع الدنيا وحظ النفس من الشهرة والجاه..
إن "التصوف المغربي وفي لحظات الشدة لم يكن ليركن إلى الرباط ليختلي بنفسه فيه، بل كان يترجم معاني حبه لله في الارتكان إلى طلب لقائه عبر سبيل الجهاد"، كما "دأبت الزوايا على القيام بدور أساسي في نشر العلم". وواضح أن التصوف الإسلامي بالمغرب قد قدم خدمات جليلة للمجتمع المغربي طيلة قرون مضت، واليوم أيضا ما زالت بعض الزوايا تسهم في تفعيل المواطنة وتخليق الحياة العامة عبر حلقات الذكر وتحفيظ القرآن الكريم وتقديم دروس في محو الأمية وفي نشر العلم والمعرفة، بل وأيضا الإسهام الفعال في أعمال اجتماعية مثل تقديم مساعدات مادية للأسر المعوزة والفقيرة ورعاية المعوقين وتنظيم قوافل طبية تجوب المناطق النائية والصعبة لتوصل العلاج والدواء لمغاربة المغرب العميق، ولعل هذا المنهج ليس غريبا عن التصوف المغربي بل هو أمر مألوف ومتعارف عليه، فلا ينكر فضل التصوف بالمغرب ومدى إسهامه في بناء المغرب القوي إلا جاحد متنكر لهويته وتاريخه.
هوامش:
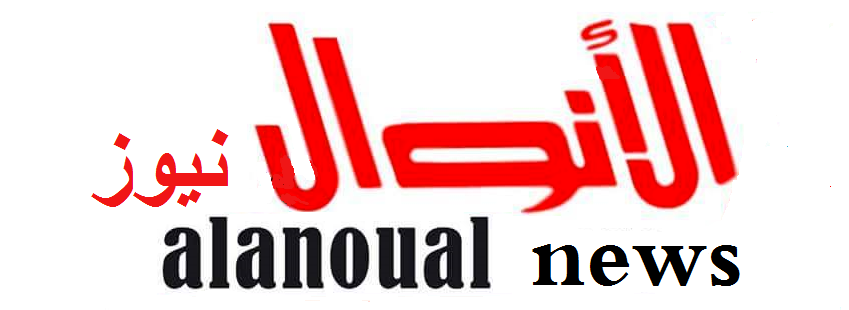
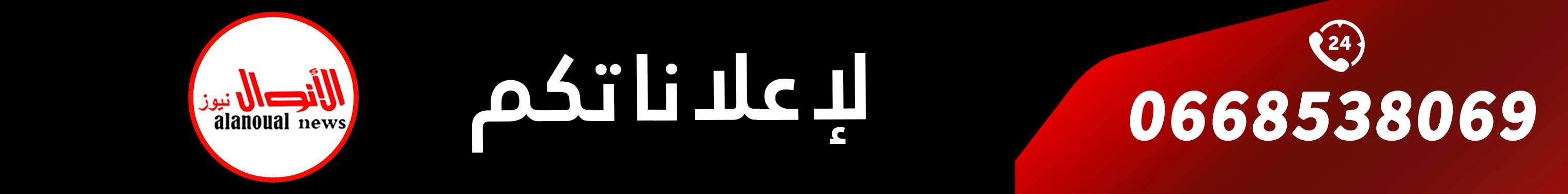
_7.jpg) تكلفة عملية دعم الحكومة للاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم
تكلفة عملية دعم الحكومة للاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم _5.jpg) مدير مستشفى الزموري ياسين الحفاني ينوه تدخل أمني ناجح حول تفكيك ما يُعرف بـ"عصابة المستشفى الزموري"على خلفية الرشوة والإبتزاز
مدير مستشفى الزموري ياسين الحفاني ينوه تدخل أمني ناجح حول تفكيك ما يُعرف بـ"عصابة المستشفى الزموري"على خلفية الرشوة والإبتزاز  ندوة علمية بسلا تناقش المبادرة الملكية الأطلسية:" فرص التنمية والمخاطر الأمنية"
ندوة علمية بسلا تناقش المبادرة الملكية الأطلسية:" فرص التنمية والمخاطر الأمنية" 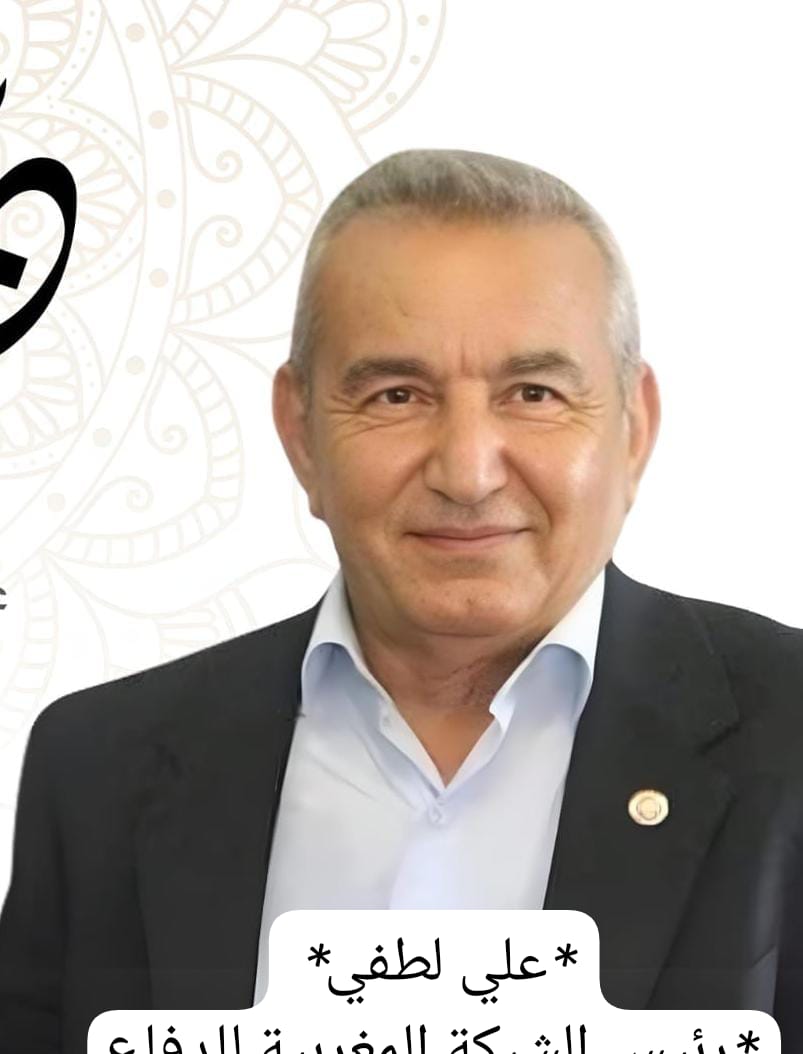 تحتفل الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الحياة 7 أبريل يوم الصحة العالمي
تحتفل الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الحياة 7 أبريل يوم الصحة العالمي 


أوكي..