رحلات المتصوفة في خدمة الأمن الروحي للمغاربة

الأنوال نيوز بقلم: الدكتور خالد التوزاني
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جوانب من الأمن الروحي للمغاربة كما طمحت إلى تحقيقه رحلات الصوفية، باعتبار هذا النوع من الأمن جهادا من أجل تعزيز عمران الإنسان والكون وبناء شخصية مطمئنة وقوية إيمانيا وروحيا، تكون قادرة على تجاوز إكراهات الذات والآخر والمحيط، والانتقال من الوضع الطبيعي القائم على الضرورات الحسية وصعوبات التكيف، إلى وضع الإنسان الكامل القائم على مكارم الأخلاق ومقامات الإحسان والقرب من الحق، وذلك بتتبع تجليات هذا الأمن في نموذج رحلة "ماء الموائد" لأبي سالم العياشي (ت1090هـ)، التي كان دافعها الأساسي هو مخدمة الأمن الروحي للمغاربة عبر السفر من وضع قلق بئيس ومحبط إلى آخر مشرق بالأمل ومحفز على العمل، بعدما اشتدت المحن وكثرة الفتن في مغرب القرن الحادي عشر الهجري واهتز الأمن في مختلف مستوياته وتجلياته، فقرر المتصوف العياشي الرحلة إلى خير الورى يتوسل به في دفع الردى، عبر رحلة الحج، وليكرر السفر أكثر من مرة بحثا عن الأمن الروحي المفتقد.
إذا كان خوض الرحلة أمرا في غاية الروعة والجمال، فإن "أروع الرحلات هي التي نقوم بها في رحلات الآخرين"، ومعنى ذلك، أن دراسة الرحلات من أمتع الأشياء وأجملها وأكثر الموضوعات فائدة ولذة، لما تتيحه من سفر علمي ووجداني يعيد للنفس أمنها الروحي ويعزز ثقتها في تراثها وأملها في مستقبلها، ولعل ما يعزز من قيمة نتائج هذه الدراسة هي تلك الألفة التي خلقها الباحث مع الرحلة العياشية ، خاصة وأن "العمل الفني إذا اقتصرنا على تذوقه للمرة الأولى فمن المحقق أن أشياء كثيرة ستفوتنا، أما إذا أتيحت لنا الألفة معه مرة ومرات سوف نزداد معرفة بحقيقته". ويضاف إلى ذلك، أن الدارس ينبغي أن يقارب النصوص الصوفية بمرجعية صوفية تستحضر خصوصيات النص الصوفي القائم على جملة من السمات مثل الإشارة والرمز والإلهام..، تلون النص وتمنحه طابعا خاصا، وبذلك فإن جمالية التلقي باعتبارها منهجا في مقاربة النصوص، يمكن أن تخدم فهم النص الصوفي وكشف جمالياته.
عندما يفقد المجتمع توازنه وتختل المعايير الضابطة للاستقرار، ويغيب الأمن بكل تجلياته ومجالاته، تصبح الرحلة ضرورية للخلاص من مرارة الواقع ولتأسيس أمن روحي متجدد لا يستقيم إلا بالعودة إلى المنبع الطاهر حيث أرض الرسالات ومهبط الوحي. وقد كان خروج العياشي من بلده المغرب في أزمنة الفتنة أشد إيلاما من احتساء السم الناقع، كما قال: "ومزجنا بحلاوة المتوقع مرارة الواقع، وقد يستشفى من بعض الأدواء باحتساء السم الناقع،" سم الغربة ومفارقة الأهل والديار، لكنه نافع في دفع الأسواء وإزالة الأدواء وإحياء الأمن الروحي المفتقد، كما قال العياشي: "وقد نفعتهم والله أي نفع، ودفعت عنهم مع غيبتي أعظم دفع، وأي نفع ودفع أعظم من المثول بين يدي النبي ﷺ بكرة وعشيا، في أوقات الشدائد التي كانت عليهم، والأهوال التي صارت لديهم، أستشفع به إلى الله في دفع الأسواء، وإزالة الأدواء" . مما أسهم في خدمة الأمن الروحي للمغاربة ونشره وترسيخه.
هكذا، قامت الدراسة في ضوء المنطلقات السابقة على تعرف مفهومي الأمن والرحلة، وتتبع خصوصيات الرحلة عند المغاربة وضرورتها، مع التركيز على نظرة الصوفية للسفر، وإبراز حاجة المغاربة للأمن الروحي خلال القرن الحادي عشر الهجري، ثم تتبع تجليات الأمن الروحي في نموذج رحلة "ماء الموائد" لأبي سالم العياشي.
مفهوم الأمن الروحي
يعد مفهوم الأمن الروحي من المفاهيم الحديثة نسبيا، حيث لم يكن هذا المصطلح متداولا في التاريخ الثقافي والفكري الإنساني، وإنما ظهر في العقود الأخيرة نتيجة تزايد ظاهرة التطرف الديني والغلو وفوضى الفتاوى والانحرافات في فهم الدين، مما تسبب في زعزعة استقرار بعض المجتمعات والشعوب واهتزاز أمنها، ومن ثم برزت الحاجة للأمن الروحي، خاصة مع ما يشهده العالم اليوم من حروب وفتن وأزمات وأمراض، حوّلت حياة كثير من الناس إلى قلق وتوتر وخوف دائم.
ورد الأمن في القرآن الكريم، نقيضا للخوف والفزع ، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ ، وكذلك في قوله عز وجل: ﴿وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ .
كما ورد الأمن مرتبطا بطمأنينة القلب وسكينة النفس، في قوله تعالى: ﴿أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ، وقوله عز من قائل: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ . فالأمن يزيل الخوف ويبعده ويحقق طمأنينة القلب وسكينته، وهو من نعم الله تعالى على عباده، فمن أسمائه الحسنى "المؤمن"، يقول تعالى: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ ، فالذي ينشر الأمن هو الله تعالى، ولذلك فهو يفيض الأمن على بعض الأماكن، يقول تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ ، وقوله عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ ، كما يجعل من يدخلها آمنا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ ، ويتعلق الأمر بالبلد الحرام.
هكذا، يتبين أن الأمن نعمة من الله عز وجل يتفضل بها على عباده شريطة تحقيق الإيمان وعمل الصالحات، وذلك ما نص عليه قوله تعالى ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ . وقد يسلب الله تعالى الأمن على من كفر بأنعم الله، قال الحق سبحانه: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ .
وإذا كان الأمن هو الطمأنينة والسكينة وطرد الخوف والفزع، فإن له صلة وثيقة بالقلب والروح، هذه الأخيرة لا تشعر بالأمن إلا في حضرة الحق تعالى، فالمؤمن من يشعر بالأمن، والعاصي من لا يأمن عذاب الله، وبذلك فأهل الله هم الآمنون المطمئنون، لأنهم ساروا على نهج الله تعالى ووفق صراطه المستقيم، وهي المعاني التي تؤطر مفهوم الأمن الروحي، فهناك أنواع أخرى من الأمن، كالأمن الغذائي والأمن الاجتماعي والأمن الوطني.. وغير ذلك من أشكال الأمن والتي يعتبر الأمن الروحي من أهمها وأكثرها تأثيرا في حياة الفرد والمجتمع.
مفهوم الرحلة
تعتبر الرحلة جزءا أصيلا من حركة الحياة على الأرض ، وتستمد أهميتها وضرورتها في الآن ذاته من طبيعة الحياة القائمة على المفارقة والاختلاف، ولذلك "فهي كثيراً ما تهتم بالعادات والتقاليد، وتعنى بتحديد الفروق بين الشعوب والمجتمعات" ، وقد عرف أدب الرحلة اهتماما من قبل بعض الباحثين ، كما أقيمت مراكز بحث متخصصة في دراسة الرحلات.
يبدو أن معنى الرحلة لا يثير أي مشكلة في اللغة، فمادة "رحل" تسبح في فلك الانتقال والظعن والمسير والضرب في الأرض والانتشار ، لكن يستعصي تحديد معنى "أدب الرحلة" في الاصطلاح، لأنها لا تتضمن فقط ما هو أدبي، ولكن تشتمل أيضا على ما هو تاريخي وجغرافي وعلمي.. وغير ذلك، مما يجعل التأليف في الرحلة يتطلب "ثقافة واسعة ودقة في الملاحظة" . كما أن البحث فيها لا يخلو من صعوبات، لأن أدب الرحلة "تجتمع فيه فنون عدة، وموضوعات جمة، مما يجعل ضبط معاييره وتعيين مقاييسه، أمرا صعبا" . فالرحلة تجتمع فيها صعوبة التأليف وصعوبة الدراسة في الآن نفسه.
يمكن اعتبار الرحلة تجربة "تعلن عن سرد الأسفار" ، وتتضمن معنى الذهاب بعيدا عن الأوطان، حيث يتم التعبير عن هذه التجربة من خلال الأدب، مما يؤدي إلى نوع من الاندماج بين زمن التجربة وزمن تدوينها، يُفضي إلى تشكيل نوع من التداخل والتكامل؛ بين ما يراه الكاتب بعينه، وما يرسمه الخيال للمتلقي، وهو يعكس تواصلا من نوع خاص، يحركه دافع نفع الغير وتخليد السفر، عبر نقل هذا الأخير من حيز الأشواق والرقائق، إلى صفحات الأوراق. أما أنواع الرحلات فيمكن التمييز بين نوعين؛ الرحلة الواقعية، والرحلة الخيالية ، دون أي تفضيل بينهما، "فالرحلات الخيالية لا تقل أهمية عن الرحلات الفعلية، لأن كلتيهما تنتهي إلى مقولة؛ إن المعرفة بالذات تتأصل عن طريق المعرفة بالآخر" . ولذلك، يمكن الجمع بين النوعين معا ليتضمن أدب الرحلات "كل ما يكتبه الرحالة، سواء من سار منهم في البقاع، أو من تجول مع الأفكار، وأخذ الخيال منه كل مأخذ" .
واضح أن بعض الرحلات كانت تسمى قديما بكتب المسالك والممالك، ويميز بينهما محمد الفاسي بقوله: "إن مؤلف الرحلة يذكر فيها ما يتعلق بنفسه، فينبه مثلا على تاريخ خروجه من وطنه (...) وأما مؤلف المسالك والممالك فإنه يكتفي بذكر المسافات، وبوصف البلاد التي يمر بها، ولا يتعرض لنفسه إلا في ما قل" ، حيث ترتبط كتب المسالك بعلم الجغرافيا عند العرب، أو ما سُمي بـ"الجغرافيا الوصفية" ، والتي تطورت إلى أن "تخلت منذ القرن التاسع الهجري عن الوصف الدقيق والتعبير المعقول المقبول، واهتمت بالتراجم ووصف المزارات والأضرحة والخانقاوات التي أحيطت بالكثير من الأساطير والمعجزات وكرامات الأولياء" ، وبذلك، استقل البحث الجغرافي عن "أدب الرحلة"، وبقي هذا الأخير فنا أدبيا، يستقطب كثيرا من العلماء والأدباء حتى صار "من أهم فنون الأدب العربي" .
إجمالا، تطورت الرحلة عبر ثلاث محطات: أولها الاهتمام بالمسافات وتقويم البلدان، وثانيها وصف المسالك والممالك، وثالثها الاهتمام بالتراجم والمناقب ووصف كرامات الأولياء. ولا يمنع ذلك من وجود رحلات تجمع بين تلك المحطات جميعا، أو تزيد عليها بسرد النصوص وتجميع المؤلفات كما هو الشأن في الرحلة العياشية المسماة "ماء الموائد" لأبي سالم العياشي (ت1090هـ).
ضرورة الرحلة
ارتبطت الرحلة بعلم الجغرافيا، حيث كان الرحالة يسجل ملحوظاته في كتب تسمى بالمسالك والممالك، ولكن بعد أن استقلت الجغرافيا كعلم قائم بذاته، أصبحت الرحلة فنا. وأساس الرحلة هو وصف الرحالة لما يعرض له في سفره وذكر الإحساسات التي يشعر بها أمام هذه المناظر.. ثم تطور هذا الفن وارتقى في مستويات الإبداع والتجديد. ولابد من التنبيه هنا إلى أن مفهوم الرحلة مفهوم متشعب متداخل الدلالات والمعاني: فقد يعني مجرد الانتقال من إقليم إلى آخر، وقد يعني لوناً أدبياً يقوم على علاقة زمنية مكانية تعتمد التقليد الأمين وعرض الخواطر بدقة.
كما أن الرحلة من الفنون الشائعة المتداولة في مختلف بلاد العالم. وقد ساعد على ازدهارها اختلاط الشعوب وحب الإطلاع والاستطلاع، والكشف والاستكشاف. فتضاعف الاهتمام بها واتسعت دائرتها لتشمل الأدب والتاريخ والفلسفة..، وبذلك تعتبر الرحلة ملتقى للمعارف والفنون؛ إذ تتصل بأمور كانت من صميم الجغرافيا كعلم السكان والتجارة والاقتصاد، دون أن تهمل ميدان السياسة والاجتماع والتربية والتعليم وغيرها، "فهي كثيراً ما تهتم بالعادات والتقاليد وتعنى بتحديد الفروق بين الشعوب والمجتمعات، مشيرة إلى الاختلاف في أنماط الحكم والعلاقات بين الحاكم والمحكوم" . والرحلة بهذا صلة وصل بين الثقافات المختلفة: "فهي وسيلة من وسائل التقدم والتطور وأداة تفاعل حضاري" ، كما تشهد بذلك العديد من الرحلات.
زيادة على ذلك، تبدو الرحلة ميداناً معرفياً غنياً بالدلالات والرموز ومجالاً خصباً يشي بقصة جهود الإنسان وجهاده ساعياً إلى اكتشاف مجاهيل الكوكب الأرضي مرتاداً آفاقاً جديدة، رغبة في إدراك بعض أسرار الكون وأملاً في الاطلاع على سلوك البشر وطرائق عيشهم. فالسفر إذن درس تجريبي ومدرسة تعلم الناس وترشدهم إلى استخلاص العبر. ولعل ذلك ما حمل الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون إلى القول: "إن السفر تعليم للصغير وخبرة للكبير" . وأكثر من ذلك، يذهب أحد الأدباء الفرنسيين إلى القول: "إن الرحلات تشكل أكثر المدارس تثقيفاً للإنسان" ، ولعل ذلك بعض ما حملنا على البحث في أدب الرحلة. ومن خلال دراستنا للرحلة العياشية المسماة "ماء الموائد" نستطيع القول إن قراءة الرحلات خير مدرسة للتكوين المستمر وإثراء الفكر، واكتساب مناهج الفهم والتفسير للأحداث والوقائع والظواهر، بل وتقويم النفس وتهذيبها. إن الرحلة "جزء أصيل من حركة الحياة على الأرض" .
أكد ابن خلدون (ت808هـ) على ضرورة الرحلة حين قال: "والرحلة لابد منها في طلب العلم، ولاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ" ، وقد تجازوت أهميتها قضية التعلم والاكتساب، إلى النظر إليها باعتبارها "معيارا للحكم على مستوى العلماء والفقهاء" ، فهي "تعادل أكبر الإجازات والشهادات التي يحصل عليها العالم أو طالب العلم" ، بل هي "بمثابة الأطروحات التي يكلل بها علماء وقتنا دراساتهم" ، ومن هنا اعتُبرت الرحلة "ضرورة وشرفا، حيث كان لقب الجوّالة صفة مشرفة" ، ولذلك "لا تكاد تخلو ترجمة أديب من الأدباء من تأليف رحلة أو عدة رحلات" ، و"من ليس له رحلة يُعد علمه قاصرا" ، مما يفسر كثرة الرحلات في التراث العربي. ولعل هذا التميز، راجع إلى حضور دافع الدين موجها في معظم رحلات العرب، حيث تصبح الرحلة عملا مقدسا، سواء رحلة نيل أعز ما يُطلب وهو العلم، أو رحلة أداء فريضة الحج، وفي الحالتين معاً يكون تحقيق الأمن الروحي هدفا مضمرا في جل الرحلات، يقول ابن عجيبة: "لا مسافة بينك وبينه، حتى تطويها رحلتك، ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك" ، وهو ما يُبين أهمية الرحلة ولزومها عند من اشتغل بعلوم الحقائق.
يقول صالح مغيربي: "ارتبطت الرحلة – باعتبارها ترحالا داخل دار الإسلام- بأداء فريضة الحج أو طلب العلم أو الثراء، وبدافع الفضول الشخصي أو الدرس "الجغرافي"، أما الرحلة إلى البلاد الأجنبية، فقد ارتبطت بالتجارة أو بالسياسة في صيغة سفارة أو تجسس أو شن حرب" ، وهي أهداف تضمر حاجة الإنسان لنوع من الأمن والاستقرار والتمكين في الأرض، خاصة عندما يكون الإنسان في وضع لا ينسجم مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم؛ من قوة وأمن، ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا﴾ ، فالخروج من منطقة الضعف والهزيمة إلى حيث أرض الله الواسعة محمود شرعا، بل واجب ومطلوب، ويُعاتب على تركه. ولذلك، كانت الرحلة خروجا من وضع مقلق، والتماسا لأفق مشرق، وبتعبير محمد لطفي اليوسفي تعتبر كتب الرحلات "خطاب مقاومة، وهي فعل جهادي" بامتياز، لأنها تؤسس للتغيير نحو الأفضل. فالرحلة تعبير عن "رغبة عميقة في التغيير الداخلي، تنشأ متوازية مع الحاجة إلى تجارب جديدة، أكثر من تعبيرها في الواقع عن تغيير مكان" ، علما أن "المقصود بالمكان، في معظم الرحلات، هو مكان المجتمع الآخر أو الثقافة الأخرى، والمجتمع والثقافة كائنات زمانية بالضرورة، وفهم الحاضر فيها يتطلب بالضرورة معرفة بالماضي، بل وتشوفاتها نحو المستقبل أحيانا" ، وبتعبير آخر، يمكن النظر إلى الرحلة، باعتبارها انتقالا "من حضيض الرغبات والأهواء، إلى مدارج علوية من الجهاد الروحي والفكري والحضاري" ، فما الذي يميز الرحلة عن المغاربة؟
خصوصيات الرحلة عن المغاربة
ما يميز الرحلة عند المغاربة ارتباطها بالركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام، وارتباطها أيضا بطلب العلم واستكمال الثقافة. وهما أمران حث عليهما ديننا الحنيف. فالحج - حسب الدكتور عبد الهادي التازي- كان أكبر وأعظم مؤسسة قدّمها الإسلام للمسلمين أينما كانوا وحيثما كانوا، بما تشتمل عليه من تنوع زادٍ، كان الحج أبرز رسالة موجهة إلينا لمعرفة الآخر، ولاكتشاف الآخرين لحوار الحضارات . ولا يفهم من هذا أن المغاربة اقتصروا في أسفارهم على التوجه نحو المشرق فقط، بل سافروا نحو كل الأقطار المختلفة شرقا وغربا، يقول الحسن الشاهدي: "ولعل الذي ساعد على تنمية هذا الاهتمام ورعى هذه الرغبة في الرحلة عند المغاربة هو الموقع الجغرافي للمغرب، ببعده عن الشرق والحضارة من جهة، وإطلاعه على القارة الأوربية من جهة ثانية، ولهذا انتظمت رحلات المغاربة الأقطار المختلفة شرقا وغربا، بلادا إسلامية وغير إسلامية، وإن كنا وجدنا أن الحجاز يستقطب أكثر المغاربة ويستهويهم ويجذبهم نحوه" ، نظرا للسبب الديني المباشر.
تميزت الرحلة عند أهل المغرب بظواهر أخرى، منها أن كثيرا من المغاربة كانوا "لا يكتفون برحلة واحدة إلى المشرق عامة وإلى الحجاز خاصة، ولكنهم بمجرد ما يصلون إلى بلدهم يسرعون إلى العودة من جديد؛ فهذا بن جابر الواداشي أطلق عليه بن خلدون صاحب الرحلتين، وهذا بن جبير قام برحلات ثلاث، وبن بطوطة قضى جزءا كبيرا من حياته في الرحلة والتنقل" ، وأبو سالم العياشي قام بثلاث رحلات، ثم قال في الثالثة قبل أن يصل إلى المغرب راجعا: "نسأل الله تعالى بجلال وجهه العظيم، ووجاهة نبيه الأكرم الكريم، أن يرزقنا العود إلى تلك الأماكن المطهرة" . وهناك ظاهرة أخرى تمثلت في طول المكث بالديار المقدسة وشدة التعلق بها إلى درجة الاستقرار فيها أحيانا، فمن الذين "عرفوا بهذا الصنيع أبو عبد الملك بن سمجون اللواتي الطنجي الذي أقام في الشرق سبع عشرة سنة" .
كما لا نعدم في تاريخ المغاربة صنفا آخر من الرحالة الذين كانت لهم أغراض غير التي ذكرنا من حج أو طلب علم، حيث سافروا إما للعمل، أو زيارة الأهل والصحب، أو لمجرد النزهة والمغامرة والاكتشاف.. وقد يجتمع أكثر من هدف في مشروع رحلة، ولكل واحدة منها خصوصية في الزمان والمكان وتطلعات صاحبها. وعموما فأنواع السفر عديدة؛ حيث يميّز الدكتور محمد الكحلاوي خمسة أنواع من الرحلات كانت على الدوام الدافع وراء كثير من الأسفار والخرجات وهي: الرحلة نحو حواضر العالم الإسلامي ومراكز الثقافة فيه، والرحلات الحجازيّة طلباً للحج والعمرة والزيارة، والرحلات العلميّة، والرحلات الزياريّة لزيارة أضرحة الأنبياء والأولياء، والرحلات السفاريّة لأداء مهام دبلوماسية كافتكاك الأسرى وحمل رسائل شفوية أو كتابية لملوك الأرض وسلاطينها.
ولا شك أن الرحلة إلى الحج قد كانت سببا مباشرا وراء كثير من الرحلات التي قام بها المغاربة، بل لقد تفوقوا على غيرهم في هذا المجال؛ فقد ذكر ابن خلدون وبعده المقري أسماء عدد كبير من رحّالي الغرب الإسلامي لأسباب متعددة. وشهرة المغاربة في هذا المجال يعترف بها المشارقة اليوم، حيث يقول أحد الباحثين: "ويظهر أن الرحالة الحجاج من المغرب العربي والأندلس يأتون في المقدمة مقارنة بإخوانهم من بقية البلاد الإسلامية في هذا الشأن. فقد رصد الشيخ حمد الجاسر حوالي سبعين اسماً وأثراً من القرن الثالث الهجري حتى القرن الرابع عشر الهجري وكلهم من الأندلس والمغرب قدموا إلى الحجاز لأجل الحج والزيارة وخلفوا تآليف" . مما يدل على أن"علاقة المغرب بالحجاز ظلت باستمرار علاقة وطيدة" .
كما يذكر محمد الفاسي في مقاله "الرحالة المغاربة وآثارهم" بعضا من أنفس الرحلات المغربية من قبيل: رحلة "الشهاب إلى لقاء الأحباب" لأفوغاي (سافر سنة 1007هـ) . ورحلة "عذراء الوسائل وهودج الرسائل" لابن أبي محلى (ت1023هـ). ورحلة "أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب وسيد الأعاجم والأعارب" لمحمد بن أحمد القيسي الشهير بالسراج والملقب بابن مليح (سافر سنة 1040هـ). والملاحظ أن التراث العربي يحفل برحلات متعددة . والواقع، أن عدد الرحلات المغربية، أكثر من ذلك بكثير، حيث إن عدد الرحلات التي ألفت فقط منذ القرن الحادي عشر بلغ نحو خمسين رحلة ، كما يرصد عبد العزيز بن عبد الله عددا كبيرا من الرحلات الحجازية في مقاله حول "الرحلات الحجازية المغربية: كشف أمجاد الجزيرة العربية" ، وعلى الرغم من أن معظم تلك الرحلات في حكم المفقود أو الضائع، إلا أن ما احتفظت به الخزانات العامة والخاصة منها، يدل على نهضة مغربية في التأليف في هذا الفن.
وفي سياق التعريف بتلك الرحلات يذكر الأستاذ خالد بن أحمد الصقلي ثمانية عشر رحلة حجازية لعلماء مغاربة أغلبها لم يحقق ولم ينشر بعد، ولا يغفل عن ذكر مكان وجودها، ويعد مؤلفوها من فحول العلماء في المغرب. وحول القيمة العلمية لهذه الرحلات يؤكد الدكتور عبد الهادي التازي أن الرحلات الحجازية موسوعة فقهية جديرة بالاطلاع والدراسة والتحليل، نظرا لما تتضمنه من ثروة فقهية نادرة المثال، ومن هنا وجدنا بعض الرحلات تزخر بالفتاوى حول ما يمكن أن يحصل في أثناء الحج، و قد زاد من قيمة الفتاوى أنها لا تنتمي إلى رأي معين وإنما تعتمد على عدة آراء، وكل رأي له مدركه ومستنده في القضية . وجدير بالذكر، أن هاجس لقاء الشيوخ وتحصيل العلم، والحديث عنه بشكل من الأشكال، يعتبر "القاسم المشترك بين جل نصوص الرحلات الحجازية التي عرفها هذا التراث الأدبي في المغرب" .
وقد أدرك بعض الباحثين المغاربة هذه القيمة فحوَّلوا اهتمامهم نحو دراسة الرحلات الحجازية وأدب الرحلات عموما. ولم يقتصر البحث على المستوى الفردي بل انتظم داخل مجموعات يوحدها الهدف المشترك؛ حيث أنشئت بالمغرب مؤسسات علمية تخصصت في أدب الرحلة كالمركز المغربي للتوثيق والبحث في أدب الرحلة، والجمعية المغربية للبحث في الرحلة، ومتحف ومرصد بن بطوطة بالمغرب، والمركز العربي للأدب الجغرافي. كما بدأ انتشار الوعي بأهمية الرحلات في الكشف عن معارف جديدة، من خلال التظاهرات العلمية التي تقوم بها هذه المؤسسات ، وحاليا تعد وزارة الثقافة المغربية مشروعا علميا يهدف إلى تحويل نصوص الرحلة إلى جمهور أوسع من خلال المختصرات والمقتطفات والمختارات للأطفال واليافعين، مع مراعاة إدراج الرحلة في الكتب المدرسية والجامعية. بالإضافة إلى التنبيه على أهمية دعم البحث في نصوص أخرى مضمنة داخل مصادر ومظان مختلفة من أجل ترميم النصوص الرحلية بناء على تكليفات .
إذا كانت الهوية المغربية تتأس على ثلاثة مبادئ أساس هي؛ العقيدة الأشعرية والفقه المالكي و تصوف الجنيد، فإن ذلك يعني أن التصوف ركن أساس من هذه الهوية الأصيلة، ومن ثم يصبح البحث عن نظرة الصوفية للرحلة ضروريا لبناء تصور شمولي حول رحلات المغاربة ثم إسهام هذه الرحلات في تحقيق الأمن الروحي لأهل المغرب.
نظرة الصوفية للرحلة
يميز أبو حامد الغزالي بين نوعين من السفر: "سفر بظاهر البدن عن المستقر والوطن، إلى الصحاري والفلوات. وسفر يسير القلب عن أسفل السافلين، إلى ملكوت السماوات. وأشرف السفرين السفر الباطن" ، فهو أحسن السفر كما نقل ذلك أبو سالم العياشي في رحلته "ماء الموائد":
مَا أحسَن الضَّحك الجَارِي بِغير فَم ورُؤْيَةٍ غَـابَ عَنْهَا هَيكل البَصَــــــــر
كُنْ قَاطِنـًا ظاهرًا والسِّر مُرْتَـحِــــــــــــــــــلٌ فَالسَّيْرُ مِنْ دُونِ رِجْلٍ أَحسن السَّفَر
فهو سفر وجداني إلى مدارج الحقيقة الروحية، يُسْفِرُ عن معدن الإنسان، ويسير به نحو نوع من الترقي في عالم الحقائق، يقول عبد الكريم الجيلي: "فهذا سفر أسفر عن محياه، وأظهر ما منحه مولاه، فإذا تحقق الإنسان بهذه الحقائق، واستحضر هذه الطرائق، سافر من معدنه إلى نباته، إلى حيوانيته، إلى إنسانيته، إلى نفسه، إلى عقله، إلى روحه، إلى سره، إلى حقيقة حقيقته وكليته المطلقة" ، حيث يشير إلى تفاصيل رحلة الإنسان في مسيرته السلوكية إلى الله، ومعراجه إلى معرفته والتفاني في حبه، فيخرج الإنسان من اضطراب النفس إلى أمن الروح، قبل أن يصل إلى عالم الحقائق، ويدرك حقيقة الحقائق، حيث لا حدود لفوائد هذا النوع من الأسفار، الذي تكون النفس مسالكه وممالكه، ويكون القلب مسافرا فيها، أو منتقلا من مقام إلى مقام.
هكذا، تعبِّر الرحلة عند المتصوفة عن نوع من "الانتقال عن المقامات، والإنزال في أخرى، كالانتقال من مقام الإسلام إلى الإيمان، ثم من مقام الإيمان إلى الإحسان" ، ويقتضي ذلك قطع كل العلائق، والخروج عن الشهوات والعوائد، حيث "لا يتحقق السفر ويظهر السير إلا بمحاربة النفوس، ومخالفتها في عوائدها، وقبيح مألوفاتها وشهواتها" ، وحسب همة السالك يكون نوع السفر الذي يطيقه قلبه، وتقدر عليه جوارحه، وقد لَخَّصَ ابن عجيبة أنواع سفر القلوب إلى حضرة علام الغيوب في الانتقال من أربعة مواطن إلى أربعة أخرى، حيث يسافر أولا: من موطن الذنوب والغفلة، إلى موطن التوبة واليقظة. ويسافر ثانيا: من موطن الحرص على الدنيا والانكباب عليها، إلى موطن الزهد فيها والغيبة عنها. ويسافر ثالثا: من موطن مساوئ النفوس وعيوب القلوب، إلى موطن التخلية منها والتحلية بأضدادها. ويسافر رابعا: من عالم الملك، إلى شهود عالم الملكوت، ثم إلى شهود الجبروت، أو من عالم الحس إلى عالم المعنى، أو من عالم الأشباح إلى شهود عالم الأرواح، أو من شهود الكون إلى شهود المكوّن . وبذلك ندرك المهمة الجسيمة التي على السالك إنجازها، وهي بلوغ حضرة الحق، وما تتطلبه هذه الغاية من جهد مستمر، قد يفوق ما تتحمله أجساد الرحالة أثناء السفر المحسوس. لكن المتصوف قد يجمع في أسفاره بين سفر القلوب ورحلة الأبدان، فيحقق نوعا من الكمال في رحلاته التي تختلف عن رحلات غيره من الناس، ويستمر في الانتقال حتى "يصير سفره وحضره على السَّوية" .
يتبين أن رحلات القوم لم تكن "للتنزه في البلدان، أو لكروب الأوطان، بل في رضى الرحمن، لأن مقاصدهم دائرة على الجد والتحقيق والمناقشة والتدقيق، لا ينقلون أقدامهم إلا حيث يرجون رضى الله (...) ولا يسافرون بقلوبهم إلا إلى حضرة القريب المجيب، بخلاف العامة: أنفسهم غالبة عليهم، وشهواتهم حاكمة عليهم، إن تحركوا للطاعة خوضتها عليهم، فأفسدت عليهم نياتهم، وأزعجتهم في هوى أنفسهم، تُظهر لهم الطاعة وتُخفي لهم الخديعة" . وذلك، لأن مدار السفر، على "مجاهدة النفوس ومحاربتها في ردها عن عوائدها ومألوفاتها" ، ومن عجز عن ذلك، لم يكن مسافرا بالقلب، وإن انتقل بالبدن. وهكذا، تنبه الصوفية للمعاني الخفية في الأسفار، فعملوا على تسخيرها في تحقيق الأمن الروحي للأفراد والمجتمعات من خلال محاربة أهواء النفس وبذل المجهود في نفع الغير ونشر الأمن والسلم.
يعتبر الحج رحلة السمو الروحي إلى الله، ولذلك وظف الصوفية هذه الرحلة في تعزيز الأمن الروحي وتقويته، نظرا لارتباط هذا النمط من الرحلات بالتحرر من كل القيود، عبر التجرد من المحيط والمخيط، والإقبال على الحق بالكلية، فيدخل الحاج إلى حرام مكة "وقد أصبح متجردا محرما، لا يشغله شيء عن ذكر الله" ، وهي شعائر يمتد تأثيرها، إلى ما بعد انتهاء المناسك، وعودة الحاج إلى دياره، حيث لا يحدث الاستقرار الروحي عند الحاج فحسب، وإنما يمتد أثره إلى المجتمع من حوله، ولذلك شكَّل الجنوح نحو البقاع المقدسة، "محور كرامات بعض الصلحاء العلماء، كسبيل لإصلاح أوضاع المجتمع، عبر الخروج من واقع مادي مثخن بالفساد في رحلة روحية إلى عالم الاستقرار النفسي والوجداني، الذي يساعد على تحقيق التوازن بين الروح والمادة" ، ومن ثم ترسيخ الأمن الروحي في المجتمع وإشاعته، فالمثول بين يدي المصطفى ﷺ، والتعرض لنفحات الرحمة الإلهية، وعطاء الله في مناسك الحج والعمرة، يعد أعظم نفع للمجتمع الجريح والمضطرب، كما قال العياشي: "وأي نفع ودفع أعظم من المثول بين يدي النبي ﷺ بكرة وعشيا" ، حيث خاض العياشي رحلة الحج عندما اشتدت المحن واشتعلت الفتن التي أكثرت في القوى هدما وفي الأقوات نهبا، فقرر السفر إلى خير البقاع، حيث خير الخلق محمد ﷺ، يتوسل به إلى الله أن يفرج كربة المغاربة ويعيد إليهم أمنهم، يقول العياشي:
سَأَنْفَعُكُم في غَيْبَتِي بِالدُّعَاءِ فيمَواقف حجي حيث أَصْفُو مِنَ الكَدَرْ
هكذا، تؤدي الأحاسيس الروحية التي يتذوقها الحاج أثناء أداء المناسك، إلى تأسيس الأمن الروحي في نفوس الحجاج، وكما كان الحق تبارك وتعالى كريما مع ضيوفه، فإن الحاج يبلغ ذروة الشعور بالأمن في حضرة الحق، ويسعى لزراعة الأمن حيثما انتقل بعد ذلك، بل قد يصبح الحاج مصدرا للتبرك، كما يحكي العياشي ما حدث له مع أحد تجار غزة: "وتلقانا أول ما دخلنا رجل من تجارها، فأدخلنا داره تبركا وأطعمنا" . وهكذا، يصبح الحاج مصدر بركة وأمن، بعدما تقلَّب بين الخوف والرجاء وذاق مرارة فقدان الأمن، في طريق الحج كما قال العياشي: "وقد عاينا من الطمأنينة في الطريق والعافية والسكون في مسيرنا هذا ما قضينا منه العجب، لأنا ما كنا نسلك هذه البلاد إلا في أيام الموسم، ونعاين ما يقع بها من النهب والسرقة والروعات المتوالية، فظننا أنها كذلك دائما" ، ثم يبلغ مقصوده في النهاية ويدخل المسجد الحرام آمنا، كما قال تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً﴾ ، لتحقق الرحلة هدفها في تثبيت الأمن الروحي وإشاعته وترسيخه. فما تجليات الأمن الروحي في الرحلة العياشية "ماء الموائد"؟ ما قيمة هذه الرحلة؟ ومن هو صاحبها؟ وما مدى حاجة المغاربة لأمن الروحي زمن العياشي؟ وكيف أسهمت رحلته في استرجاع الأمن الروحي؟
قيمة رحلة "ماء الموائد"
تعد الرحلة العياشية المسماة "ماء الموائد" لأبي سالم العياشي وثيقة لا تقدر بثمن في دراسة الحركة الفكرية والروحية بالمغرب وباقي أنحاء الوطن العربي، فهي من "أعظم رحلات أهل المغرب العلمية" ، حيث أقبلت عليها الأوساط العلمية في المغرب وخارجه، فتعددت نسخها الخطية داخل المغرب وخارجه ، إذ "لا تكاد تخلو خزانة عالم كبير منها" ، نظرا لاحتفائها بأجواء الحياة في مغرب القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين، بل في كثير من البقاع الإسلامية إبان تلك الفترة، خاصة وأن الموسوعية التي اتصفت بها هذه الرحلة "جعلتها مصدرا موثوقا لأخبار وأحداث العصر على طول الخط الذي اتبعته الرحلة، بوصفها للبلاد والأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية" ، وذلك بنظرة رحالة عالِم صوفي مدرك لرسالته في المجتمع.
ولعل ما يرفع من قيمة هذه الرحلة كونها تشتمل "زيادة على وصف البلدان التي مر بها الكاتب، على تراجم علماء مشهورين، وإشارات تاريخية، ومناظرات فقهية لا تخلو من طرافة" ، وتضم نصوصا نادرة ومتونا لكتب ورسائل علمية فريدة تتجاوز البعد المحلي إلى الانفتاح على قضايا تشغل المسلمين في أرجاء أخرى من المعمور ، حيث "يظهر أسلوب جديد في البحث يحاول أن يتجاوز النطاق المغربي المحدود إلى ذلك الفضاء الواسع الذي يمتد إلى الشرق الأدنى، حيث تختلف المناهج الدراسية نوعاً ما عنها في المغرب، وحيث تتسم طرائق التصنيف ومواضيع التأليف بميزات من طراز جديد ، وبذلك دشنت هذه الرحلة للاختلاف والتميز، ومما يعزز من قيمتها أيضا كون صاحبها "لم يكن مجرد عالم قال في فنون النظم والتأليف ما استطاع، بل كان شخصية استوعبت واقع عصرها" ، وتفاعلت مع قضايا مجتمعها وهموم أمتها، مما أسهم في ترسيخ الأمن الروحي للمغاربة وللعالم الإسلامي إبان القرن الحادي عشر الهجري.
من هو أبو سالم العياشي ؟
على الرغم من أن أبا سالم العياشي لم يدون ترجمة ذاتية، باستثناء ما ورد في بعض مؤلفاته عن أسرته وبعض أعلامها، إلا أن العديد من المصادر والمراجع قد تطرقت للحديث عن ترجمته أثناء دراسة بعض آثاره العلمية، بين مختصرة ومطولة وأخرى باللغة الأجنبية . فمن هو العياشي؟
هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن موسى بن محمد بن يوسف بن عبد الله العياشي ، نسبة لآل عياش أو آيت عياش. اشتهر بكنية أبي سالم ، من أبرز شيوخ الزاوية العياشية ، كان يلقب بعفيف الدين، المالكي، المغربي الإدريسي. ولد لليلة بقيت من شهر شعبان سنة (1037هـ: 4 ماي 1628م) بآيت عياش بالقرب من قرية تازروفت – على بعض أودية أحد روافد واد زيز- التي كان انتقل إليها أجداده من قصر ولتدغير من فجيج.
وصفه أحد الشيوخ بقوله: "نادرة الوقت غريب الزمان الفقيه المحدث الصوفي" . ووُصف كذلك، بـ"الشيخ الصالح العالم، العامل الناجح، المحدث المحقق، والعلامة المدقق، زبدة أهل الفضل والصلاح، ومعدن الحلم والسماح، فخر المتقين السالكين، وعين أرباب اليقين" . ومدحه الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمان الخياري (ت1083هـ) ، قائلا:
مُذْ لاَحَ بالمغرب المَاهُولِ فاضِلُـهوراح مُرْتَضِعًا ثَدْي العُلاَ نَاشِي
عاشَتْ مَعَالِمُ أَرْبَابِ النُّهَى وسمتولا عَجِيب إذا عاشَتْ بعـيَّاش
فَلْيَبْقَ للـعلمِ كي تَـبقى مَدَارِسهمَاهُولة يَقْتَفِيهَا القَاصِرُ النَّاشِي
تلقى أبو سالم العياشي تعليمه الأول على يد والده محمد بن أبي بكر (ت1067هـ) مؤسس زاوية آيت عياش التي تحولت فيما بعد إلى اسم زاوية حمزة بن أبي سالم عبد الله العياشي (ت1030هـ)، واشتهرت أيضا باسم الزاوية العياشية ، وهي المكان الذي نمت فيه مدارك أبي سالم، قبل أن يرحل في طلب العلم إلى بلاد درعة حيث الزاوية الناصرية، ثم إلى فاس حيث جامعة القرويين، "ولم تتح له الظروف التي عرفها المغرب أواسط القرن الحادي عشر الهجري أن يرحل إلى الدلاء ولا إلى مراكش، فاستغنى عن زيارة الأولى بالعلاقات الودية والمراسلات العلمية والأدبية التي كانت بينه وبين بعض علماء الزاوية الدلائية كأبي علي الحسن بن مسعود اليوسي... كما لم يزر الثانية مكتفيا بصحبة أشهر علمائها أبي بكر بن يوسف السكتاني" ، وذلك أثناء رجوعه من الحج في رحلته الأولى سنة 1059هـ.
احتل أبو سالم العياشي مكانة مرموقة بين أبناء عصره، نظرا لما تميز به من افتتان بالتنقل والأسفار، وولع بطلب العلم حيثما كان، إذ لم يكن طالب دنيا وإنما طالب ذوق وعلم، كما يقول:
ولستُ بطالب دُنْيا فما لـيولِلـدُّنيا التي تـردي وتضْنِي
ولكن طَـالبٌ ذَوْقًا ويُسْـرا وعِـلْمًا صَـالِحًا يُغني ويُقني
مما أسهم في بلورة تجربته، وفي تنوع مشاهداته وانطباعاته ، فالرجل أخذ عن الأعلام الذين أدركهم بالمغرب، حتى بلغ مرتبة التمكين التي أهلته لخوض الرحلة الكبرى، لأن السفر عند القوم لا يكون إلا بعد بلوغ التمكين، كما نقل ذلك أبو سالم في رحلته: "إن السفر لا يورث للمبتدئ إلا التفرقة، فينبغي للطالب إذا وجد الشيخ أن يكون ملازما لخدمته، ولا يفارق صحبته إلا بعد التمكين" .
هكذا، رحل الرجل ثلاث مرات إلى البلاد المشرقية ليتتبع العلم في مظانه وعند أربابه ويرمي بسهم مصيب مع أصحابه ، فلم يترك عالما إلا قصده وسمع منه، ولا متصوفا إلا زاره وتبرك بما عنده، فأفاد واستفاد، حتى اجتمع له من الأسانيد والروايات والإجازات ما لم يجتمع لغيره من معاصريه بدوا وحضرا ، و"اتسمت شخصيته باطلاعها الوافر على علوم الحقيقة والشريعة والأدب، فاهتمت في علوم الحقيقة بالطرق الصوفية والمرويات المسلسلة في إطار الأوراد والتبرك، واهتمت في علوم الشريعة بالعقائد والمعاملات في إطار المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، واهتمت في الأدب بشعر المديح النبوي وبجوانب التعبير عن الذات والمناسبات وبعض الآراء النقدية" . وبذلك، شكَّل أبو سالم العياشي "ظاهرة علمية فريدة في عصره" ، أهلته للتفرغ للتدريس والتأليف سواء في بعض البلاد المشرقية مثل المدينة المنورة، أو في مراكز العلم المشهورة بالمغرب مثل فاس، وكذلك بزاويته في مسقط رأسه بآيت عياش.
توفي أبو سالم العياشي بعدوى الطاعون يوم الجمعة 18 ذي القعدة سنة (1090 هـ: 1679م). وشكّل رحيله خسارة كبيرة للتصوف الإسلامي بالمغرب، ولعل ما تركه من آثار علمية نفيسة، تكون عزاء لفقدانه المفاجئ، فإلى جانب مؤلفاته الكثيرة ، ترك الرجل خزانة عامرة بالكتب، تضمنت نفائس المخطوطات وغرائب الآثار.
حاجة المغاربة للأمن الروحي زمن العياشي
شهد القرن الحادي عشر الهجري بالمغرب مجموعة من الصراعات السياسية التي هَزَّت استقرار البلاد وعصفت بأمن المغاربة، وخاصة بعد انهيار الدولة السعدية ووفاة المنصور الذهبي سنة 1012هـ حيث أدت النزاعات بين أبنائه "في طلب العرش والفوز بصولجان الملك" ، إلى انقسامات أضعفت الدولة ، وأصبح المغرب "كملوك الطوائف في الأندلس" ، فضلا عن الأطماع الخارجية حيث استولى الأجانب من اسبان وبرتغال وانكليز على مراسي المغرب وطمعهم في داخله ، واستطاع أتراك الجزائر الدخول إلى وجدة والاستيلاء عليها وضمها إلى ممتلكاتهم ، كما قام الثوار في كل ناحية ، ولم تستقر الأوضاع إلا مع المولى الرشيد بعد خوضه لحروب استمرت سبع سنوات وهي المدة التي قضاها في الحكم، فحقق بذلك للمغرب وحدته واستقراره باعتبارها مرحلة أساسية لانطلاق مسيرة البناء الحضاري مع ملوك الدولة العلوية الشريفة.
إذا كانت أزمات النزاع على السلطة، أمرا متوقعا في كثير من الدول، فإن المشهد يبدو صعبا، عندما تضاف إليه أزمات الغذاء والوباء والغلاء، وما يترتب عن ذلك كله، من غياب للأمن وانهيار للقيم؛ حيث اجتاح الوباء المغرب من سنة 1007هـ إلى 1016هـ، وساعد على انتشاره بفاس، فيضان عظيم خرّب المنازل والقناطر والأسواق ، وعمقت سنوات الجفاف والغلاء الأزمة، لتعيش البلاد وضعية حرجة عبَّرت عنها كتب التاريخ والسير التي أرخت لتلك الفترة العصيبة ، حيث "شاع احتراف السلب والنهب في الأموال والنفوس" ، وانتشار الأوبئة والمجاعات، حتى قال الشاعر:
يا من عن الغَرْبِ عام الجُوع قد غربا
إن حَــدَّثُوكَ أحـاديث إذا سمعــــت
اشدد بعــام يكاد الزَّرْعُ فيه يكــــون
ما أعظم الأمــر إِذْ كانت تَعُودُ بـــه
لا تنكرن على من جوعه غَلَبــــــا
يَظَّلُ سَـامِعها يقول واعَجَـبـــــــا
كالنّدَى فَيُبَاعُ وزنـــه ذَهَبـــــــــــا
التَّمْرُ تِبْرًا وعـاد حَشفه رُطَبَـــــا
ويصف صاحب رحلة "ماء الموائد" ما حل بالمغرب وصفا مؤثرا بقوله: "في سنة تسع وستين دبت في مغربنا عقارب الفتن، وهاجت بين الخاصة والعامة مضمرات الإحن، فانقطعت السبل أو كادت، وماجت الأرض بأهلها ومادت، (...) وأضرم الجوع في سائر الأرجاء ناره، فتولد منه من الفتك والحرابة ما أعلى تفريق الكلمة مناره، وتطاير في كل أفق شَراره، وأهان خيار كل قطر شُراره، واتخذت البدعة شعارا، والزندقة دثارا، وفر الساكن من بلده، والوالد من ولده" . وهو وصف دقيق لمظاهر غياب الأمن بكل أنواعه، حتى شاع سفك الدماء وأكل الحرام بسبب الجوع وفساد الذمم فعوقب الناس بحبس المطر ،كما قال الشاعر في درعة:
يَطُوفُ السَّحَابُ بدرعة كما
يطوفُ الحجيج بالبيتِ الحَرَام
تُريـدُ النُّزُولَ فلمْ تَسْتَطِــــــــعْ
لسفكِ الدِّمَاءِ وَأَكْلِ الحَــــــرَام
بلغ الجوع الحسي بالمغاربة درجات قصوى "أكل الناس فيها الجيف والدواب والآدمي وخلت الدور وعطلت المساجد" ، حيث تأثر الجانب الروحي كذلك بتعطيل المساجد، وكثرة الظلم للأنفس والعباد، وقد وصف الحسن اليوسي ظلم الجباة وصفا دقيقا مؤثرا حين قال: "قد جردوا ذيول الظلم على الرعية، فأكلوا اللحم وشربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ، ولم يتركوا للناس دينا ولا دنيا" . وهكذا كانت الفتن في المغرب "كنزول المطر من السماء؛ حروب طاحنة متوالية بين السعديين والعلويين وبين المسلمين والإسبانيين والإنجليزيين، وثوار متلصصون هدفهم الإفساد في الأرض ونهب الأموال والنفوس. ويضاف إلى ذلك ما كانوا يصابون به من نكبات الحياة كضيق في المعيشة، وارتفاع في الأسعار، وجدب وقحط وزلازل وهزات" ، حيث عرفت مدينة فاس زلزالين عنيفين؛ الأول في رجب سنة 1030هـ والثاني في رمضان سنة 1075هـ فاغتم الناس وعمّهم الخوف والفزع، واعتقدوا في الحالتين أنها الساعة لا محالة ، حتى قال أبو سالم العياشي "وهذا أعظم دليل على قرب انقراض الدنيا واستبدال عمرانها بالخراب وأنهارها بالسراب" . مما جعل الرعب يسيطر على الناس فيغيب الأمن الروحي، وتصبح الرحلة إلى خير بقاع الأرض وحيث خير البرية ضرورة لإعادة التوازن واستعادة الأمن الروحي الذي يعد أساسا لكل أمن آخر ومنبعا لكل عمل صالح.
تجليات الأمن الروحي في رحلة "ماء الموائد"
لعب الصوفية دورا مهما في إحياء الأمل في نفوس المغاربة عبر زرع بذور الأمن الروحي، من خلال إنشاء الزوايا التي تعددت أدوارها الروحية والاجتماعية والعلمية والجهادية أيضا ، كما قاومت البدع ، وحاربت مظاهر الفساد الديني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وعززت الأمن الروحي للمغاربة بإحياء السنة ورد الأمة لدينها، بتعظيم بيوت الله وعمارتها بالصلوات والأذكار وتلاوة القرآن، كما قال أبو سالم العياشي: "إذا أراء الله خلاء بلد بدأ ببيته، ثم يتبعه ما سواه، وإذا أراد عمارته فكذلك" .
أمام انهيار الأمن الروحي للمغرب، وانكباب الناس على الدنيا، كما قال أبو سالم العياشي: "وأما الآن فالاهتمام كله بالدنيا، ولم يبق من الاهتمام بالدين إلا ما نسبته إلى الدنيا نِسْبَةُ الفلك الأعظم إلى الجزء الذي لا يتجزأ" ، قرر العياشي الرحلة إلى البقاع المقدسة قصد المثول بين يدي النبي ﷺ بكرة وعشيا يستشفع به إلى الله في دفع الأسواء وإزالة الأدواء وإعادة الأمن لأهل بلده، وقد كانت الأهوال عظيمة إذ يقول: "وأي نفع ودفع أعظم من المثول بين يدي النبي ﷺ بكرة وعشيا، في أوقات الشدائد التي كانت عليهم، والأهوال التي صارت لديهم، أستشفع به إلى الله في دفع الأسواء، وإزالة الأدواء" ، فعندما تشتد المحن يفر الإنسان لخالقه ويقطع العلائق ليتصل برب الخلائق، فيستشفع إلى الله بأكمل الخلق محمد ﷺ. فما هي تجليات الأمن الروحي في رحلة "ماء الموائد"؟
1-التضحية والإيثار:
لم يكن خوض الرحلة أمرا سهلاً بالنسبة لأبي سالم العياشي، وخاصة في رحلته الحجازية الأولى سنة 1059هـ حيث كان عمره 23 سنة، و"الشباب إذ ذاك ناعمة أغصانه، والهوى شديد على القلب عصيانه، وفنن الصبا ناعمة أوراقه، والوطن حبيب يشق فراقه" ، ومع ذلك، استسهل العياشي "قطع تلك العلائق كلها" ، وركب متون المجاهل مع ركب يؤمون البيت العتيق، وقد كان يظن أن مشاهدة تلك الأماكن المقدسة تشفي من أليم الشوق عليلا، أو تبرد من أليم البعد غليلا. لكن، بمجرد أوبته إلى وطنه وانتهاء أمد الغيبة، حنّت نفسه للرجوع إلى الحج مرة أخرى، فيصف شوقه لمرافقة ركب الحج قائلا: "فلا يأتي أوان ارتحال الركب إلا أطاعت الجفون داعي السكب، وحنت حنين الثكلى الواله إلى معاهد الرسول وآله، ودب بين الجلد والعظام دبيب الشوق إلى تلك المشاعر العظام" . وهو وصف يبين بجلاء، مدى الشوق الذي زاد بزيارة البقاع المشرفة، فعوض أن يزول الحنين أو تخف حدته، نجده يزداد ويعلو فيسيطر على وجدان أبي سالم وكيانه، فلا تقر له عينا حتى يحقق بغيته في الرحلة مرة ثانية سنة 1064هـ، "ولم يخمد مع ذلك متأجج نار الغرام" ، فيعقد العزم على الحج مرة ثالثة سنة 1069هـ لولا أن ظروف المغرب الصعبة في تلك السنة حالت دون رحلته، فانتظر تغير الحال من اضطراب إلى استقرار، لكن "لم يزل أمر الفتن يتفاقم ويربو، والهمة عن قصدها المحمود لا تنبو" ، حتى حلت سنة 1072هـ التي عرف فيها المغرب أوج أزمته، فيصف العياشي مظاهر تلك الأزمة وصفا مؤثرا تقشعر منه الأبدان، إذ يقول: "وأضرم الجوع في سائر الأرجاء ناره، فتولد منه من الفتك والحرابة ما أعلى تفريق الكلمة مناره، وتطاير في كل أفق شَراره، وأهان خيار كل قطر شُراره، واتخذت البدعة شعارا، والزندقة دثارا، وفر الساكن من بلده، والوالد من ولده" . حيث أيس العياشي من السفر إلى الحج، بعد العزم القوي، يقول: "وطويت شقة ذلك العزم أي طي، فلحقني من التخلف كرب شديد، (...) فاستروحت من ذلك العناء والألم إلى مدح النبي ﷺ، فأنشأت منها عدة قصائد في أيام مولده الشريف (...) أظهرت فيها التودد والتعطف، وأكثرت التشكي والتبكي والتلهف على ما فات من القصد الجميل في هذه السنة (...) وأطنبت في الاستغاثة إلى الله بنبيه الكريم أن ييسر لي في زيارته من فضله العظيم" ، حيث شرع في نظم القصائد المدحية التي نفث فيها شوقه لزيارة البقاع الشريفة والمثول بين يدي قبر النبي ﷺ، ومن جملة ما جاء في تلك القصائد، قوله:
فيا ليتَ شِعري هل أرى طيبة وهل
أحـــــث ركابـي في زِيَارَتِهـَا حَـثّــا
وهلْ أقفن مـا بيـن قبـر ومنبـــــــر
أصلي وكَمْ سِــــــرّ هُنَالِكَ قـد بثـا
أُناجـي رَسـُولَ الله بِالسِّـــرٍّ تــــارةً
وَأَشْكُو إليه بعـدها الحزن والبثا
ومع أن أثر العزم قد امحى وزال طمع العياشي في السفر، إلا أنه في حال بين المنزلتين؛ فلا هو بقادر على الارتحال، ولا هو بفارغ البال، لما يحسه من أشواق، وفي ذلك يقول:
أَرُومُ ارتحالا نحوه فَتَصدني ذُنوب
بها قـد صِرْتُ في الغِـلِّ والقَـيْـــدِ
فصرت مُعَنىً لا الوصال يُتَاحُ لي
ولا المكث يهنى لي لِمَا بِي مِنْ وجدي
وظل على تلك الحال القلقة والمحزنة، حتى جاءته رياح الرحمة من حيث لا يحتسبها، يقول: "وما كنت أطمع أن ذلك يكون عن قريب، بل هو عندي أغرب من غريب" . فأن يكون حلم تحقيق الرحلة أغرب من غريب، يجعل الرحالة مستغربا من توالي الأحداث الميسرة للرحلة، حيث انقلبت الموانع إلى بواعث محفزة للسفر، فهل زالت المحن وخمدت الفتن؟
لم تنقض الأزمة التي عرفتها بلاد المغرب سنة 1072هـ التي وُصفت بـ"السنة الشهباء التي أكثرت في القوى هدما وفي الأقوات نهبا" ، وإنما خرج العياشي اضطرارا لينفع أهله فكان رده على من اتهمه بالفرار:
وقالوا فَرَرْتَ وليس الفِــــــرار
لمِثْلِكَ في القَومِ مِن فِعْلِه
فقُلتُ فَرَرْتُ إلى المُصْطَفَى
ومِثْلِي يَفِـرُّ إِلَـى مِثْلِــــه
فهو لم يحج فرارا وإنما شوقا لرحاب المصطفى ﷺ، والتماسا لاستجابة الدعاء في مواقف الحج، حيث يقول:
أحِبَّةَ قلبـي لا ضِرَارَ ولا ضَــــــرَر
ولكنـنـا نـرضى بما سَاقَهُ القَـــــدرْ
سـأنفعُكُمْ في غَيْبَتِي بالدعـاء في
مواقف حجي حيث أَصْفُو مِنَ الكَدرْ
ولست بنـاسٍ عهـدكم وودادكـــــم
وإنْ طَـالت الأيام واتصـل السفـــرْ
يذكرنيكـم كــل حسن رأيتــــــه
ولاسـيمـا بـرد العشيَّة والسَّحـــــــرْ
فعندما تشتد المحن يفر الإنسان لخالقه ويقطع العلائق ليتصل برب الخلائق، فيستشفع إلى الله بأكمل الخلق محمد ﷺ، وبذلك يظهر ملمح التضحية والإيثار في أسمى تجلياته، حيث يحرص الإنسان على نفع الغير، فيؤثر التعب والنصب في سبيل بلوغ الأماكن المقدسة ليكون نبراس خير يضيء للناس عتمات الزمن القاسي.
2-الانتماء لجميع الطرق الصوفية:
من أهم ما يوضح بجلاء إسهام رحلة "ماء الموائد" في تعزيز الأمن الروحي للمغاربة، سعي الرحالة العياشي إلى الانتماء لكل الطرق الصوفية التي سادت في زمانه، وتوثيق الروابط مع شيوخها، عن طريق "الانتماء السندي"، حيث سعى إلى الانتساب إلى جميع شيوخ السند وطرقهم مهما اختلفت مشاربهم ، ولعل ذلك ما جعله يستوعب كل الطرق الصوفية الأربعين التي عرفت في زمانه ، بل كان أول من أدخل الطريقة النقشبندية للمغرب، ليدعم الجانب الروحي والإيماني للمغاربة، حيث وضَّح قواعد هذه الطريقة وأصولها في رحلته، وذكر فيها من كلام السادات النقشبندية، ما رأى فيه كفاية في التشويق إلى سلوك طريقهم لمن وجد مرشدا أو صحبة ، ومؤكدا أن هذه الطريقة لا تختلف في جوهرها عن الشاذلية، حيث يقول: "ومن تأمل رشحات النقشبندية وحكم الشاذلية لم يجد بينهما اختلافا إلا بعض الاصطلاحات الراجعة إلى الأعمال الظاهرة، وأما الأعمال القلبية والمنازلات العرفانية فلا فرق أصلا" . وذلك ما أسهم في تقوية الوازع الإيماني عند المغاربة وتعزيز الأمن الروحي.
يبدو أن اهتمام العياشي بالانتماء إلى كل الطرق الصوفية في المغرب والمشرق، قد حمل في طياته رسالة ضمنية مفادها عدم تفضيل طريقة صوفية على أخرى أو تمييز شيخ معين، حيث التركيز على الأصل المتمثل في الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا يهم بعد ذلك اختلاف الاصطلاحات، فكل الطرق إلى الله ينبغي أن تسهم في خدمة السلوك الإيماني وتثبيت الأمن الروحي. ومما يعزز هذا التوجه في الفهم، كون الزاوية العياشية لم تكن تتبنى طريقة صوفية محددة مثل باقي الزوايا المعاصرة لها، وإنما كانت زاوية علم وخزانة كتب وحلقات درس ومذاكرة، فكانت علاقة الطلاب بالشيوخ علاقة علمية صرفة يجمعهم طلب العلم وحب الدين والوطن، ونستدل بهذه الميزة على "مرونة المدرسة المغربية وانفتاح أبنائها على مختلف الثقافات" حمايةً للأمن الروحي وتعزيزا له؛ حيث إمكانية الأخذ من الآخر وإفادته ونفعه، في سياق التبادل الإنساني "الروحي" بكل تجلياته وأبعاده، فلا توجد عصبية أو قبلية ولا تقوقع في طريقة معينة، لأن الغاية الكبرى هي توحيد الله عز وجل وتحقيق الأمن والطمأنينة بذكر الله، كما قال تعالى: ﴿أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ .
ومما يدل على إسهام الرحالة العياشي في ترسيخ الأمن الروحي للمغاربة كذلك، أنه لم يؤسس لنفسه طريقة خاصة به وبمريديه، على الرغم من قدرته على ذلك، وكأنه يريد أن يؤكد أن الحفاظ على الوحدة الروحية للمغاربة مقدم على كل عمل؛ حيث ضرورة الاعتصام بالكتاب والسنة ولا ضرر بعد ذلك من الاستفادة من كل الطرق الصوفية مادامت تستمد حياتها من أصل واحد، هو الوحي الإلهي المتمثل في القرآن والسنة، وبذلك شكّلت وحدة الأمن الروحي أولوية الأوليات في منهج الرحالة المتصوف العياشي كما ظهر ذلك جليا في رحلته "ماء الموائد".
3-علاج الأمراض الظاهرة والباطنة:
من الواضح أن الأمن الروحي يعيد للإنسان توازنه ويشفي من بعض الأسقام، وقد استشعر أبو سالم ذلك في رحلته إلى الحج، فعلى الرغم من أن السفر في العادة قطعة من العذاب، إلا أنه في حال الرحلة إلى الحج دواء من كل الأسقام، وكيف لا يشفى من الأدواء من كانت وجهته مكة وطيبة ومرغ أقدامه في رمال المحبة المحمدية؟
من الغريب أن يقع الشفاء في الطريق إلى الحج مع توالي المراحل والتقدم في المسير، فكيف إذا بلغ الرحالة مقصوده ونال القرب من البقاع الشريفة؟ يقول أبو سالم العياشي: "وقد شفاني الله في هذه الطريق المباركة من جميع ما كان فِيَّ قبل ذلك من الأمراض الظاهرة والباطنة، وأعني بالباطنة الحسية، ولا نيأس من فضل الله في المعنوية. وقد أنعم الله علينا بنعم سوى ذلك لا تحصى وأيادي لا تستقصى" . ويقول أيضا: "ومما أنعم الله به علي أن أعطاني من القدرة على المشي ما لم أكن أعهد من نفسي بعضه (...) فصرت اليوم أسير مرحلة كاملة، وإما نصفها أو أزيد أو أقل فكثير" . بل بلغ العياشي من القوة الجسدية والنفسية درجة قرر فيها أداء مناسك حجته الأخيرة مشيا على الأقدام، كما يحج الفقراء والضعفاء دون متاع ولا ركوب، في حجة وصفها بـ"حجة صعلوكية" . وهو ما نستدل به على أن رحلة المتصوف العياشي إلى الحج مثلت علاجا لأمراضه الظاهرة والباطنة، وأسهمت في شفائه واستعادة قوة البدن، وهي مظاهر لقوة الروح ونشاطها، ومن ثم أمنها وسلامها، وهو الأمن الذي سينعكس على من حوله من الناس أثناء رحلته وبعد أوبته ورجوعه.
4-مبدأ التسليم والتبرك
تحضر البركة في رحلة "ماء الموائد" باعتبارها رافدا من روافد الأمن الروحي، وتؤدي دورا بارزا في إعادة التوازن، وتتجلى في مبدأ التسليم وتصديق الكرامة، فالكرامات "أداة من أدوات صناعة البركة (...) أي وسيلة من وسائل التحول من الدونية إلى القدسية" التي تفترض ضرورة الاحترام وتؤدي إلى حصول الأمن الروحي والاستقرار النفسي، لأن القرب من أولياء الله قرب من الله وسبيل للتقرب إليه، ومحبتهم من محبته.
لأبي سالم العياشي نظرة خاصة للصوفية؛ فهو يكّن للأولياء احتراما كبيرا، فيعظم شأنهم ويلح على ضرورة زيارتهم، حيث يقول: "إذا كانت بركة النسبة للأنبياء عليهم السلام وللأولياء رضوان الله عنهم يظهر أثرها في العجموات فما بالك بالآدمي الذي هو أشرف المخلوقات! فلا تقصروا إخواني من خدمة الصالحين وزيارتهم وملاقاتهم، فإن لذلك أثرا عجيبا في تليين القلوب، وتسخير النفوس" . وبلغ تقديره للقوم إلى درجة تفضيل أقوالهم وقبول ما يقررون من آراء حول بعض القضايا والأحكام، حيث قال: إن "المسألة إذا كانت ذات قولين، وكان الصوفية مع إحدى الطائفتين ترجح قولهم لا محالة، لما رزقوا من صدق الإلهام ونفوذ البصيرة مع تأييد الله لهم عند اشتباه الأمور، فيميلون مع الحق أينما مال لرفضهم دواعي الهوى . ولعل ذلك ما يفسر تصديقه لكل ما قد يصدر عن الأولياء من أمور خارقة للعادة، فهو يقبلها وإن تعذر عليه فهم مقصودهم منها، وفي هذا المعنى يقول: "فإن صح عن هؤلاء الأئمة أنهم قالوا ذلك، فنحن ممن يعتقدهم ويجزم بصدقهم فيما يقولون لأنهم خيار الأمة، إلا أنا نكل العلم إلى الله تعالى في فهم ما ورد عنهم في ذلك" .
هكذا يؤسس أبو سالم العياشي لمبدإ التسليم للأولياء ، ويؤكده التزامه بهذا المبدأ قائلا: "ما أذكر أني سمعت كلاما من كلامهم فنفر منه قلبي أو كرهه، وإن كان في غاية الإشكال، بل ينشرح قلبي لسماعه وقَبوله ولو لم أفهمه، وغالبه لا أكرر النظر فيه مرارا بحسن النية إلا ويَمُنُّ الله بفهمه على وجهه أو ظهور محل لائق أحمله عليه. وما لم أجد له محلا أجد في قلبي بَرْدَ التسليم له والتفويض في معناه لله ولرسوله ولأولي العلم من خلقه؛ إذ هم خلفاء الله ورسوله في فهم كلامه وكلام أوليائه" . لأن كلام العارفين بالله "ميراث كلام الله ورسوله الذي هو منبع اللطائف والأسرار" . ولذلك حرص العياشي على تصديق القوم وإن تعذر عليه فهم ما يقولون، ويعتبر التأكيد على هذا المبدإ، تأكيدا على حسن الظن بهم، ومن ثم فهو يؤدي إلى إشاعة أمن روحي واستقرار نفسي، يؤسس لمجتمع متوازن يقوم على الثقة المتبادلة بين أفراده والاحترام بين مكوناته. يقول أبو سالم العياشي: "فأنا والحمد لله ممن يعتقد تنزيه ساحة الأئمة الصوفية عن الكذب والافتراء، ويثق بأقوالهم ويصدق بكراماتهم، ويحمل ما أشكل على أحسن محامله، ولا أطعن فيه بوجه، وأُسَلِّم لهم فيما لم يتبين لي وجهه" .
يؤدي العمل بمبدإ التسليم في التبرك، إلى ترسيخ الأمن الروحي في المجتمع، من خلال إشاعة الاحترام والاعتراف بالفضل، ويتجلى ذلك في ما ذهب إليه العياشي في رحلته "ماء الموائد" عندما تحدث عن تراتبية في التقليد، تقوم على التمييز بين العوام والعلماء والمتصوفة، حيث يقلد العوام العلماء، ويقلد العلماء الصوفية، يقول العياشي: "كما كان ينبغي للعوام تقليد العلماء فيما قالوه، وإن لم تدركه عقولهم، وُثُوقا منهم بحسن نظرهم وسداد رأيهم، كذلك ينبغي للعالم تقليد العارف الذي فوقه فيما لم يبلغه عقله (...) فأقل درجاته التسليمُ له فيما أتى به، إذ منازعته فيما لم يحط به علما ولم يدركه عقله خدلانٌ وحرمانٌ" .
من الواضح أن أبا سالم العياشي وإن كان يلح على ضرورة التسليم للأولياء، إلا أننا لا يمكن أن نأخذ تصديقه للشيوخ والأولياء بالمطلق، فقد فَصَلَ في تسليمه للشيوخ والأولياء بين التصديق والعمل، حيث يقول: "إني وإن صدقت القوم فيما يقولون واعتقدت صحة مقالتهم فإني لا أنتقل عما أنا عليه من معتقد العوام المقطوع بصدقه إلا ببرهان من الله واضح وحجة منه قاهرة" ، حيث يميز بين تسليمه للقوم واتباعه لهم بالإطلاق، فلا يدل تسلميه على الاتباع بالضرورة، لأنه لا يتبع إلا ما ثبت أصله ونهل من حجة الشريعة الواضحة ، وإن ظهر ميله لاقتداء بعض الأفعال، فإنما ذلك لغياب نهي شرعي، ولدخول الفعل في باب المباحات والفضائل، مثل التبرك ببعض الآثار والتعبير عن حب النبي ﷺ.
أسهم سلوك الرحالة المتصوف العياشي في الحفاظ على الأمن الروحي داخل الفضاءات التي كان يمر منها، فمن ذلك أنه وصف انتعاش التجارة في منى أيام التشريق، وذكر أن "أكثر التجار يقولون: إن من اشترى شيئا من منى وجعله في تجارته وجد بركته وظهرت له ثمرته" ، فعلَّق على ذلك بقوله: "ولا يبعد ذلك، فإنه موسم شريف، ومحل بركة" ، حيث أقر الناس على اعتقادهم ما دام لا يناقض الشريعة، وبذلك حافظ على استقرار الأوضاع، ولم يكن تدخله إلا لتعزيز السلوك الإيجابي الذي يوحد الكلمة ولا يفرقها ويجمع شمل المسلمين ولا يشوش عليهم، وهي إشارات من عالم صوفي كبير أراد بها زرع بذور الأمن الروحي في المجتمعات، وترسيخها منهجا في التعامل مع بعض الأمور التي لا تناقض الشريعة وإن كانت اعتقادات غريبة.
يظهر أن "البركة" جزء من الشيخ أبي سالم العياشي، تحضر في بنية تفكيره ونمط حياته، بشكل واضح، فقد توسع في وصف المساجد التي تزار في المدينة المنورة للتبرك بها ، وكذلك الآبار التي ورد أن النبي ﷺ تفل فيها أو شرب من مائها أو توضأ فيها فاكتسبت بذلك فضلا على غيرها، فصارت مقصودة بالزيارة والاستشفاء بمائها ، وكذلك الشأن في ذكر بعض أودية المدينة ، فضلا عن تتبعه في الأماكن التي يمر منها لكل أثر يُتبرك به، فيتصرف كما تتصرف العامة من أخذ لتراب بعض الأماكن واستصحابه معه لبلاد المغرب بقصد التداوي مثلما فعل مع تربة صعيب بالمدينة المنورة . وهو بذلك يؤسس للأمن الروحي الذي يربط الإنسان بأصوله ودينه، فلا يخاف استلابا ولا اغترابا.
يستفحل التبرك حتى يتضخم، فيتجاوز الواقع اليومي للرحالة، إلى ما يكتبه، ففي الرحلة ينقل نصوصا عديدة بنية التبرك بها، حيث يجعلها ضمن متن الرحلة رجاء "البركة"، كما يظهر ذلك جليا في توظيفه لعبارات شتى من قبيل: "سأكتبها تيمنا وتبركا" ، وهذا "نص الكتاب تيمنا بألفاظه وتبركا بنَفَسِه الرباني، لما اشتمل عليه من الإشارات العرفانية والحقائق العيانية" . وغير ذلك، من النماذج الكثيرة في الرحلة، حيث يصبح التبرك وجلب البركة مصدرا من مصادر الأمن الروحي.
إذا كان التبرك مصدرا لنوع من الأمن الروحي والاستقرار النفسي، فإن مصادر البركة متعددة في رحلة "ماء الموائد"؛ فمنها ما هو متداول ومشهور، كالانتماء إلى النبي ﷺ، ومنها ماهو خفي ومستور، مثل علوم الحقيقة والشريعة، حيث يصبح الكلام في العلوم والآداب نوعا من التبرك، ولذلك تحتشد نصوص متعددة في الرحلة ومناقشات مستفيضة في أمور ذوقية وعلمية، فقراءة رحلة "ماء الموائد" سفر في رياض الفكر وتنقل في معارج الروح لترتقي بقطف درر من كل علم وفن، فهي موائد علم ماؤها حسن الظن بالصوفية وثمرتها الأمن الروحي، ولذلك لم يجد العياشي حرجا في إدراج نصوص طويلة ضمن رحلته، مبررا اختياره برغبة التبرك، حيث يقول: "انتهى ما انتقيته من الأجزاء المتقدمة تبركا بلفظها، فاغتفرت طولَها لفائدتها" . وقوله أيضا: "وقد نقلتها مع طولها تبركا بها" .
خـاتـمـة
إن الإنسان اليوم وهو يقرأ رحلات الصوفية لا يفارقه الشعور بأن لدى القوم رغبة قوية في مجتمع آمن ومطمئن ومزدهر بكل أنواع الخير والإحسان، وهي البيئة "المثالية" للعبادة الحقة، حيث يتجلى أمن الروح واطمئنان القلب وهدوء النفس وصفاء السريرة، ويظهر في كل مظاهر الحياة والسلوك والوجدان، فيفيض الإنسان المؤمن الآمن بالخير والأمن على كل من حوله، ومن ثم الإسهام في نشر رسالة الإسلام التي هي رسالة أمن وسلام في جوهرها.
من الواضح أنه حيث يوجد الأمن توجد أشياء أخرى معه، وترافقه خيرات وبركات، كما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ ، وقوله عز وجل: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ . فمع وجود الأمن الروحي في قلوب الأفراد وفي المجتمع، يأتي الازدهار والرقي وتتقدم المجتمعات والشعوب، حيث تقع حركة نشيطة في التجارة والمبادلات والاستثمار والصناعة والفلاحة وفي كل مجالات النمو والإنتاج والخدمات، نظرا لإشاعة السلم والتعايش وشعور الناس بالاطمئنان يجعلهم يمارسون حياتهم آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ومستقبلهم، فيقع السلم الاجتماعي العام، وينعم المجتمع الإسلامي بالاستقرار.
إجمالا، يمكن القول إن رحلة "ماء الموائد" قد أسهمت في تحقيق الأمن الروحي للمغاربة، سواء في زمن الرحلة أو زمن تدوينها، أو خلال أزمنة القراءة فيما بعد، نظرا لنجاح العياشي في التأليف بين موضوعات تفضي إلى زرع بذور الأمن الروحي وترسيخه، وخاصة في عصر تأليفها حيث كان الأمن مفقودا في مغرب القرن الحادي عشر الهجري بسبب عقارب الفتن التي "طاش لها الوقور (...) ووضع النفيس وارتفع الخسيس، وفشا العار وخان الجار ولبس الزمان البؤس وجاء بالوجه العبوس (...) وطأطأ الحق نفسه وأخفى المحق نفسه (...) ووردت المهالك وسدت المسالك وعم الجوع" . فكانت رحلة المتصوف إلى الحج بابا لإعادة التوازن بإحياء الأمن الروحي وحمايته، من خلال مظاهر التضحية والإيثار، وسلوك التصوف القائم على وحدة الطرق الصوفية، والشعور بقوة البدن والروح أثناء خوض الرحلة، ومبدأ التسليم والتبرك باعتباره منهجا يحافظ على الاستقرار ويزرع بذور الثقة والأمن والتعايش والوئام.
مما يعزز من قيمة ما قدمته هذه الرحلة المغربية المشهورة في خدمة الأمن الروحي للمغاربة وترسيخه، كون صاحبها من أبرز شيوخ التصوف في المغرب، مثّل نموذجا واقعيا للصوفية المغاربة الملتزمين بالوسطية والاعتدال، والذين حرصوا على تعزيز الأمن الروحي وحمايته، إلى درجة يستمر معها مدد بركة الرحلة ساريا في كل الأحوال، كما قال أبو سالم العياشي: "فكانت تلك الرحلة (...) جعل مدد بركتها ساريا في جميع أحوالنا" ، وقوله أيضا: "وإني لأرجو لي ولهم حصول بركات تلك الأوقات، في سائر أحوالنا في المحيى والممات" . وذلك ما يوضح بجلاء جانبا مشرقا من جوانب استمداد الأمن الروحي، الذي يتجاوز حدود الزمان والزمان، ليستمر مدده ساريا مع كل قراءة جديدة للرحلة المغربية الصوفية، باعتبارها مظهرا من أبرز مظاهر الحضارة المغربية في بعدها العالمي مادامت الرحلة ارتيادا للآفاق وإعلانا عن الانفتاح على الثقافات الأخرى.

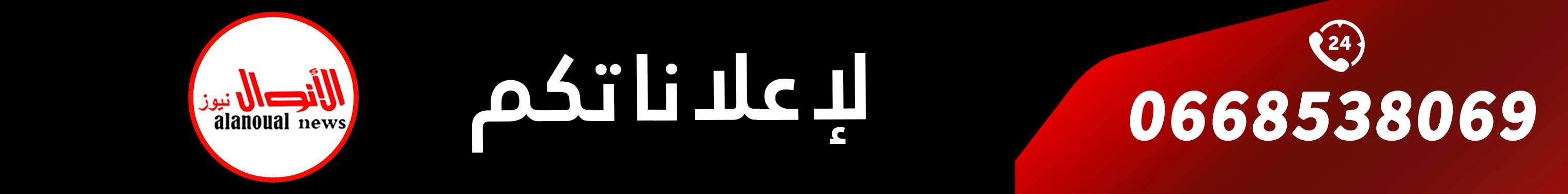
 الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس
الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس _6.jpg) صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب
صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب  نداء فاتح ماي 2025 _ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو إلى تعبئة وطنية
نداء فاتح ماي 2025 _ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو إلى تعبئة وطنية _6.jpg) مستمرون في الاشتغال على القضايا الحقوقية وفي الدفاع عن المظلومين رغم حرماننا من وصل الإيداع لليوم 296 من قبل ولاية الرباط سلا القنيطرة
مستمرون في الاشتغال على القضايا الحقوقية وفي الدفاع عن المظلومين رغم حرماننا من وصل الإيداع لليوم 296 من قبل ولاية الرباط سلا القنيطرة 
_5.jpg)

أوكي..