الدين والتديّن في المملكة المغربية

الأنوال نيوز بقلم: الدكتور خالد التوزاني
ينهل السلوك الديني في المملكة المغربية من المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وتصوف الجنيد السالك، أهم سماته وخصائصه، والتي جعلت من المغرب قطباً دينيا وحضاريا بارزاً على الصعيدين الإفريقي والعالمي، نظرا لما يطبع هذا السلوك من وسطية واعتدال وانفتاح وتسامح، انسجاما مع روح الشريعة الإسلامية السمحة في الحث على مكارم الأخلاق والنهل من سيرة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، حفظه الله ونصره وأيده، والمؤكد أن هذا السلوك النبوي القائم على تزكية النفس وتربيتها، يمثل خَزَّاناً معرفيا وثقافيا ووجدانيا مؤهلاً للإسهام بفعالية في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة، وتخليق السلوك العام، وربطه بجوهر الإنسان وقداسته، إلى جانب ما يمكن أن يقترحه من حلول جديدة لواقع مادي معقد وملتبس تختلط فيه المصالح وتتضارب فيه التيارات والآراء المناقضة أحيانا للشريعة وسلطان العقل والحكمة والقانون، ولذلك فإن رصيد المملكة المغربية من السلوك الديني الملتزم بالثوابت الدينية الأصيلة في منابعها النقية، قد مثّل صمام أمان أمام كل انحراف أو تشويه ومسخ.
يحرص المغرب على حماية خصوصياته المحلية في التدين، ففي قراءة القرآن الكريم اختار المغاربة رواية الإمام عثمان بن سعيد المصري المعروف بورش (ت197 هـ-813م) من طريق أبي يعقوب يوسف الأزرق المدني (ت224هـ-839م) حسب اختيارات حافظ القراءات أبي عمر عثمان بن سعيد الداني الأندلسي (ت444هـ-1053م) وعلى وفاق ما نظمه أبو الحسن علي بن بري التازي (ت730هـ-1330م) في أرجوزة "الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع"، وبقي المغرب محافظاً على هذا الاختيار عدة قرون، و ليس ذلك تعصباً لرواية معينة، بل يريد المغرب أن يحافظ على شخصيته المستقلة حتى لا تذوب مثل أقطار أخرى، وهذه الخصوصية هي السبب في التمسك برواية ورش إلى الآن، علماً أنَّ المغاربة قد أتقنوا القراءات كلها، ونالوا جوائز عالمية في حفظ وقراءة القرآن الكريم، فعلاقة المغاربة بالقرآن تبدأ من الصغر في الكُتّاب بحفظ كتاب الله قبل الدخول إلى أقسام المدرسة، وهذا المنهج بقي المغرب محافظاً عليه في الكثير من المناطق وخاصة الجبال والأرياف وعديد المدن المغربية..
إن حاجة عصرنا إلى تدين سليم وسطيّ ونقي، ضرورة ماسة من أجل تخليق السلوك ونشر قيم التسامح ونبذ العنف والتطرف ومواجهة التعصب والمغالاة، دون التفريط في ذرة واحدة من تعاليم الإسلام السّمحة، ولا شك أن هذا النمط من التدين مرغوب ومطلوب، لما فيه من إمكانات الإصلاح المجتمعي للفرد والجماعة، بخلاف أنماط التدين التي يمكن وصفها بغير السليمة، والتي تتَّسمُ بالغلو والتطرف والانحراف، وتقدّم صورة مشوّهة للدين والمتديّنين، وتغدو عائقا من عوائق التحديث والتنمية والتطوير، ومن ثم فالبحث في التدين السليم يعد ضرورة علمية وحاجة اجتماعية من أجل تصحيح المفاهيم.
إن أهم مدخل لتدين سليم، هو خلق جسور التواصل بين الإيمان باعتباره عملاً قلبيا داخليا وبين السلوك الإنساني بوصفه مظهراً خارجيا يترجم ما يحمله المرء في ذهنه من أفكار، وسبيلُ هذا التواصل يتحقّق في سلوك التزكية العرفانية، أي التصوف الجنيدي، كما اعتمده المغاربة منذ قرون في نمط تديّنهم، ضمن ثوابت دينية، خلقت من المغرب نموذجاً في الوسطية والاعتدال، وبوّأته مكانة مرموقة في هذا المجال، إذا استحضرنا حجم الإقبال على النموذج المغربي، من قبل دول إفريقية وأوروبية.
ونظرا للفاعلية التي تميّز التربية الروحية، المرتبطة أساساً بتزكية النفس، لما لها من آثار في تقويم السلوك، فقد كثر في الآونة الأخيرة الاهتمام بالظاهرة الصوفية؛ حيث نلحظ وفرة المؤلفات في هذا المجال دراسةً وتحقيقاً، وتخصيص مجلات علمية بعض أعدادها لبحث قضايا في التصوف، كما نوقش الموضوع في مؤتمرات عالمية، ونجد له حضوراً في الإعلام من خلال برامج تسلط الضوء على الطرق والزوايا وأعلام الصوفية، وكذلك ولوج التصوف للدراسات الجامعية سواء في مواضيع الدكتوراه أو من خلال وحدات بحث متخصصة، إلى جانب ترميم كثير من المؤسسات الدينية وخاصة المساجد والمدارس والزوايا والأضرحة، كل ذلك يدل على انتعاش التصوف في وقتنا الحاضر، الشيء الذي يفرض ضرورة تعميق البحث في هذه الظاهرة، من أجل الكشف عن الجوانب الخفية فيها، ووضع اليد على مواطن القوة والتميز، والتي يمكن أن تخدم تكوين الإنسان، بعيدا عن الانحرافات والشبهات التي قد تعطل مسار التنمية والتحديث وتعيق التجديد في الرؤية والعمل، وكذلك لا بد من دراسة التصوف بعيدا عن كل المزايدات السياسية والخلفيات الإيديولوجية الضيقة، فيكون الإنسان في جماله وكماله المبتدأ والمنتهى ويكون السلوك الديني السليم غاية سامية لأجل مجتمع متسامح.
على الرغم من أن التصوف قد اكتسح اليوم مجالات مهمة في الحياة المعاصرة، واستطاع بفضل ثورة الإعلام، أن يلفت الأنظار إليه بعدما عاش طويلا في الخفاء مندمجا في السياق المجتمعي بشكل لا واعي، إلا أنَّ التصوف يتم النظر إليه باعتباره تراثا معزولا عن سياق الواقع ولا يمكن استثماره أو الاستفادة منه بسبب انحرافه أو المبالغات التي ترد فيه، أو عدم إمكانية تطبيقه في واقع تكنولوجي معقد لا يعترف بالروحانيات، ولعل هذه النظرة المجحفة تجاه التصوف هي التي جعلته مرتبطا عند البعض بالتطرف والبدع والضلالات، وفي أحسن الأحوال يتم النظر إليه باعتباره ماضيا حضاريا لم يتبق منه إلا الجانب الشعبي والطقوسي الذي لا يرقى لانتظارات مجتمع اليوم.
لقد شكَّل التصوف عبر التاريخ جانبا معقدا في الفكر الإسلامي نظرا لاحتوائه على عدد من القضايا الشائكة والصعبة، مثل الكرامات والشطحات، والتي جعلت من التصوف كائنا زئبقيا يتلون حسب نظرة كل باحث وأيضا حسب كل تجربة روحية؛ ففي التصوف جانب إيجابي مشرق يتمثل في الإلحاح على ضرورة تخلية النفس من الرذائل، وتحليتها بالفضائل، وتصفية القلب من الأغيار، وتطهير الروح من الأدران، ليبلغ المرء عبر مداومة ذكر الله، درجة من اليقين والاطمئنان القلبي تؤهله لتذوق حلاوة الإيمان وجمال العبادة، فيدرك حقيقة التوحيد ويتعلق بالحق فلا يرى في الكون غير الله، إلا أن هذا المسار الارتقائي في التقرب إلى الله قد يطغى عليه أحيانا بعض الغلو أو التطرف، وخاصة عندما ينحرف عن منهج الكتاب والسنة ويُحَكّم شهوات النفس مثل حب الرياسة والجاه والطمع وحب الظهور الذي هو قاصم الظهور حسب الصوفية، فيصبح التصوف بهذا المعنى، جانبا مظلما يقود إلى الابتعاد عن التدين السليم والاقتراب من المذاهب الفلسفية والعقائد الأخرى التي لا تستند إلى شريعة الله وإنما تستمد أصولها ونظرياتها وتطبيقاتها من خليط متنوع لأفكار وتصورات إنسانية غريبة تخرق المألوف من الدين والعرف والذوق، ولعل بعض المنتسبين للصوفية عندما يميلون إلى خرق مألوف المجتمع إنما يريدون لفت الانتباه وتأكيد صدقهم عبر الكرامات وادعاء الولاية والصلاح، وقد كان المطلوب إصلاح النفس، وليس البحث عن كسب النفوس وتكثير الأتباع والمريدين.
إذا كان سلوك تزكية النفس مكونا من مكونات الدين، متمثلا في مرتبة الإِحسان الذي حدده رسول الإِسلام محمد صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حين قال: "الإِحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإِن لم تكن تراه فإِنه يراك"، فإن ذلك يعني أنه لا ينبغي رفض التصوف جملة وتفصيلا بسبب كثرة الانحرافات الظاهرة، كما لا يجوز قبوله بغثه وسمينه، بل لا بد من غربلته وتصفيته، ليخرج للناس طاهرا مضيئا، مداويا لأسقام النفس، ومعالجا لأمراض العصر، وهذه رؤية علمية منصفة، ترى في التزكية العرفانية قدرتها على الإسهام في الواقع، وخاصة في الجانب العقدي والأخلاقي الذي يحتاجه العالم اليوم.
يمثل التصوف البعد الداخلي للتجربة الدينية، حيث ينتقل المتدين من الإسلام شعيرة، إلى الإيمان عقيدة، إلى الإحسان سلوكا، وهي مقاماتٌ يحتاج فيها المتدين إلى الوازع القلبي، لأن رياضة النفس لازمة كرياضة الجسد، ولذلك عمل التصوف على خلق التوزان بين المادة والروح، وتسهيل العبور نحو الصفاء والمحبة والتسامح والإخاء، وخاصة في زمنٍ أصبح فيه الأمن الروحي أعز ما يُطلب وأنفس ما يُبحث عنه، فكان التصوف باعتباره تربيةً وسلوكاً منبعاً لتحقيق السّلام بكل تجلياته وأبعاده، ودفع البشرية للعودة إلى المنبع الصافي حيث المحبة لكل الخلق وترك الشقاق والافتراق وزرع محاسن الأخلاق وفضائل القيم في النفوس، والتي بها ترتقي البشرية وتُعمّرُ الأرض.
عندما نقول: وسطية التصوف، فإن هذا التعبير قد يوحي أو يوهم، أن هنالك تصوفا معتدلا يشكل وسطا بين طرفي نقيض: تصوف متطرف وآخر متسامح أو متساهل، وحسب هذا الفهم، هناك أنواع من التصوف، في حين ليس هناك إلا تصوفا واحدا؛ وهو التصوف الإسلامي، والذي يتكئ على مقام "الإحسان" ويقتبس من تعاليم الإسلام ما به تتحقق تزكية النفوس وترتقي الأرواح، وغير هذا النوع يعتبر انحرافا عن الأصل أو تقليدا لا يعول عليه، ولذلك ينبغي أن نقول أننا بحاجة إلى خطاب صوفي سليم، بدلا من خطاب صوفي معتدل أو متطرف.. لكن، مادام المجال قد خاض فيه الكثيرون من مدعي التصوف، كما قال أبو حامد الغزالي عندما سئل عن التصوف: "هذا باب المدعي فيه كثير". فإن الحاجة أصبحت ماسة لرد بعض الشبهات من قبيل؛ تطرف الصوفية وانحرافهم عن وسطية الإسلام، أو تعميم انحرافهم، أو الحكم على كل الصوفية بالبدع والضلالات.
إنَّ إطلاق أحكام عامة بغير دليل، أو تسخير الآراء الشخصية دون داع أو مبرر، كثيرا ما أفسد التصوّر حول الدين والتدين، وأسهم في ترسيخ التمثل السلبي تجاه كثير من الممارسات، أو المواقف والآراء. ومن ثم، فإنه يلزم الباحث في الدراسات الإسلامية وقضايا الهوية والثقافة والأدب أيضاً، الانتباه إلى مثل هذه القضايا التي تعتبر بالغة الحساسية، فيتصدى لها بالبحث والاستقصاء، لمقاربة الحقيقة الدينية من زوايا متكاملة تتسم بالعمق والشمول كلما أمكن ذلك، دون أي ادعاء بامتلاك "الحقيقة المطلقة"، والتي تظل نسبية في جميع الأحوال، ما دام البحث يدخل في نطاق "الإنسانيات"، وتلقي الإنسان لما هو روحي مغرق في الذوق، كما أنَّ الباحث أحياناً يكون مطالباً بقدر معين من التجربة حتى يتمكن من فهم الموضوع، موازاة مع إعمال الفكر والنظر والاستدلال.
يؤكد الواقع نجاح التجربة الدينية للمملكة المغربية، فقد استطاع المغرب أن يقدّم درسا في التعايش السلمي والتواصل الحضاري منذ عدة قرون مضت، فالمجتمع المغربي مشبع بقيم قيم التسامح والحوار ومحبة الآخر، وقد عاشت في أرضه العديد من الديانات والجنسيات المختلفة، ولا شك أن سر هذا التعايش يرجع بالأساس إلى جملة من الثوابت الأصيلة التي تتشبث بها المملكة المغربية وعلى رأسها السلوك الديني الملتزم بالكتاب والسنة، والذي يُجسِّدُ حقيقة التدين السليم، الذي يحرك الإنسان في دائرة العقل المتوازن، والعاطفة الدينية العقلانية المحتكمة للنصوص التأسيسية والمتكيّفة مع الواقع، وحتى لا تكون هذه الوسطية المنشودة "وسطية اللين والتخاذل"، أو وسطية يتطلع إليها الغرب، أو مَنْ يحارب الهوية الإسلامية في صفائها ونقائها، فإن مفهوم الوسطية لابد أن يُطلب من القرآن والسنة وعمل الصحابة وعلماء الأمة، وهي أصول الوسطية في تدين المغاربة، وما دامت هذه الوسطية تتشبث بأصولها ومصادرها الأولى فهي مؤهلة لإدلاء بدلوها في الإصلاح والتغيير، أما الخطر الذي يهددها فهو تبديل معناها إلى معاني اللين والبساطة والتنازلات والاستسلام والخضوع والاستلاب..، وهي معاني دخيلة على هذا المفهوم الذي تحول إلى "وسطيات" بدل وسطية خيرية وعادلة واضحة المعنى والدلالات، كما تناولنا ذلك في كتابنا: التصوف الإسلامي؛ نحو رؤية وسطية، والذي صدر مؤخراً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بلبنان.
من الأكيد أن السلوك الديني عند المغاربة، باختياره منهج الوسطية والاعتدال والتسامح تدبيراً للاختلاف، قد استطاع الصمود في وجه الأعاصير والرياح العاتية القادمة من الشرق أو الغرب، تحت قيادة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، باعتباره أعلى سلطة دينية في المغرب، متمثلة في مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي لها دور مهم في حماية الثوابت المغربية وتأصيل الحياة الروحية، ولعل مصدر قوة الفكر المغربي عموماً، يرجع لهذا التلاحم بين التاريخ والحاضر، وبين الثوابت والمتغيرات، في وعي تام بقيمة الوقت وضرورة مواكبة جديد العصر، وفي الآن ذاته حماية الخصوصية المحلية والهوية الوطنية، وهذا جانب من العبقرية المميّزة للمغرب، وسِرٌّ من أسرار استمرار الدولة واستقرار المجتمع، ولذلك تأثرت الثقافة المغربية بهذه السمات المتفرّدة، إذ لا ثقافة فاعلة وواقعية بدون الوسطية وبدون الهوية، حيث إنها تُفَعِّلُ النخب الاجتماعية وتحمي الأمة ومجدها، كما تسهم في الحفاظ على توازنات اجتماعية واقتصادية كبيرة، دون أيّ عنف أو إكراه، فالثقافة قوة ناعمة ودبلوماسية موازية سائلة وسائغة، تمارس تأثيرها بشكل ضمني يزاوج بين المادي واللامادي في تناغم تام وتداخل يجعل من اللامرئي مؤثِّراً في الواقع المرئي.
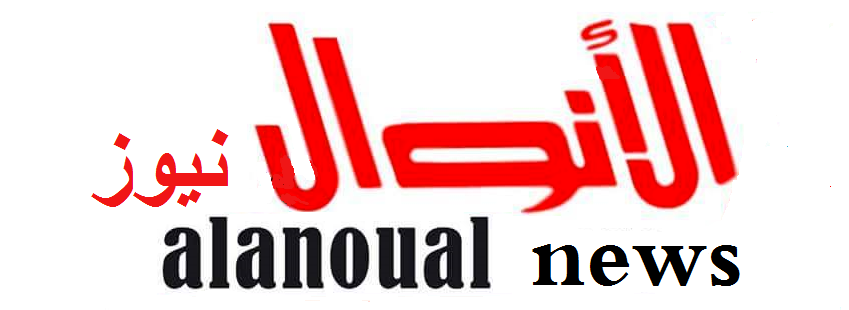
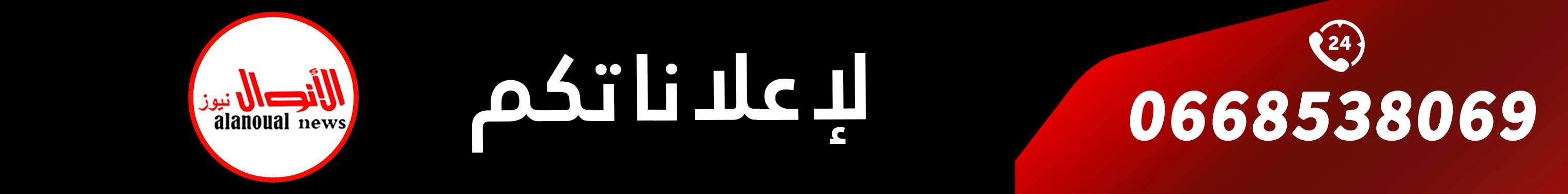
_4.jpg) العثماني رئيس الاتحاد العالمي للتعاضد يبرز ريادة التجربة المغربية في مجال التعاضد خلال المنتدى الدولي للتعاضد بكوادالاخارا المكسيك
العثماني رئيس الاتحاد العالمي للتعاضد يبرز ريادة التجربة المغربية في مجال التعاضد خلال المنتدى الدولي للتعاضد بكوادالاخارا المكسيك _3.jpg) جلالة الملك يُعطي بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش
جلالة الملك يُعطي بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش _2.jpg) حرب مبابي وسان جيرمان تشتعل.. تجميد 55 مليون يورو وتهديد بسحب رخصة النادي
حرب مبابي وسان جيرمان تشتعل.. تجميد 55 مليون يورو وتهديد بسحب رخصة النادي  كوادالاخارا،المكسيك – تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في قلب الحركة التعاضدية العالمية
كوادالاخارا،المكسيك – تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في قلب الحركة التعاضدية العالمية 


أوكي..