الاستعمار وبنية الاستعمار

الأنوال نيوز: بقلم حسن أوريد -كاتب مغربي-

مما يرويه المغاربة أن شيخا مغربيا مَهيبا قصد الحاكم العسكري لمكناس، إبّان الاستعمار، في بداية الخمسينيات بمكتبه فيما كان يسمى بيرو عرب (مكتب الأهالي)، فاستقبله الحاكم بما يليق بسنه، وارتاع الحاكم الفرنسي حين قال له الشيخ، لقد آن الأوان أن ترحلوا، لأن مَن أنشأتم من ذريتنا أكثر إمعانا في الاستعمار، وهم محافظون على تراثكم، مؤتمنون على صنيعكم خيرا مما تفعلون. يتداول المغاربة تلك القصة الحقيقية، ويتداولون كذلك ذلك المثل الذي كان يردده بعض من الناطقين بالأمازيغية غداة الاستقلال، من أن النصل الذي كانوا يُحَزّون به الرقاب هو ذاته، وأن ما تغير هو مقبض النصل.
كانت النخبة المغربية، تعي أن الاستعمار خرج من الباب ليعود من النافذة، وأنه بقي بمؤسساته، وخياراته وتوجهاته، بل ورجالاته المؤتمنين على تراثه، في المؤسسات الحساسة، من جيش وإدارة وقطاعات اقتصادية، ولذلك نحت الزعيم المهدي بن بركة مصطلح مَغْربة الحماية، لانتقاد ما آلت إليه الأمور، أي أن منظومة الحماية استمرت ولكن بمغاربة.
كان جزء من الصراع المحتدم في مغرب الستينيات خاصة، بين اتجاه مؤتمَن على الميراث الاستعماري، واتجاه يريد أن يتخلص منه، وكانت المعركة ضارية، لأنها كانت معركة وجودية. قد يقال الشيء ذاته عن الجزائر، رغم اختلاف السياق والمساق، في ما يعبر عنه الجزائريون بالصراع بين ابن باديس وباريس، أي عبد الحميد بن باديس زعيم جمعية علماء المسلمين، التي برزت في الثلاثينيات، كرد فعل لمئوية احتلال الجزائر، وشعار صاحبها، «شعب الجزائر مسلمٌ وإلى العروبة ينتسب»، ومن يرتبطون بباريس سياسيا واقتصاديا وثقافيا، ويسمون بحزب فرنسا.
لم يواكب الاستقلال السياسي استقلال اقتصادي ولا ثقافي في بلدان العالم العربي. ولعل ذلك ما أوحى للباحث الفرنسي المختص في الحركات الإسلامية فرنسوا بورغا، صياغة مصطلح، موجة الاستقلال الثقافي التي بدأت في التسعينيات في كل من الجزائر، وبشكل من الأشكال في المغرب، أي أن موجة الاستقلال السياسي أعقبتها، حسب هذا الباحث، موجة استقلال اقتصادي، في السبعينيات، ذلك الذي تبدّى مع التأميمات، وفك الارتباط بالمتروبول، وأخيرا موجة الاستقلال الثقافي التي تُعبر عنها الاتجاهات الإسلامية. لا أدري مدى وجاهة هذا التحليل، ولكن الذي أراه، أن شكلا جديدا من الاستعمار بزغ في أعقاب سقوط حائط برلين، باسم حق التدخل، وقرارات الأمم المتحدة في فرض الحصار على دول، واستصدار قرارات مجحفة في حق شعوب ما تزال تعاني من ويلاتها الأمَرّين، كما حصل لشعب العراق وليبيا، ومشاريع صياغة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، المنبثقة عن معاهد أمريكية، وبرامج الحكم الرشيد، وتمكين القدرات، وصياغة المخيال، وإصلاح المنظومة التربوية، وباسم الباب المفتوح في الاقتصاد، والغطاء الأيديولوجي المعروف بتوافق واشنطن. باسم الأيديولوجية الجديدة، تم تفكيك مؤسسات اقتصادية استراتيجية للدولة، وحُولت للخصخصة بأثمان بخسة، في ظروف غير شفافة، وباسم الانفتاح، مُنحت أراض خصبة وشاسعة لمنتجين فرنسيين، في المغرب، ومُكنت شركات سياحية من أراض عمومية، بأثمان جزافية كي تستثمر في السياحة، ولم تسلم الثقافة من «الاستثمار»، وأنشئت مؤسسات خاصة تدرّس بالفرنسية، وكانت تستخلص أرباحا طائلة تُحوّلها للمتروبول.
ولم يكن من الممكن تنزيل تلك التوجهات من دون نخبة «منغمرة» في روح العصر، أو حسب المصطلح الفرنسي branchée، ولم تكن تلك النخب (أو النخبة على الأصح)، قد تلقت تكوينها في كبريات مدارس الغرب ومعاهده فحسب، بل كانت تجهل المقومات الثقافية للمغرب، ولا تحسن العربية ولا الأمازيغية، ولا تعرف الكثير عن تاريخ المغرب، وترتهن إلى بنية تقليدية موازية، تضطلع بدور الغطاء الأيديولوجي، وتأطير الجماهير، أو صياغة المخيال والسهر على «الأمن الروحي»، من خلال رؤية تقليدية للثقافة، في غطاء حديث، ونفض الغبار عن مؤسسات عتيقة، بدعوى أنها تُشيع صورة مسالمة للإسلام، وما شابه ذلك، رغم أنها كانت ضالعة مع الاستعمار، وكانت تدعو للتحجر والخرافة والبدع. قامت النواة الأولى لتلك البنية في المغرب من عناصر تعود أصولها إلى الجزائر، ظلت وفية «للجزائر الفرنسية»، ووجدت في المغرب الحضن لها، وكانت حاضرة بقوة في جهاز الأمن، وكانت من العناصر التي فتنت الوطنيين، منهم الأخوان العشعاشي والضابط ربيع، الذي سيصبح لاحقا مديرا عاما للأمن الوطني، ممن سارت بذكرهم الركبان، أو عناصر تقنية في الحقوق خاصة، كما عباس القيسي (أمين عام للحكومة) والهاشمي بن غبريط، (مفتش في وزارة الخارجية) والحسين بن حربيط (مسؤول في وزارة الداخلية)، وعبد الصادق ربيع (أمين عام للحكومة)، أو بعض العناصر التي اشتغلت مع الإدارة الفرنسية، ممن كانوا يسمون (المتعاونين). كان القاسم المشترك لهؤلاء ليس جهلهم بالعربية وبالأمازيغية فقط، بل احتقارهم لهما، واحتقارهم لكل ما يمُتّ لهما. اغتنت البنية بروافد عدة، من أبناء المهاجرين في فرنسا، ولا عيب في أن يسهم هؤلاء في بناء بلدهم، ولكن بعضا منهم كانوا ينطلقون من الرؤية التي تنسج في فرنسا، ومن المنظور الذي يصاغ على جنبات نهر السين. وكان البعض من هؤلاء يتقلد مناصب حساسة، ويحافظ على جنسيته الفرنسية، ولم تكن الجنسية مجرد وثيقة إدارية، ولكن توجها وخيارا، بل عقيدة. وكانت هذه الفئة مسنودة بلفيف مؤثر في باريس، من رجال السياسة والإعلام والمال، أو من كان المقيم العام لوسيان ستيك يسميهم إبان الاستعمار بقبيلة أولاد لاسين.
كان جزء من الصراع المحتدم في مغرب الستينيات خاصة، بين اتجاه مؤتمَن على الميراث الاستعماري، واتجاه يريد أن يتخلص منه
لم تعد البنية هي القرص الصلب الذي يشتغل في الخفاء، بل أخذت تتولى مناصب سياسية في قطاعات حساسة، وكان لزاما لها أن تواجه الرأي العام وتخاطبه، ولم يكن يضيرها أن تلحن في ما تقرأ من الخطب، التي تُدبّج لها، أو لا تحسن قراءتها، لأن جوهر السلطة بيدها، وتحظى بثقة الهيئات العليا، وكان الرأي العام يتعرض إلى حصص من التعذيب في الاستماع لخطب بلغة مضطربة، مترجمة في الغالب من الفرنسية. كانت هذه البنية هي ما سيُعهد لها أن تفكر في قضايا التربية، بل حتى في الدين، وتصوغ تصور التنمية، وتُطلع الرأي العام على نتائج ما انتهت له، في تاريخ 14 يوليو 2020، لكي تزف للمغاربة بشرى نتائجها في ذاك اليوم المشهود، في مقاربتها «التشاركية، الاندماجية»، أكرِمْ بها وأنعمْ، والتي لا تضم عنصرا واحدا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ناهيك من الإسلاميين.
كانت هذه البنية تعي أن هناك عقبة كأداء تنتصب أمامها وهي اللغة العربية، وعوض أن تتعلم العربية، أضحت تزعم بأن اللغة العربية لغة أجنبية، وأن اللغة الوطنية للمغاربة هي الدارجة، وتبرر ضحالتها المعرفية، وركاكتها في التعبير باسم التنوع الثقافي. ولم تكن ارتباطات من يريدون صياغة المخيال هؤلاء تقف عند ضفاف نهر السين، بل كان من له علاقات عضوية ووجدانية مع الصهيونية، أو يرتبط بأجندتها، مع إمكانات ضخمة في ميدان شركات التواصل. ليس هناك استعمار، إلا إذا كانت هناك قابلية للاستعمار، كما كان يقول المفكر اللوذعي مالك بن نبي، ولا فرق أن يكون الاستعمار قديما أو حديثا، فهل نَعيب عودة الاستعمار أم البنية الحاضنة للاستعمار؟ هما على كل حال متلازمان.

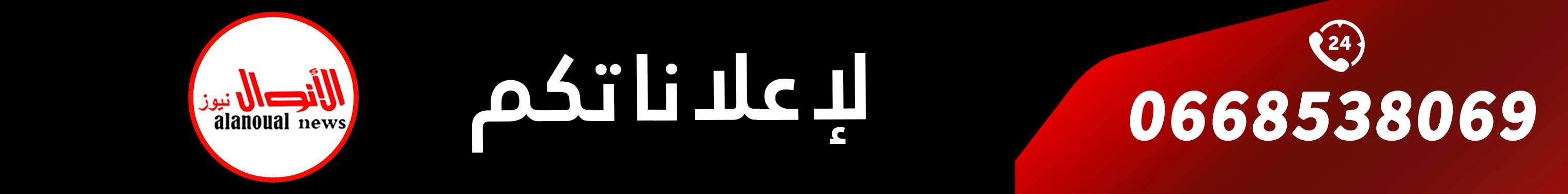
_24.jpg) بيان شرعي يحرم، ويدين رسوّ سفن أمريكية بميناء طنجة محمّلة بعتاد عسكري موجه للكيان الصهيـوني
بيان شرعي يحرم، ويدين رسوّ سفن أمريكية بميناء طنجة محمّلة بعتاد عسكري موجه للكيان الصهيـوني _64.jpg) البيان الصادر عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان حول صناعة التقليدية تحتضر بإقليم سطات
البيان الصادر عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان حول صناعة التقليدية تحتضر بإقليم سطات _80.jpg) النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تشدد على ضرورة غربلة وتصحيح المنظومة القانونية وتنقيتها من كل ما يربطها بالقانون الجنائي
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تشدد على ضرورة غربلة وتصحيح المنظومة القانونية وتنقيتها من كل ما يربطها بالقانون الجنائي _157.jpg) من رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية عدم تسليم وصل الإيداع
من رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية عدم تسليم وصل الإيداع 


أوكي..